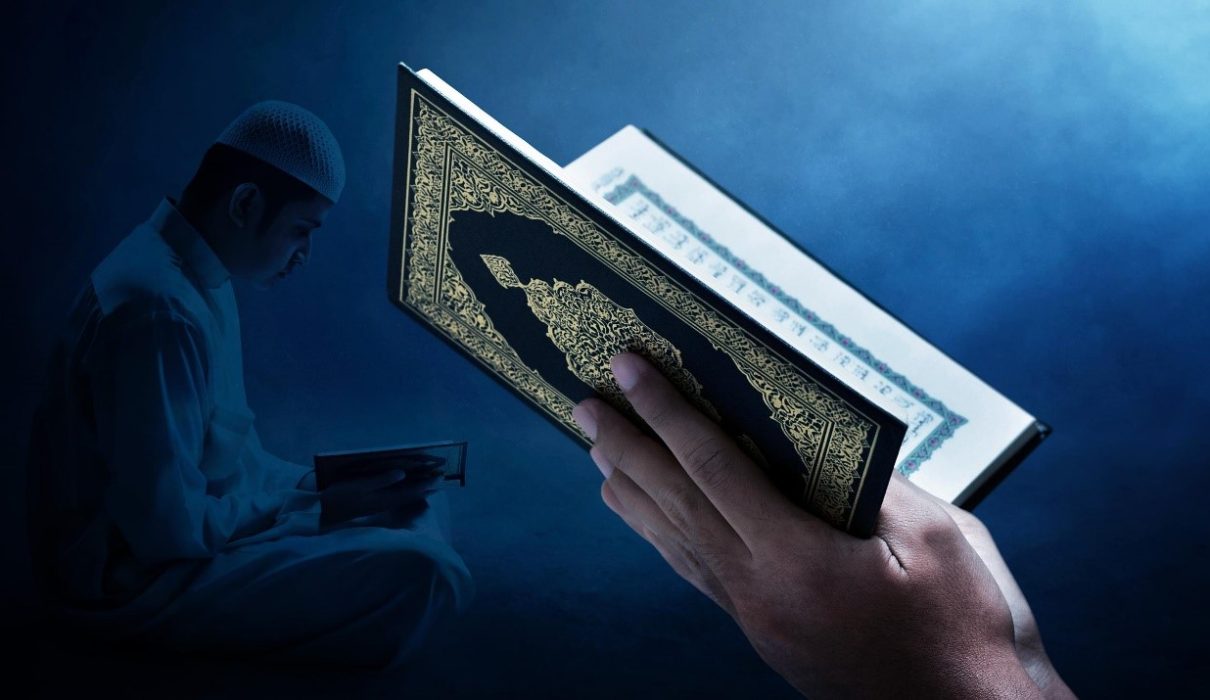
أطروحات متباينة:
ما تأثيرات تعدد القراءات على تفسير القرآن؟
لا تزال مسألة تعدد قراءات القرآن الكريم تشغل اهتمام عدد من الباحثين والمنشغلين بالحقل الفكري الديني، وبشكل خاص المحسوبين على ما يُصطلح عليه بالاتجاه “التجديدي” في الفكر الديني، مقابل شيوع التأصيلات لتعدد القراءات باعتبارها مبحثاً في علوم القرآن الكريم.
وتتباين المواقف داخل التيار “التجديدي” –على اختلاف التوجهات والمشروعات الفكرية الخاصة- من تلك القراءات سواء المتفق عليها والأكثر شيوعاً، أو غيرها مثل الشاذة، خاصة مع احتمالات تأثيرات تلك القراءات على تفسير القرآن.
وفي حين تُقر التيارات “التراثية” و”التقليدية”، بتعدد القراءات، والاتفاق على قراءات عشر، في المقابل، تقول بعض الآراء برفض تلك القراءات بالكلية، مقابل مواقف أقل حدة في التعاطي مع مسألة تعدد القراءات، واعتبارها اجتهادات لغوية للعرب منذ عهد الرسول محمد (ص).
تأصيلات متعددة
تهتم عدد من الكتابات التراثية بمسألة القراءات المختلفة للقرآن الكريم، خاصة مع بروز اختلاف في بعض الأحرف والتشكيل، بما استدعى تدخلاً لوضع تأصيلات لتلك القراءات ودراستها، لوضع ضوابط لعدم تأثيرها على تفسير القرآن الكريم، وأبرز تلك التأصيلات:
1- أحد مباحث علوم القرآن: تُعد القراءات المختلفة للقرآن الكريم، أحد المباحث الرئيسية في علوم القرآن المستقَر عليها في التراث الإسلامي على مدار قرون، وتُعرف القراءات اصطلاحاً بأنها: “مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة في القراءة يخالف مذهب غيره”.
وتشير بعض الكتابات إلى أن القراءات المختلفة للقرآن، مثبتة بأسانيد وتعود إلى الرسول (ص)، وظهرت القراءات في عهد الرسول، وتعددت بين الصحابة، منهم: “علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود”، وانتقلت تلك القراءات إلى مختلف الأقطار، كما جاء في كتاب “مباحث في علوم القرآن”، للكاتب مناع القطان.
2- القرآن نزل على سبعة أحرف: تستقر الكتابات المتعلقة بالقراءات على أن القرآن الكريم نزل على الرسول (ص) على سبعة أحرف، استناداً إلى بعض الأحاديث التي وردت فيما يُعرف بـ”كتب التراث”، كما جاء في حديث: “عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ»، وقَالَ ابْنُ شِهَابٍ الزهري: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الأَمْرِ الَّذِى يَكُونُ وَاحِدًا لاَ يَخْتَلِفُ فِي حَلاَلٍ وَلاَ حَرَامٍ”، صحيح مسلم.
ولكن يتضح أن ثمة اختلافاً حول المقصود بالأحرف السبعة التي وردت في الحديث السابق، وغيره من الأحاديث التي تشير إلى نفس الدلالة، ولكن يميل بعضها إلى اعتبار أن المقصود بالأحرف السبعة هو لغات العرب خلال فترة نزول القرآن، وهي: “قريش، وهذيل، وثقيف، وهوازن، وكنانة، وتميم، واليمن”.
3- الاستقرار على 10 قراءات متفق عليها: تختلف بعض الكتابات في علوم القرآن، في تصنيف القراءات وأنواعها، في إطار محاولة وضع ضوابط حاكمة لاستخدام القراءات، واستبعاد القراءات “المجهولة”، وتميل بعض الكتابات إلى تصنيف القراءات إلى ستة أنواع: المتواتر، والمشهور، والآحاد، والشاذ والموضوع، والمدرج، مع الاستقرار على عدم الاعتماد على الأربعة أنواع الأخيرة.
في المقابل، تشير بعض الكتابات، إلى تصنيف القراءات إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي: “المتواترة، والآحاد، والشاذة”، مع الاتفاق على أن المتواترة سبع فقط، وهي تُنسب لأئمة القراءات: “نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو بن علاء، وابن عامر الدمشقي، وعاصم الكوفي، وحمزة الكوفي، والكسائي الكوفي”، والآحاد ثلاث، وهي تنسب لأئمة القراءات: “أبو جعفر المدني، ويعقوب البصري، وخلف بن هشام البزار”، ليصبح عدد القراءات المتفق عليها في مبحث القراءات ضمن دراسة علوم القرآن، عشر قراءات، مع استبعاد القراءات الأخرى، باعتبارها شاذة.
4- حدود التأثيرات على تفسير القرآن: ركزت بعض الدراسات على تأثيرات تعدد القراءات وعلاقاتها بتفسير القرآن، واتجهت وفقاً لتصنيفات القراءات وأنواعها إلى اعتبار أن القراءات التي لها تأثير على التفسير هي تلك القراءات المقبولة (المتواترة، والمشهورة)؛ إذ يصبح بعض الاختلاف له أثر في المعنى، وبالتالي له أثر تفسيري.
واستبعدت دراسة “اختلاف القراءات وأثره في التفسير”، للباحثة مريم الشيخ، تأثيرات الأنواع الأخرى من القراءات على تفسير القرآن، مثل المردودة (لم يصح سندها، أو لا سند لها، أو لم تلقَ قبولاً عند العلماء)، فضلاً عن القراءات الشاذة، ولكن في الوقت ذاته، تتطرق بعض الآراء التي جاءت في الكتابات التراثية، إلى أن إمكانية دراسة القراءات المردوة والشاذة في بيان القراءات المشهورة وبيان معانيها، دون أن يكون لها أثر تفسيري واضح أو منفصل.
أطروحات متباينة
في مقابل ما استقرت عليه كتب التراث على مدار قرون حيال مسألة تعدد القراءات، فإن ثمة رؤى مغايرة لها، انشغلت بها بعض الاتجاهات فيما يُعرف بتيار “التجديد” في الفكر الديني، أو داخل التيار “القرآني”، الذي يرى بمركزية القرآن عن غيره من المصادر الأخرى مثل كتب السنة والفقه، ويمكن التطرق لأبرز تلك الرؤى، كالتالي:
1- قراءة واحدة لا متعددة للقرآن الكريم: ترفض بعض الاتجاهات داخل التيار “القرآني” فكرة تعدد القراءات، وترى بأن القرآن نزل مرة واحدة في قلب الرسول (ص) في ليلة القدر، ثم تنزَّل مقروءاً على لسانه، ولكنه كان يُسرع في القراءة، فإنه يقرأ بالقراءة العادية، في حين أن قراءة القرآن فريدة، ولذلك جاء قول الله تعالى: “لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾” سورة القيامة.
وترى تلك الاتجاهات أن قول الله تعالى “فاتبع قرآنه” كما في الآيات السابقة، ولم يقل “فاتبع قراءاته”، للتدليل على أن قراءة القرآن فريدة واحدة، لتشير إلى أن تعدد القراءات يأتي في سياق التلاعب بالقرآن الكريم، وتطرف لتغيير النص القرآني، ضمن محاولات لتحريف معنى القرآن، برزت في العصر العباسي، مثل قضية الناسخ والمنسوخ، والتأويلات في التفسيرات، وجمع الأحاديث وكتب الفقه التراثية.
2- طابع اجتهادي ضمن اللهجات العربية: مقابل الموقف الحاسم داخل بعض الاتجاهات في التيار القرآني، فإن بعض الآراء داخل التيار “التجديدي” في الفكر الديني لم تتطرق إلى تأثيرات مسألة القراءات على التفسير، وعدم التوسع في مناقشة هذه القضية وتأثيراتها، ضمن القضايا التي انشغلوا بها، في سياق مواجهة ما اعتبروه “جموداً” في الفكر الديني.
واعتبر الدكتور محمد شحرور أن القراءات نوع من الاجتهادات في سياق اللهجات العربية، وفقاً لاستنطاق العرب للقرآن، وليس له فائدة سوى أن القراءات مرجعية فقط، لحسم بعض الاختلافات حول آيات غير مفهومة في بعض القراءات، ولكن لا تمثل أغلب القراءات مشكلة.
وهنا، شحرور، يرى بتعطيل الاعتماد على القراءات في تفسير القرآن، انطلاقاً من عدم تأثير القراءات على تفسير بعض الآيات، ولكنه جعل القراءات يُوضح بعضها البعض في الكلمات التي تحتاج لتوضيح.
3- محدودية تأثير القراءات على الأحكام العامة: تدافع بعض الاتجاهات داخل التيار “القرآني” عن عدم تأثير تعدد القراءات على مسألة تفسير القرآن؛ إذ تؤكد على ثبات واستقرار المفاهيم الإيمانية والقصص، والأحكام الشرعية والتماسك المنطقي، ولكن الاختلاف في القراءات ليس اختلاف تضاد أو تناقض، كما يقول الباحث سامر إسلامبولي.
وبذلك، يدفع “إسلامبولي” الادعاءات المتعلقة بتحريف القرآن، انطلاقاً مع تعدد القراءات، مع توضيح المقصود في قول الله تعالى: “أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا”، سورة النساء – الآية 82، إذ إن “الاختلاف الذي قصده النص القرآني لو تحقق لثبت أن القرآن ليس من عند الله”، وفي حين أكد أن الاختلاف الجزئي في القراءات لبعض الكلمات أو الضمائر وارد، إلا أنه ربط ذلك بتتابع القراءة عن الرسول (ص).
4- أزمة تأثير الأحرف السبعة على الفقه: مع استقرار مبحث القراءات ضمن دراسة علوم القرآن الكريم على مسألة نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف، إلا أن ثمة اتجاهات تعارض هذه الرؤية، مثل الباحث مروان محمد عبد الهادي.
انطلق “عبد الهادي” من فرضيته حول رفض “الأحرف السبعة”، استناداً إلى توحيد الخليفة عثمان بن عفان للقراءات، وإلا لكان سمح بتعدد القراءات، والتي هي بالأساس “خدمت فقهاء القرون الأولى للإسلام الذين وقفوا عاجزين أمامها، ولذلك ينبغي دحض كل الأحاديث والروايات التي تلقتها الجموع الغفيرة حول القراءات”.
5- تداخل السياسي مع سيادة بعض القراءات: تعكف بعض الكتابات على دراسة أبعاد تداخل السياسي والديني خلال القرون الأولى من التاريخ الإسلامي، وتحديداً عقب وفاة الرسول (ص)، لبيان تأثيرات هذا التدخل على مجمل الأفكار السائدة والتي جاءت بها كتب التراث، وبالأخص على المستوى الفقهي، من خلال فرض القدسية على بعض النصوص، بما يخدم السلطة السياسية في كل عصر على حدة.
وفي هذا السياق، يجادل الباحث التونسي عبد الباسط القمودي، بتداخل الأبعاد السياسية فيما يتعلق بتعدد القراءات، ويقول: “إن القراءة المنسوبة إلى الرسول اعتبرت شاذة، والاختيار قد تجاوزها واستقر على غيرها، بدوافع مختلفة أغلبها سياسي، مثل حرق المصاحف من أجل التخلص من مظاهر الاختلاف”.
قضية جدلية
تظل قضية القراءات المختلفة للقرآن الكريم إحدى القضايا الملتبسة بين التيارات التقليدية والتراثية من جهة، والتيار “التجديدي” من جهة أخرى، في ظل تباين الرؤى والمواقف حيال تلك المسألة، رغم الإقرار على محدودية تأثير تعدد القراءات على الأحكام العامة التي جاءت بالقرآن، إلا أن بعض الاتجاهات تدفع باتجاه طرح تساؤلات منهجية، في الاتفاق على بعض القراءات دون غيرها، في سياقات زمنية ومكانية معينة، ولا تزال تأثيراتها حاضرة في التاريخ المعاصر، وخاصة على مستوى منظومة الفقه السائدة منذ قرون.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.