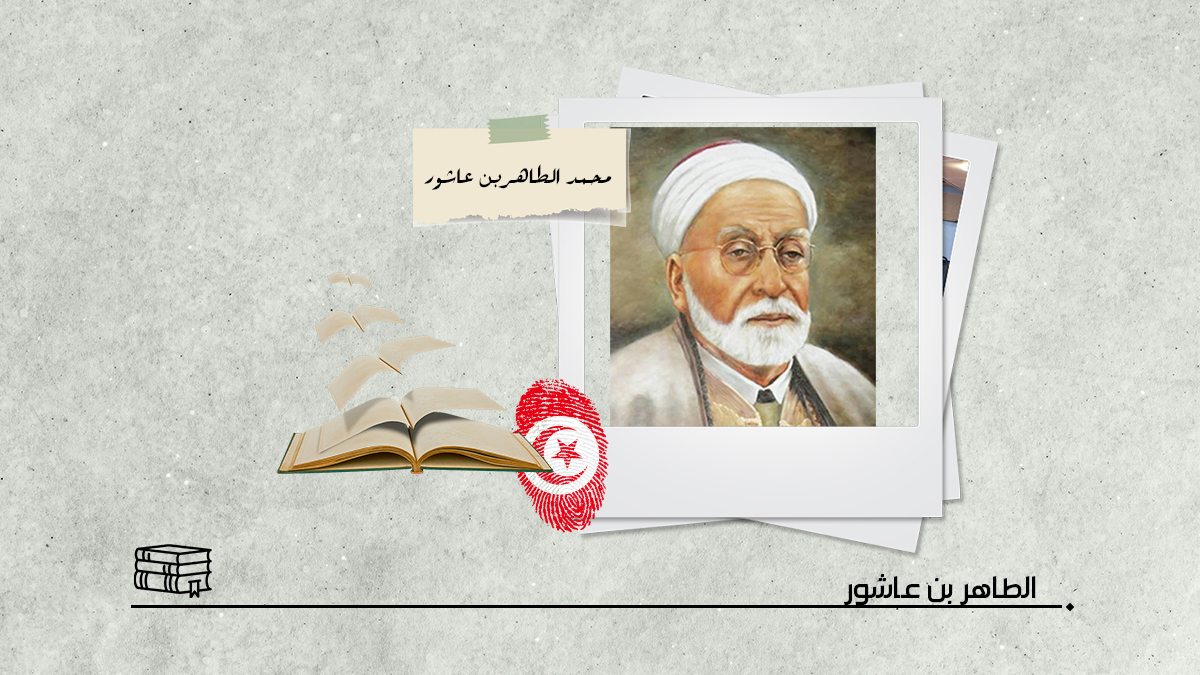
الطاهر بن عاشور:
مقاصد الشريعة وتجديد الخطاب الفقهي
مَثَّل الشيخ التونسي محمد الطاهر بن عاشور (1879-1973م)، الذي شغل منصب شيخ جامع الزيتونة، امتداداً لمدرسة محمد عبده الإصلاحية؛ إذ نادى بالإصلاح الديني، الذي ربط بين تحقيقه وبين استخدام المنهج العقلي واستخدام العلوم الحديثة، ونادى من أجل ذلك بإصلاح التعليم واعتماد تدريس العلوم الغربية الحديثة بأنواعها، الإنسانية والفلسفية والرياضية والطبيعية.
واجتهد "ابن عاشور" في تجديد الفقه الإسلامي، وتأسيس فقه "جديد" عبر تأسيسه علم مقاصد الشريعة، الذي ينبذ المنهج الفقهي القديم المعتمد على القياس اللفظي دون النظر العقلي ومراعاة الظروف والتطورات الاجتماعية المتغيرة وفقاً للزمان والمكان، ووسّع مفهوم مقاصد الشريعة حتى تضمن مفاهيم مثل المساواة والحرية.
وقد وسّع "ابن عاشور" في دعوته الإصلاحية مفهوم الدين، ليشمل جميع الأديان كلها ووحّد بينها وبين مقاصدها، كما اشتملت دعوته الإصلاحية على مفاهيم ثورية، مثل: مناداته بالمساواة بين الرجل والمرأة، وحق المرأة في التعليم، وإقراره مبدأ الزوجة الواحدة دون تعدد الزوجات، وضمّن آراءه في عديد من مؤلفاته، مثل: "تفسير التحرير والتنوير"، و"مقاصد الشريعة"، و"أليس الصبح بقريب"، و"أصول النظام الاجتماعي في الإسلام"، و"التوضيح والتصحيح"، و"تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة"؛ إضافة إلى كتابته مقالات مختلفة في عديد من المجلات التونسية وخطبه الدينية.
الإصلاح الديني
ذهب "ابن عاشور" إلى أن الدين "ضرورة حتمية للإنسانية"، وتوسَّع في تعريفه إيَّاه ليشمل الأديان كلها، ورأى أن هدفها -أي الأديان- الخير والأخلاق ونشر الفضائل بين الناس وإبعادهم عن العدوان والشهوات، وهدفها واحد عنده هو "حفظ نظام العالم وصلاح أحوال أهله"، حسب قوله.
وربط بين الدين بشكل عام، والإسلام بشكل خاص، وبين العقل والواقع، فقال: "العقائد الإسلامية وشرائع الإسلام وقوانينه حقائق تدركها العقول، تطبقها على الخارج فتجدها مطابقة للواقع"، ووصف طبيعة تلك الأحكام الإسلامية المرتبطة بالعقل بصفات مثل:
1- العموم: فرسالة الإسلام موجّهة للإنسانة، ليست خاصة بزمان أو مكان أو مجتمع دون غيره.
2- الشمول: اتساع تعاليم الإسلام لتشمل مناحي الحياة وتضبط النظام الاجتماعي.
وقد نادى "ابن عاشور" بإصلاح التعليم، بما فيه التعليم الديني، كما نادى بتدريس العلوم الغربية مثل العلوم العقلية الفلسفية والرياضية والطبيعية، ووجد في ذلك سبيلاً لإصلاح الأمة، وطبّق بعض هذه العلوم على منهجه الديني الإصلاحي، فقد رأى أن الخطاب الديني في حاجة إلى توجيه جهود الإصلاح إليه عبر منهج عقلي عملي وعلمي معاصر، يعتمد على الآليات العلمية الحديثة، ويمكِّن من تحديد الخلل الذي انتقل بالأمة الإسلامية من حالة النهوض في بادئ أمرها، إلى التخلف الحضاري الذي جعلها رهينة الاستعمار الغربي، حسب قوله.
الفقه التقليدي
طالب "ابن عاشور" في مذهبه الإصلاحي لتجديد الخطاب الديني بأهمية "إصلاح التفكير" نفسه، والاعتماد على العقل وآلياته والعلوم ومنتجاتها في النظر إلى أحوال المسلمين، وترك المنهج التقليدي السائد في التراث، الذي يُجافي العقل ويعتمد في استنتاجه على القياس اللفظي دون استقراء حقيقي لطبيعة المشكلات الدينية، حسب قوله.
واجتهد "ابن عاشور" في تجديد الفقه الإسلامي، ووضع أُسساً لما وصفه بـ"علم فقهي جديد"، أطلق عليه "علم مقاصد الشريعة"، تضمّن أُسساً وقواعد فقهية جديدة، كما رأى فصل "علم مقاصد الشريعة" عن علم أصول الفقه الذي يهتم باللغة ودلالة الألفاظ، ما يجعل علم أصول الفقه يتسم بالاحتمالية دون اليقين رغم ادعائه عكس ذلك، حسب قوله.
وقصد بـ"علم مقاصد الشريعة" الاجتهاد في ما ينفع المسلمين عند تغير العصور والمجتمعات، ومراعاة ما يناسبها من مصلحة، لا سيما عند نزول الكوارث، وذلك عبر منهج يستند إلى العلوم العقلية وأدواتها الاستدلالية، لما يمكن أن تصل إليه من نتيجة واقعية تفيد الأمة الإسلامية، حسب قوله.
وقد اعتمد منهج "ابن عاشور"، الفقهي التجديدي، على نقد علم أصول الفقه، فانتقد عدداً من العلماء المشهورين في التراث الفقهي التقليدي، مثل أبي إسحاق الشاطبي (توفي 790هـ)، وأبي الحسن الأنباري (توفي 619 هـ)، الذين ادَّعَوا قطعية أدلة أصول الفقه وقطعيتها على عكس حقيقتها، وإهمالهم العناية بمعاني المقاصد والمصالح، إلا في ما ندر من بعض مسائل الحلال والحرام والبيوع وتجاهلهم المعاملات، حسب قوله.
واتهم "ابن عاشور" علماء الفقه في التراث الإسلامي وفي العصر الحديث، بأن أدلتهم الفقهية وإنتاجهم الفقهي "لا يخدم مقاصد الشريعة، لا سيما وأنهم اتبعوا منهج استنباط الأحكام من الألفاظ، دون الاهتمام بالواقع وحوادثه الطارئة"، حسب قوله.
وضرب مثلاً بتحريم بعض الفقهاء في العصر الحديث أكل خنزير البحر، دون البحث عن طبيعته، رغم الآية القرآنية التي تقول: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ...﴾ [المائدة: 96]، فجاء تحريمه فقط لارتباط اسمه بالخنزير، فجاء الحكم الفقهي استدلالياً لغوياً دون الاستدلال الواقعي، وفق قوله.
الإصلاح الفقهي
اعتمد منهج "ابن عاشور"، في علم مقاصد الشريعة، على القول باحتمالية الأدلة واعتبار المصالح ومراعاتها، ما لم يوجد في نصوص الشرع ما يمنعها وثبت فاعليتها في صلاح الأمة الإسلامية، مع الاجتهاد، لا سيما مع "تغير الأوضاع وتجدُّد الأحوال"، في المقارنة بين هذه المصالح للأخذ بما يفيد المسلمين وفقاً لظروفهم الاجتماعية والتاريخية وما يتعرضون له من تحديات ومواجهات، بهدف تمييز المصلحة الكلية على الأمة الإسلامية، أو على قطر من أقطارها، أو ما يتناسب مع مصالح جماعة كبيرة من المسلمين، وفقاً له.
استخدم "ابن عاشور" منهجاً عقلياً في تحديد مقاصد الشريعة، اعتمد على الاستقراء الفعلي والمنطق العقلي، وطبّقه على القرآن في استخلاص مقاصد الشريعة منه، معتمداً على وضوح الدليل القرآني واتفاق ظاهره مع باطنه، ما أمكن من استخلاص مقصد شرعي من القرآن، وفقاً له.
وقد أراد "ابن عاشور" في إصلاحه الفقهي، الوصول إلى قوانين وقواعد فقهية تهدف إلى إصلاح نظام المعاملات المدنية والآداب في المجتمعات الإسلامية، مع تأكيده نسبية هذه القوانين وارتباط صلاحيتها بمتطلبات العصر واحتياجاته المتغيرة والطوارئ النازلة به والتطور الحاصل به.
وقد تجاوز "ابن عاشور" مقاصد الشريعة التقليدية، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال، إلى مقاصد شرعية جديدة، انطلاقاً من المقصد الرئيسي الذي عرفه بأنه "المقصد الأعظم من الشرع، وهو جلب المصالح ودرء المفاسد وإصلاح العالم وأحواله"، حسب قوله، فوضع مقاصد جديدة تتناسب مع العصر الحديث، مثل:
1- المساواة: فأعطى حق المساواة للأفراد في الحقوق والواجبات؛ لأن الله خلقهم متساوين وضمِن لهم حق حفظ الحياة.
2- الحرية: وقصد بها الحرية الشخصية، وقدرة الفرد على الاختيار وفق عقله دون فرض رأي عليه.
3- التيسير: وهو مقصد يرى أنه هدف رئيسي للإسلام، الذي جاء تيسيراً على الناس في حياتهم وعباداتهم ومعاملاتهم.
تشريعات الضرورة
انتقد "ابن عاشور" تجاهل علماء الفقه، التشريعات والأحكام التي تفرضها الضرورة، التي أطلق عليها اسم "تشريعات الضرورة"، ونادى باعتبارها والأخذ بها ولو كانت "تشريعات مؤقتة"، وربط بينها وبين الضرورة العامة المؤقتة، وما قد يستتبع ذلك من إتاحة الممنوع لتحقيق مقصد شرعي، مثل سلامة الأمة والمجتمع والأفراد، التي تأتي بين أهم أولوياته.
وقد تجاوز الحالة الإسلامية في تشريعات الضرورة إلى مذهب إنساني عالمي، لارتباط مصير الأمة الإسلامية بالعالم، فقال: "مقصد الشريعة من التشريع هو حفظ نظام العالم وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسُد"، كما أنه ذهب إلى "مصلحة نظام العالم في احترام بقاء النفوس في كل حال"، حسب قوله.
وتأتي العلوم العقلية الفلسفية كمصدر معرفي رئيسي عند "ابن عاشور"، في منهجه الفقهي التجديدي؛ إذ يرى أن إصلاح مبدأ التفكير يؤدي إلى إصلاح العالم، بل وجعَل العقل من أسياسيات منهجه، فيقول: "جعل الله هذه الشريعة مبنية على اعتبار الحِكَم والعلل التي هي من مدركات العقول لا تختلف باختلاف الأمم والعوائد"، حسب قوله.
حقوق المرأة
أكد "ابن عاشور" أهمية المساواة بين الرجل والمرأة منطلقاً من القرآن وتكليفه للرجل والمرأة دون استثناء، ونادى بحقوق المرأة التي تضمَّنها قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ...﴾ [البقرة: 228]، وفسَّر وجود أحكام خاصة بالمرأة في القرآن باختلاف في الخلق والنوع بين الذكر والأنثى، حسب قوله.
لقد أعطى الله المرأة في الإسلام، حسب "ابن عاشور"، مكانة عبَّر عنها بأحكام خاصة بسبب النوع، ضارباً مثلاً بعدم فرض الجهاد على المرأة، لا بسبب تميز الرجل، بل بسبب الصفات الجسدية، وفي المقابل أعطى الإسلام حق الحضانة للمرأة دون الرجل لامتيازها عنه في هذا الشأن، حسب قوله، مشدداً على حق المرأة في التعليم دون تفريق بينها وبين الرجل في هذا الحق، الأمر الذي عبَّر عنه عملياً حينما تولى مشيخة جامع الزيتونة، فقد افتتح فرعاً به خاصاً بتعليم الفتيات تحت اسم "مدرسة السيدة عجولة".
وقد مال "ابن عاشور" إلى عدم تعدد الزوجات، وتعلل بـ"الخوف من عدم العدل"، الذي نصَّ عليه قوله سبحانه: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً...﴾ [النساء: 3]، وذهب إلى إمكانية وقف العمل بالنص القرآني الذي يبيح التعدد إذا اقتضت المصلحة ودعت الضرورة إليه، وأعطى سُلطة لولي الأمر في منع التعدد، حسب قوله.
وختاماً، تميز المشروع الفكري للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، بنظرة شمولية عالمية إلى الإنسان، حيثما كان مجتمعه، فنادى بتجديد الخطاب الديني عقلياً وعملياً، واستخدم في ذلك العلوم الحديثة والمناهج الفلسفية، وربط بينها وبين واقع المجتمعات الإسلامية وتطورها واحتياجاتها، ووجَّه سهام النقد إلى الفقه التقليدي السائد عبر التراث الإسلامي، والمسيطر على الواقع الحالي، وعمد إلى منهج فقهي "جديد" تضمَّن مقولات فقهية رئيسية جديدة طوَّرت مقاصد الشريعة، ونادى بإيجاد تشريعات جديدة، لا سيما في الحالات الطارئة التي تضرب المجتمعات الإسلامية وتهددها، رأى فيها إمكانية تجاوز النص وتعطيله، ولو مؤقتاً، لتحقيق سلامة الأمة والمجتمع، ما يمثل ثورة تجديدية في الخطاب الديني والفقهي.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.