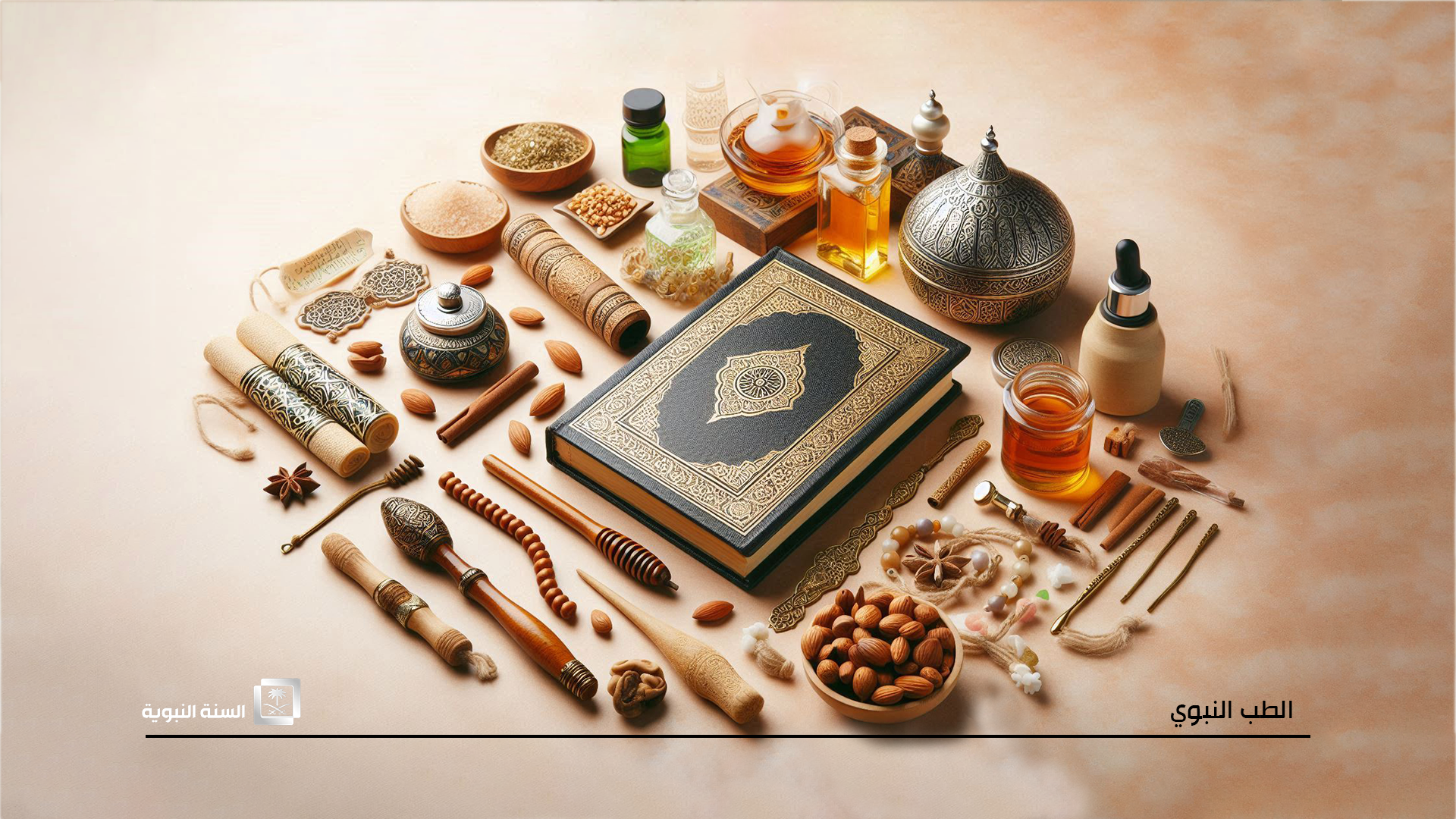
الطِّب النَّبَوي:
إشكالية مصطلح تختلف عليه الآراء
لم يستجِب النبي للمشركين حين طالبوه بخوارِق حسية ومادية ومعجزات تشبه معجزات الأنبياء والرسل السابقين عليه، مُستشهداً بآيات القرآن الكريم التي تتمثّل فيها آيات خلق الله في الكون، بوصفها دلائل على وجوده وقدرته وتمام نعمته. ومن المُلاحظ، أن آيات الذكْر الحكيم لم تتضمّن أي إشارة إلى معجزة خارقة للنبي الأكرم؛ لذا، متى وكيف ظَهَرَ مصطلح “الطب النَّبوي” في أحاديث الرواة والإخباريين والمحدّثين باعتبار محمد طبيباً معالجاً؟ ولِمَ راجَ هذا المصطلح وكَثُرَ طُلّابُه؟ وما الآراء الفقهية المؤيدة والمعارضة لهذا المصطلح؟
مصطلح الطب النبوي
ظَهَرَ مصطلح “الطب النَبوي” عند أبي بكر بن السّني في منتصف القرن الرابع الهجري، في كتابه المصنّف “الطب في الحديث”، وعند ابن شعبة الحرّاني في كتاب “الطب النَبوي”؛ وكَثُر تداول المصطلح بعد ذلك في القرن الخامس الهجري عند أبي القاسم النيسابوري، وأبي العباس المستغفري، حتى القرن الثامن الهجري، ليظهر المصطلح عند ابن قيم الجوزية في مصنفاته، خصوصاً كتاب “زاد المعاد”، ثم في أواخر القرن التاسع الهجري في مصنفات شمس الدين السخاوي، وجلال الدين السيوطي.
أما بالنسبة إلى تعريف الطب النبوي، فهو مصطلح يُطلق على مجموعة من النصائح المنقولة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تتعلّق بوصفات “طبيّة”، تطبَّب بها ووصفها لغيره، وصُنّفَت في شكل أحاديث، بعضها علاجي وبعضها وقائي، في ما يخص صحة الإنسان من وصفات علاجية للأمراض، ونصائح في الطعام والشراب والمداواة.
أولاً، آراء تؤيد الاستشفاء بـ”الطب النبَوي”: وَرَدَ في كتاب “الجمع بين الصحيحين” لمحمد بن عبد الله الجوزقي، أن رجلاً أتى النبي فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقِه عسلاً، ثم أتى الثانية، فقال: اسقِه عسلاً، ثم أتاه الثالثة، فقال: اسقِه عسلاً، ثم أتاه، فقال: فعلتُ، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقِه عسلاً فسقاه، فبرأ. ويذكر أبو عبد الله الحميدي عن حَبّة البَركة، في كتابه “الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم” حديث أبي هريرة، أنه سمع رسول الله يقول: “في الحبة السوداء شفاء من كل داء، إلا السَّام”.
وروى البخاري أن قوماً قدموا إلى المدينة، فمرضوا، فأشار عليهم النبي بالشرب من ألبان إبل الصدقة وأبوالها، حتى صحوا وسمنوا؛ وفي القصة أنهم ارتدّوا وقتلوا راعي الإبل، ثم أدركهم المسلمون وقتلوهم.
وقد ذهب الإمام السرخسي، وهو أحد أئمة المذهب الحنفي، إلى أن التداوي بأبوال الإبل “رخصة لأناس مخصوصين في وقت مخصوص، ولا يصح تعميمه على الناس إلى الأبد”؛ واستند في ذلك إلى قاعدة أصولية، مفادها: إن “حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط منها الاستدلال، وهذا في ما يتعلق بالوقائع الفعلية التي تحتمل التخصيص، وهو ما ينطبق على هذه الحادثة”.
ويقول السرخسي “إن الحديث حكاية حال، فإذا دار بين أن يكون حجة، أو لا يكون حجة، سقط الاحتجاج به، ثم نقول: خصَّهم رسول الله بذلك، لأنه عرف من طريق الوحي أن شفاءهم فيه، ولا يوجد مثله في زماننا، وهو كما خصَّ الزبير بن العوام بلبس الحرير لحكّة كانت به، أو لأنهم كانوا كفاراً في علم الله تعالى، وقد علم رسول الله من طريق الوحي أنهم يموتون على الرِّدَّة، ولا يبعد أن يكون شفاء الكافر في النجس”، حسب قوله.
ويقول بدر الدين العيني، في “عمدة القاري”، وهو من أئمة المذهب الحنفي، بأن “إبِلَه عليه الصلاة والسلام ترعى الشيح والقيصوم، وأبوال الإبل التي ترعى ذلك وألبانها تدخل في علاج نوع من أنواع الاستشفاء، فإذا كان كذلك، كان الأمر في هذا أنه عليه الصلاة والسلام عرف من طريق الوحي كون هذه للشفاء، وعرف أيضاً مرضهم الذي تزيله هذه الأبوال، فأمرهم لذلك”، حسب قوله. ويذكر أبو عبد الله المازري، في كتاب “المُعلم بفوائد مسلم”، أن رسول الله قال: “من تَصَبّح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سُمٌّ حتى يمسي”.
وأقرَّه غير واحد كالإمام ابن العربي، مالكي المذهب، والقاضي عياض وابن حجر العسقلاني والمناوي. ويقول أبو العباس القرطبي: “فحيث أطلق العجوة هنا إنما أراد به عجوة المدينة، وظاهر هذه الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السُّمِّ، وإبطال السحر، ثم هل ذلك مخصوص بزمان نطقه عليه الصلاة والسلام أم هو في كل زمان؟ كل ذلك محتمل، والذي يرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة؛ فإن وجدنا ذلك كذلك في هذا الزمان، علِمنا أنها خاصة دائمة، وإن لم نجده مع كثرة التجربة، علمنا أن ذلك مخصوص بزمان ذلك القول”. ويقول ابن حجر العسقلاني بأن هذه الرواية “لا تقتضي الحكم عليها بالبطلان”، حسب قوله.
ويذكر ابن قيم الجوزية، في “زاد المعاد”، أن رسول الله قال: إن أمثَلَ ما تداويتم به الحجامة، وذهب ابن القيم إلى أنها إشارة إلى أهل الحجاز، والبلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة، وليس طِبُّه عليه الصلاة والسلام كطِبِّ الأطباء، فإن طبَّ النبي متيقَّنٌ قطعي إلهيٌ، صادرٌ عن الوحي ومِشْكاةِ النبوة وكمالِ العقل، وطبُّ غيرِه أكثرُه حَدْسٌ وظنون، وتجارِب، ولا يُنْكَرُ عدمُ انتفاع كثير من المرضى بطبِّ النبوة، فإنه إنما ينتفعُ به مَن تلقَّاه بالقبول، واعتقاد الشفاء به، وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان، حسب قوله.
ثانياً، آراء ترفض الاستشفاء بـ”الطب النَّبوي”: يقول ابن خلدون في “كتاب العِبَر”: “وكان عند العرب من هذا الطب كثير، وكان فيهم أطباء معروفون كالحارث بن كلدة وغيره، والطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحي في شيء، وإنما هو أمر كان عادياً عند العرب، ووقع في ذكر أحوال النبي من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة، فإنه عليه الصلاة والسلام إنما بُعث ليعلمنا الشرائع، ولم يُبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات، وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم”.
ويؤكد ابن خلدون بأنه “لا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث الصحيحة المنقولة على أنه “مشروع”، فلا يوجد ما يدل عليه، اللهم إلا إذا استُعمل على جهة التبرُّك وصدق العقد الإيماني، فيكون له أثر عظيم في النفع، وما ثبت أن النبي قاله معتمداً في ذلك على التجربة كغيره من الناس، فهذا الإشكال في أنه يؤخذ منه ويُترك وقد يصح وقد لا يصح”.
ويقول الدكتور إبراهيم رضا، العالم الأزهري: “إن التداوي بالحجامة والطب النبوي لم يكن أيام الرسول أو الصحابة، ولكن جرى بعدهم بسنوات طويلة”؛ مُشيراً إلى أن القرآن الكريم “لا يعالج الأمراض العضوية، ومن يعتقد ذلك فهو جاهل، والنبي لم يدرس الطب، وأن الحجامة مثالاً هي عادة عربية وتوارثها الأشخاص منذ عشرات القرون”.
ويؤكد أن الرسالة المحمدية قد “حررت العقل من الخرافات والأوهام”، وأن “المنهج الإسلامي يتسم بالانفتاح على الحضارات الأخرى، ولَم يجعل الطب -تعلماً أو ممارسة- حكراً على العرب أو المسلمين وحدهم، بل فتح باب العلم والمعرفة لأهل الديانات الأخرى، فظهرت أسماء مسيحية ويهودية بارزة في علم الطب”، وأن “الحديث العلمي عن الطب يجب أن يُترك لأهل الطب”، حسب قوله.
وتذهب دار الإفتاء المصرية إلى أن “أبرز العلوم التجريبية، التي أسهمت فيها الحضارة الإسلامية بالنصيب الأوفر، هو علم الطب؛ ذلك العلم الذي يهتم بصحة الإنسان ويضع له طرق الوقاية والعلاج من الأمراض”. ولم يقتصر إسهام الحضارة الإسلامية في مجال العلوم الطبية على اكتشاف الأمراض المختلفة، ووصف الأدوية المناسبة لعلاج هذه الأمراض، بل اتسع وامتد إسهام المسلمين في الحضارة الطبية حتى بلغ مرحلة التأسيس لمنهج تجريبي دقيق يتفوق ويسمو على مناهج المدارس الطبية التقليدية التي كانت سائدة قبل الإسلام.
وختاماً، فإن الرسالة المحمدية قد جاءت لتعلّم الناس التوحيد ومكارم الأخلاق، ولم تأتِ لتعلمهم أمور الطب والهندسة والعلوم؛ فالقرآن الحكيم ليس كتاباً للعلوم الوضعية، ووصفات الطب الشعبي الواردة في كتب المحدّثين والإخباريين والرواة، ليست من الوحي القرآني في شيء. وقد اتفق جمهور المسلمين في العصر الحديث على ترك أمور الطب والعلوم الوضعية لاختصاصييها، وهي الأمور التي لم تكن قط من اختصاص الفقهاء والمفسّرين، فقد ترك لنا القرآن آية يُفهم من عموم معناها أن عليكم بأهل الاختصاص، نعني قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.