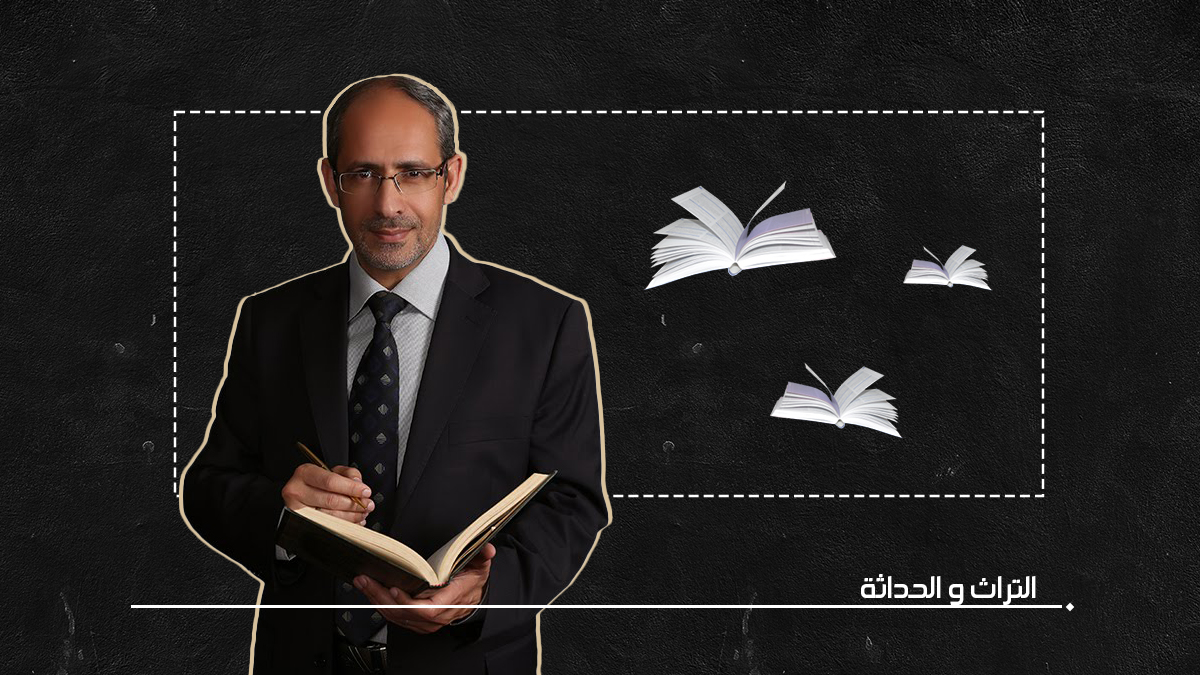
عامر الحافي:
مشكلتنا ليست مع الحداثة أو التراث بل مع بعض الحداثيين والتراثيين (الجزء الثاني)
يستكمل مركز “حوار الثقافات” حواره مع الدكتور عامر الحافي، أستاذ العقائد بكلية الدراسات الفقهية بجامعة آل البيت الأردنية، وفي الجزء الثاني من حواره يتكلم عن الحداثة ومعركتها الدائرة مع التراث والنتيجة المتوقعة، وينتقل أيضاً إلى النقاش حول القرآنيين وفكرهم بشكل عام، ويحلل كذلك التعددية الدينية في القرآن وكذلك رؤيته للحركة التنويرية في عالمنا العربي.
وإلى نص الحوار:
في مسألة التراث والحداثة.. كيف يجب التعامل معها لنخرج بمشروع نهضوي تنويري مناسب بعيداً عن التشدد؟
بداية العلاقة بين التراث والحداثة محفوفة بـ3 مخاوف؛ الخوف الأول على التراث، والخوف الثاني من الحداثة، والثالث خوف من السلطة الدينية التي تدافع عن التراث، وطبعاً هذه مخاوف مقدّرة ويجب أن نستوعبها؛ إذ يوجد من اعتبر الحداثة النقيض الكامل للتراث، وأعتقد أن الفصل الكامل بين الحداثة والتراث ضروري؛ الحداثة يجب أن تحترم حاجة الإنسان إلى الدين وتحترم الحقيقة التاريخية والقيم الأخلاقية المشتركة بين جميع البشر مثل الصدق، والأمانة، والعدل، وبالتالي إذا كانت الحداثة نقيض التراث، والتراث يشتمل على كثير من هذه القيم والحقائق التاريخية وغير ذلك، فهنا يجب أن نتوقف كثيراً إذا أردنا وضع الحداثة نقيضاً للتراث؛ لأنه ستظهر مشكلة حقيقية في فهم جدوى الحداثة التي نتحدث عنها؛ إذاً مشكلتنا ليست في الحقيقة مع الحداثة أو مع التراث، بل مع بعض الحداثيين ومع بعض التراثيين؛ فالهروب أو الخوف من الغرب والاستعمار الحديث كلّفنا كثيراً في مجتمعاتنا العربية وجعلنا نخاف من التجديد والتغيير والاستفادة المعرفية من العلوم الطبيعية والإنسانية، البعض جعل العلوم الإنسانية بمثابة أيديولوجيات لا يمكن الاستفادة منها، أنا أقول لا، العلوم الإنسانية بإمكاننا الاستفادة منها، علم الاجتماع وعلم النفس وغيرهما يمكن للمجتمعات العربية الاستفادة منها اليوم؛ إذ ظلت فترة طويلة مشككاً بها وتُعتبر جزءاً من أجندة عقائدية وبروتوكولات حكماء صهيون وغيرها؛ لأن البعض يرى أن من أسس علم النفس يهودي، وهكذا، النظرة السلبية لتلك المعارف التي أسهم فيها الغرب جعلت البعض يتراجع ويشكل نوعاً من الحاجز الذي يفصل بينه وبين المجتمع الحديث.
هل تعاملت كتب التراث مع التعددية الدينية كما تعامل معها القرآن بانفتاح؟
التعددية الدينية هي حقيقة اجتماعية وتاريخية وقرآنية، فقد أشار القرآن الكريم مثلاً إلى وجود أتباع لـ6 أديان، هم المسلمون واليهود والنصرانيون والصابئة والمجوس والمشركون، وقد تعاملت كتب الفقه مع ما يُعرف بمن لهم شبه كتاب أو كتاب كما يقول البعض أيضاً، لكن نحن نعلم أن التراث الفقهي تراث تاريخي يرتبط بسياقات اجتماعية وتاريخية معينة؛ أي إنه لا يمكن أن يكون الانعكاس الكامل للمعنى الشامل الذي جاء به القرآن الكريم، المعنى الشامل الذي يأتي به القرآن الكريم هو معنى يشمل التاريخ الإنساني كله، يشمل كل من يجتهد واجتهد في الماضي وسيجتهد في المستقبل، وبالتالي هذا المعنى يستعصي على نموذج محدد من نماذج الاجتهاد، أو فترة تاريخية محددة.
ومن الضروري أن نتعامل بعمق مناسب وفهم صحيح مع فكرة أن السلف هم الذين استوعبوا الحقائق التاريخية وحدهم دون غيرهم، لكي لا نجعل فهم الإسلام لفئة معينة من البشر، وهذا لمن كان له وعي عميق يدرك أن هذا ينفي عالمية وشمولية الإسلام التي نتحدث عنها؛ فالقرآن الكريم تحدث عن التعددية، حتى في ما يتعلق بقبول تعدد الأديان في آيات “ومن شاء فليكفر”، “إن الذين آمنوا”، أي يوجد مؤمنون ونصارى ويهود، ووجودهم جزء من المجتمع، وهذه حقيقة اجتماعية في عصر النبي وقبل عصره وبعد عصره، لكن لا نستطيع القول إن هذه التعددية الدينية كانت في أعظم تجلياتها، أو إن كتب التراث استطاعت أن تستوعب المقاصد والمعاني الكبرى التي أراد القرآن من العقل البشري استيعابها، وأعتقد أن التعددية الدينية في كل عصر من العصور ارتبطت بالتعددية السياسية؛ فإذا كان السياسيون في عصر ما منفتحين على غيرهم من الاتجاهات السياسية الأخرى، سمحوا بالتعددية الدينية، وإذا كانت التعددية السياسية ممنوعة فهذا يعني أن التعددية الدينية لن يُسمح لها أن تكون على المستوى المطلوب، وفي الوقت نفسه يوجد عمق فلسفي وضرورة لاحترام وجود هذا التعدد؛ لا بد أن يبقى الناس مختلفين، “ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة”، فمشيئة الله إذاً أن نتعدد.
هل ما يدور على الساحة بين الحداثيين والتراثيين الآن صحي أم هو مجرد جدال لن يوصل إلى نتائج مفيدة؟
الاستقطاب صار مفروضاً في واقعنا العربي والإسلامي عموماً بين الحداثيين والتراثيين، وأعتقد أن جزءاً من هذا الاستقطاب ذو بُعد سياسي.. يوجد أيضاً جانب يتعلق بالغرب والموقف منه، لاحظ مثلاً الشكوك التي لاحقت محمد عبده لأنه ذهب إلى باريس، والأفغاني كذلك، واتهامهما بأن موقفهما يتماس أكثر مع الغرب، رغم أن ذلك ضروري لنعرف هذا الاشتباك وهذه المشكلة بين الحداثيين والتراثيين على حقيقتها؛ فالموقف من الحداثيين ارتبط بالموقف من الغرب نفسه، والموقف من الغرب ارتبط بالموقف من الاستعمار الغربي الحديث، وغير ذلك من القضايا، ما جعل المسافة تتباعد بين الحداثيين والتراثيين أكثر فأكثر، باختصار يجب أن نبتعد عن تقديس التراث وأيضاً يجب أن نبتعد عن تقديس النموذج الغربي للحداثة.
كيف ترى مستقبل فكر القرآنيين في العالم الإسلامي؟
بين القرآنيين والمعتزلة نوع من التشابه؛ إذ يوجد فعلاً أثر كبير جداً بقي من المعتزلة في تاريخنا الإسلامي، والقرآنيون والمعتزلة يتشابهان في منهج العقلانية، وهذا الاتجاه يحاول وضع العقل موضعه اللائق في القضية الدينية، لكن ذلك لا يعني أن جميع الاتجاهات أو جميع الشخصيات التي تتحدث باسم القرآنيين في نفس السياق، صعب جداً أن نقول إن القرآنيين يمثلون اتجاهاً واحداً بمعنى الكلمة، لكني أعتقد أن الاتجاه القرآني له أثر إيجابي في تحريك المواد الرسوبية في الفكر الديني والتراثي، التي أصبحت عالية جداً، وبالتالي استطاع القرآنيون تحفيز العقل الديني التقليدي ليجد خطاباً مختلفاً ويبحث عن صيغ مغايرة لفهم القضايا الدينية بمنظور مختلف، فوجود هذا التمثل المتباين له أثر إيجابي؛ إذ يمكن أن أقارن ما حدث في التاريخ المسيحي من ظهور الفكر الإصلاحي لدى مارتن لوثر، وشعاره الأساسي الذي كان يتحدث عن السولاسكربتورا، يعني أن الكتاب المقدس وحده أساس البناء الإصلاحي الديني وبناء الفكر الديني عموماً، كذلك الحال، فالمسار القرآني يماثل ما يحدث عادة في تاريخ الإصلاح الديني في التيارات عموماً وبين أتباع الأديان حتى في اليهودية، فإننا نعرف الجدل ما بين التوراة المكتوبة والتوراة الشفوية، وفي الحالة الإسلامية يوجد قرآن وتوجد سُنة (منسوبة للنبي)، وقد تظهر مصادر ثالثة ورابعة وهكذا، ولكن الحقيقة أن فهم هذه الظاهرة –الثنائية- في سياقها الديني عموماً يساعدنا في معرفة التعاطي معها والتعامل واتخاذ موقف منها في سياقها الخاص، سواء كنا نتحدث إسلامياً أو غير ذلك، وأرى أن مستقبل القرآنيين هو مستقبل الحريات الدينية ومستقبل التعليم الديني، هذا يعتمد إذا كان التعليم الديني في مجتمعاتنا العربية والإسلامية سينسجم مع تعليم العلوم الاجتماعية والإنسانية في تدريس الشريعة الإسلامية، فكلما توسعت هذه المعارف في مناهج التعليم الديني ستوجد مساحة أكبر للاعتماد على القرآن، وجزء من ظاهرة القرآنيين يعود إلى محاولة الدفاع عن أصالة وأولية القرآن حتى ولو حدثت مبالغة من البعض، لكنه توجُّه يجب تقديره.
كيف تقيم تجربة القرآنيين ورؤيتهم للعلاقة بين الدين والدولة؟
هي رؤية مختلفة، خصوصاً أننا نتحدث عن النظرة القرآنية التي لا تأخذ التجربة التاريخية للتاريخ الإسلامي أو ما قاله الفقهاء هنا وهناك على أنه بالضرورة يعني التفسير النهائي لعلاقة الدين بالدولة؛ فالنظرة القرآنية لمسألة السياسة هي نظرة شمولية تقوم على مقاصد السياسة، فلو أخذنا الدكتور محمد شحرور مثلاً في تأكيده عالمية الخطاب الإسلامي وعالمية النظرة الإسلامية بأنها نظرة متطورة وتقبل التطور وتمثل لهذا التطور، فالإنسان هو الذي ينظم ويطور مجتمعه، وقدرة هذه النظرة على استيعاب التغيرات السياسية في مجتمعاتنا قد تكون فعلاً أكبر من الاتجاهات الأخرى؛ فهي غير حرفية وغير مذهبية واجتهادية وعقلانية، وكما قلنا أيضاً قبل كل شيء، هي نظرة عالمية لأنها تريد أن تجعل الفكرة، ليس فقط لطائفة معينة أو لأتباع ملة معينة، وإنما هذه الفكرة صالحة للممارسة الإنسانية عموماً، وهذه النظرة القرآنية للمقاربة ما بين الدين والدولة تجعل الاتجاه القرآني أقدر على التعامل مع هذه القضية، فالعلاقة بين الدين والدولة علاقة إشكالية في الفكر الديني عموماً، وليس الفكر الإسلامي فقط، وتحتاج إلى نظرة جديدة، وما طرحه بعض القرآنيين كان له آثر إيجابي في ذلك.
متى وكيف يمكن أن تنجح التجربة التنويرية في مجتمعاتنا العربية؟
ستنجح بالتأكيد؛ لأن التنوير هو التحقق الأمثل للرسالة الإسلامية، وهو التحقق الأمثل للرسالات والشرائع التي أنزلها الله جميعاً، ويمكن للتنوير أن يتحقق عندما تتحرر الإرادة ويولد الفكر الحر ويكون التعليم نوعاً من تحقيق الذات والتعبير عن الفكرة الذاتية أو الفكرة الروحية العميقة، وليس تعليماً كمياً أو نمطياً، جودة التعليم ونوعية التعليم وليس كمية وأنماط التعليم، إذاً يمكن للتجربة التنويرية أن تنجح عندما يزول الانفصام بين الدين والدنيا؛ فإمكانية نجاح تجربة التنوير هي إمكانية حقيقية وواردة والمجتمعات الغربية تلك التي كانت تعيش في القرون المظلمة وكانت مجتمعات في غاية الرداءة والتوحش، الآن نجد أنها استطاعت الوصول إلى ما يقول ديكارت عنه: “عندما يخرج الإنسان عن شعوره بالقصور الذاتي وأن العقل غير قادر على المعرفة وعاجز ولا قيمة له، يجب أن نتوقف وننتقد هذه النظرة السلبية ونترك الفكر الخرافي الذي تسلل وعاد إلينا من خلال مقولات دينية منتشرة”.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
لقاءات خاصة
عامر الحافي: بعض المذاهب الإسلامية لم تشتهر رغم أنها أصوب من الرائج (الجزء الأول)
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.