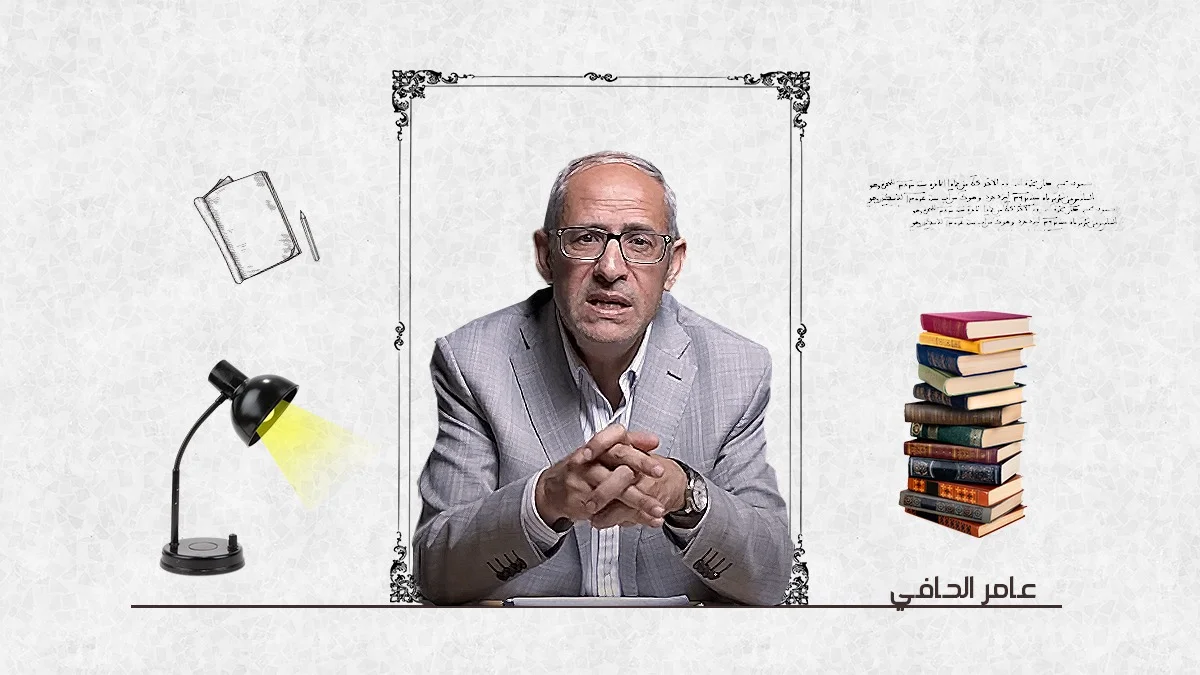
عامر الحافي:
بعض المذاهب الإسلامية لم تشتهر رغم أنها أصوب من الرائج (الجزء الأول)
مجموعة من الأطروحات الشائكة يعرضها الدكتور عامر الحافي، أستاذ العقائد بكلية الدراسات الفقهية بجامعة آل البيت الأردنية، وعلى رأسها مسألة علوم القرآن، التي يرى أنها “ناقصة وتحتاج إلى تطوير”، ويشرح خلال حواره مع مركز “حوار الثقافات” كيف يمكن تطويرها، وبعض الجدليات حول الشريعة الإسلامية والأحكام الفقهية.
وإلى نص الحوار:
- تقول إن “علوم القرآن لم تكتمل ولم تُنجز، والمعارف القرآنية تحتاج إلى تطوير”.. فماذا ينقص علوم القرآن؟
المعارف القرآنية معارف بشرية، يعني أن المفسر هو الذي وضع هذه المعارف، وبالتالي لا نستطيع القول إن علوم القرآن هي قرآن بحد ذاتها، هذه العلوم يوجد من العلماء مَن قال إنها 50 عِلماً، ومنهم مَن قال إنها أكثر من 7000 علم، إذاً، كيف يمكن أن نحصر علوم القرآن في عدد محدود من المعارف، خصوصاً مع التطور المستمر؛ فالمعارف التي تتعلق بالكونيات غير محدودة ومستمرة ومتطورة، وتوجد علوم جديدة مثل علم الجينات والهندسة الوراثية والذكاء الاصطناعي، فماذا عن الأمور الشرعية والجانب الديني؟ هل الجانب الديني منفصل عن حركة الإنسان والتطور المعرفي الطبيعي؟ بالطبع لا؛ لذلك يجب الالتفات إلى فكرة كتاب الله المقروء وكتاب الله المنظور، هذا التقسيم الجميل، كثير من العلماء تحدثوا عنه، وهو أن القرآن هو كتاب الله المقروء، والكون هو كتاب الله المنظور، وكلاهما من إبداع الله، وإذا كانت علوم كتاب الله المنظور غير متناهية، كذلك الحال فإن علوم كتاب الله المقروء غير متناهية، وأستدل بكلام سهل التستري، أحد علماء أهل السنة، عندما يقول: “لو أُعطي العبد بكل حرف من القرآن 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية منه، لأنه كلام الله وكلامه صفته”، إذاً، لا يمكن القول بوجود حد لفهم المعارف المترتبة على كلام الله، هذا يوحي بأن كلام الله محدود، وإذا كان محدوداً يعني أنه “مخلوق”، وإذا كان كلام الله هو صفة الله، إذاً لا يمكن الإحاطة بهذه الصفة كاملة، هنا يجب أن تستمر المعارف والعلوم في التطور، لكن أيضاً بنفس الاتجاه مشكلة كبرى: هل هذه العلوم يمكن أن ينقض بعضها بعضاً، هذه إشكالية يجب التفكير فيها؛ إذ توجد ثوابت يجب التركيز عليها، منها كلام ابن عباس: “أُنزل القرآن على 4 أوجه، الأول لا يسع أحد جهله ويتعلق بالحلال والحرام، والثاني تفسير يعلمه العلماء، والثالث عربية تعرفها العرب، والأخير تأويل لا يعلمه إلا الله”، 4 أنواع من المعارف اشتمل عليها القرآن، الأول بدهيات أي إنسان يعرفها، والثاني تفسير يعلمه العلماء، هنا تباين كبير جداً؛ لأن العلماء وعلومهم ومجتماعتهم يتغيرون من عصر إلى عصر، إذاً، كيف يمكن أن يوجد تفسير واحد لهؤلاء العلماء؟ الوجه الثالث عربية تعرفها العرب، هنا أريد الإشارة إلى قضية مهمة؛ إذ علوم ومعارف قرآنية يجب اليوم أن نشرعها، مثل علم الآثار القرآني، وعلم الاجتماع القرآني، وعلم ترجمة القرآن، وعلم اللغات المقارن، هذه العلوم في غاية الأهمية اليوم إذا أردنا جعل القرآن الكريم كتاباً عالمياً ليس فقط لمجموعة أو فئة طائفية.
- ما أهم التحديات التي تواجه التراث الإسلامي في العصر الحديث؟
أولاً لا بد أن نحرر مفهوم الشريعة؛ فكثير من الناس مفهوم الشريعة بالنسبة لهم هو تلك الأحكام، أحكام العقوبات/الحدود على وجه التحديد، التي تتضمن قتل المرتد، ورجم الزاني المحصن، وقطع يد السارق.. إلخ، ورغم أن هذه الأحكام بعضها لم يأتِ بأدلة قطعية، وإنما جاء بأدلة ظنية، وهذا طبعاً تُبنى عليه إشكالات كبرى حول قضية تطبيق الشريعة، لكن إذا كان مفهوم الشريعة غير واضح في الأذهان، فما بالكم بما يتعلق بمفهوم تطبيق الشريعة؟ إذاً، مفهوم الشريعة يختلف عن مفهوم الفقه، الفقه يتعلق بالأحكام العملية، والشريعة أوسع من ذلك بكثير، فهي مفهوم يشتمل على الأخلاق والقيم والجوانب الإيمانية، الشريعة الإسلامية أشمل بكثير من أن نجعلها جزءاً من الأحكام العملية، خصوصاً عندما نحصرها في جزء من أحكام العقوبات.
مفهوم الشريعة يحتاج إلى إعادة توضيح في أذهان كثير من الناس، ويجب مراعاة أن تغير الأحكام يتأثر بتغير الأزمان، فنحن اليوم في واقع تاريخي مختلف، ولا أدل على ذلك من أحكام الرق وما يتعلق بها من قضايا مختلفة، والتسري، والإماء، والجواري، وما ملكت أيمانكم وغير ذلك، فهل كل ما يتعلق بالأحكام العملية المتصلة بالشريعة الإسلامية هي أحكام أبدية يجب أن تُمارس مهما كانت الظروف ومهما تغيرت المجتمعات؟ بالطبع لا، توجد جوانب ثابتة، لكن أموراً كثيرة قد تغيرت، وكلنا نعرف أن القرآن المكي يختلف عن المدني؛ إذاً تغير الظرف المكاني والثقافة أثَّرا، “لكلٍّ جعلنا منكم شِرعةً ومِنهاجاً”، لماذا اختلفت شرائع ومناهج الأنبياء؟ لأن أزمانهم وأقوامهم وثقافتهم تغيّرت، فهل آن لنا أن نعتبر بتاريخ الأنبياء وأن الشرائع لها جانب تاريخي وثقافي يتأثر بثقافات الشعوب والأمم؟!
- ما دور الاجتهاد في الشريعة الإسلامية؟ وكيف تُستخرج الأحكام الشرعية من النصوص؟
الاجتهاد ضرورة إيمانية وإسلامية واجتماعية وحياتية يجب التزامها والسعي لها، وليس ميزة تكميلية؛ الأمة إن لم يكن فيها مجتهدون أثِمت وأصبحت مُدانة بعيدة عن شرع الله، واجتهاد العلماء يأتي من باب “مَن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر”، لكن مَن الذي يحكم بأن المجتهد أصاب أو أخطأ؟ يوجد مَن يَعتبر الاجتهاد أمراً حصرياً على مذاهب فقهية محددة، وهذا خطأ؛ لأن بعض المذاهب لم يشتهر ولم يكن له تلاميذ وأتباع يحملون رايته؛ مثل الليث بن سعد أو ابن حزم الأندلسي أو الإمام الأوزاعي، وغيرهم ممن لهم اجتهادات جليلة أحياناً كانت الصواب رغم قلة الأتباع، إذاً لا يحق لمجتهد أن يلغي حق غيره في الاجتهاد، وهنا أيضاً يجب توسيع دائرة الاجتهاد، فهل من المنطقي أن ينحصر في المذاهب الفقهية وفي الفروع أم يشمل كذلك أصول الدين؟ هل العالِم الذي يجتهد لمعرفة السّبحة سُنة أم بدعة يؤجَر عند الله والعالم الذي يجتهد في تأليف كتاب من 15 مجلداً مثل كتاب المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار المعتزلي غير مأجور في اجتهاداته الكلامية؟ هل المعتزلة فرسان علم الكلام في الدفاع عن حقائق وعقائد الإسلام غير مأجورين لأن اجتهادهم في قضايا عقائدية والقضايا العقائدية لا يجوز فيها الاجتهاد؟
أقول إن الاجتهاد، أياً كان، مأجور، سواء في فروع عملية وأحكام فقهية أم في قضايا نظرية وكلامية وعقائدية.
استخراج الأحكام الشرعية من النصوص يتطلب معرفة اللغة العربية والثقافة العربية ومعهود العرب، كما يقول الشاطبي: “القرآن نزل على معهود العرب”، وهذا ضروري جداً لفهم علم الدلالات، وهنا أشير إلى علم أصول الفقه لأنه بمثابة المنطق الناظم والميزان للتعامل مع النصوص القرآنية لاستخراج الأحكام، مثلاً توجد قاعدة “الأمر يفيد الوجوب”، فهذه القاعدة وضعها الشافعي في كتاب الرسالة، وتقول إن للاجتهاد قواعد مثل أي علم وليس مجرد خاطرة أو رأي؛ فالنبي عندما بعث بمعاذ إلى اليمن قال له: بمَ تحكم بينهم وهؤلاء قوم حديثو عهد بالدين، قال أحكم بكتاب الله، قال وإن لم تجد؟ وذلك بناءً على أنه ربما لا يجد المفكر في النص القرآني قاعدة يستدل بها على قضية معينة، قال معاذ بسُنة رسوله، قال وإن لم تجد؟ قال أجتهد برأيي.
- إلامَ يحتاج تفسير القرآن غير الدراية بلغة العرب؟ وهل الفلسفة ضمن حاجات المفسِّر الضرورية؟
يحضرني بدايةً ما ربط به الفيلسوف المسلم ابن رشد في كتابه فصل المقال للحكمة بالشريعة، واعتبر الحكمة والفلسفة الأدلة البرهانية، وبالتالي الحكمة والشريعة شقيقتان على هذا الأساس؛ فتفسير القرآن يحتاج إلى جانب من اللغة العربية وأيضاً إلى المعرفة العقلية، وهنا قضية العقل والنقل تبرز أمامنا؛ إذ يحدث تكامل بين العقل والنقل، وليس تناقضاً، إذاً تفسير القرآن في حاجة إلى علوم ومعارف عقلية، وليس فقط مجرد مرويات ومحفوظات وسرديات؛ المعرفة العقلية لقوم يعقلون، القرآن جاء لقوم يعقلون، ولذلك فالفلسفة بمعناها العميق المتضمن البحث عن الحقيقة وحرية الفكر والنقد ورفض الخرافات وعدم التناقض الذي هو قاعدة منطقية يقوم عليها العقل، قضية أساسية جداً يجب أن تكون من أساسيات التفسير؛ فكثير من العلماء كتب في أصول وقواعد التفسير، هذا علم في غاية الأهمية، لكن هل هذا العلم بحد ذاته أُغلق بابه وانتهت المعرفة إلى ما آلت إليه في العهود السابقة؟ أبداً، يجب التعامل مع العلوم الدينية كما العلوم الدنيوية. ستيفن هوكينج عندما تحدث عن الثقوب السوداء ونظرته إلى الكون قبل موته بفترة وجيزة أعاد النظر في بعض مقولاته العلمية المتعلقة ببداية الكون، كذلك الحال في “الفيزياء الدينية” -إذا صح التعبير- يجب الاعتراف أنها علوم تقبل الاستزادة والتطوير والمراجعة والنقد، لذا فالفلسفة ضرورية؛ لأن الفيلسوف يرفض بطبيعته الأحكام المسبقة ويختلف عن عالِم الكلام، لأنه يبحث عن الحقيقة. العقل الفلسفي ضرورة ونحتاج إلى وجود تيار فلسفي في الإسلام؛ لأنه يحفزنا على مراجعة ما لدينا والاستزادة وتقديم مقاربات جديدة في فهمنا الديني. الفلسفة ستجعل خطابنا الديني وتفسير القرآن تفسيراً عالمياً، ابن رشد كان يتكلم ويفكر نيابة عن البشرية كلها ويتعاطى مع أي قضية معرفية على أنها تحدٍّ للعقل البشري عموماً، كذلك الحال في فهم القرآن؛ إذ يجب أن يكون مستحضراً الهم البشري ويخاطب المسلم وغير المسلم؛ لأن هذا خطأ وقع فيه المسلمون عندما جعلوا القرآن طائفياً، خلافاً لقاعدة المعتزلة: “لا يخاطب الله عباده بما لا يعقلون”.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
لقاءات خاصة
زهية جويرو: القرآن ضمن للنساء جملة من الحقوق إنصافاً لهن من الظلم الاجتماعي الذي عانينه في إطار مجتمعات ذكورية (1-2)
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.