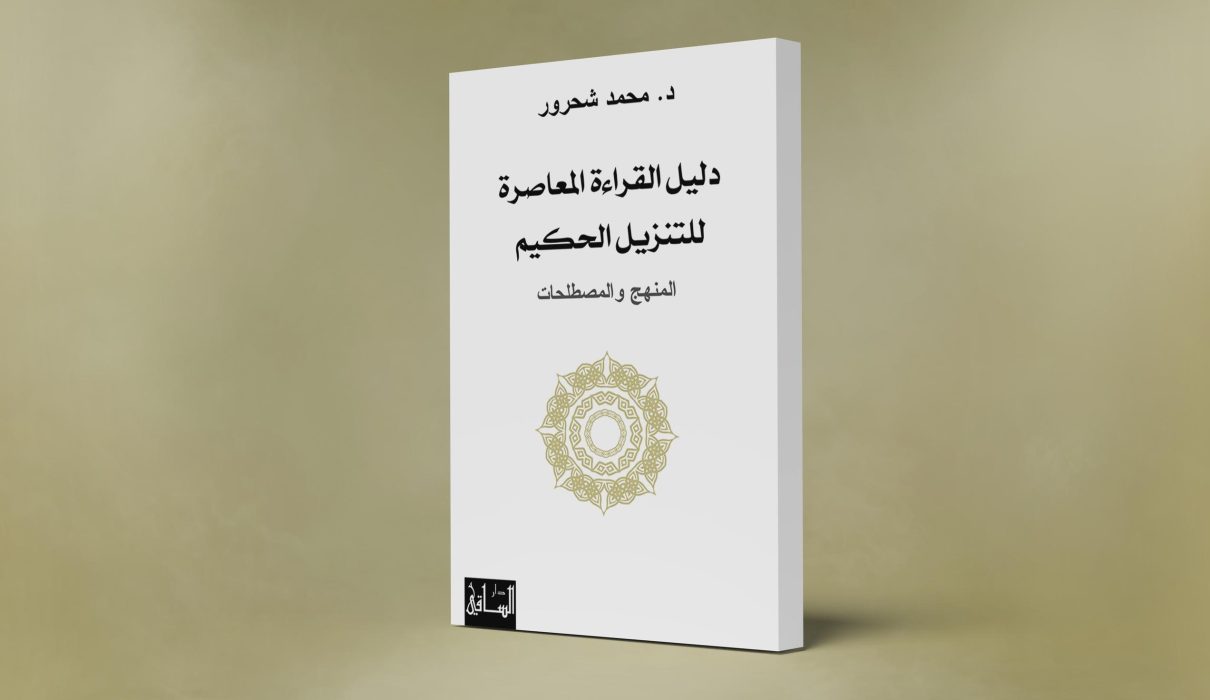
منهج مغاير:
كيف يقدم "شحرور" قراءة مختلفة للقرآن الكريم؟
شكّلت العلاقة بين القرآن والسنة النبوية، وقضية مصدر التشريع في الدين الإسلامي بصورة عامة، موضع اهتمام الكثير من الباحثين، ومن هؤلاء الدكتور محمد شحرور الذي يقدم في كتاب “دليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم”، والذي صدرت طبعته الأولى عام 2016، عن دار الساقي، قراءة مغايرة للتنزيل الحكيم، وذلك استناداً إلى مقاربة تجمع بين المنهج اللغوي والمنهج الفكري للقرآن الكريم.
ويرى الكاتب أن تناوله للقرآن الكريم يأتي “بفضل اختراق الكثير مما يسمى الثوابت في المنظومة التراثية، وخاصة ما يسمى الفقه وأصوله، التي وضعها أناس عاشوا في القرون الهجرية الأولى”، والتي هي برأي الكاتب “لا تحمل أي قدسية لأنها تمثل المنظومة القانونية للدولة التي نشأت في ظلها”.
مبادئ المنهج
ينطلق الكاتب في كتابه من فرضية رئيسية مفادها أن القرآن كتاب منزَّل من إله كامل العلم والمعرفة، ذي علم مطلق، لهذا فليس في كتابه خطأ أو تناقض، ويحدد أنه وضع منهجه الفكري لفهم القرآن بـ”الارتكاز على ما توصل إليه كل من علمَي اللسانيات والإبستمولوجيا (نظرية المعرفة) الحديثين”. ويشير “شحرور” إلى أن هذا المنهج مبني على مجموعة من المبادئ الرئيسية المتمثلة فيما يلي:
1- التأكيد على الفهم العقلي: يؤكد “شحرور” في كتاباته على ضرورة الاعتماد على التفسير العقلي للقرآن وكافة النصوص الدينية، على اعتبار أن نصوص القرآن كانت تحض على التفكر وإعمال العقل. وفي هذا الإطار، يُشير الكاتب إلى أنه “لا فهم لنص القرآن إلا على نحو عقلي”.
2- التطور في فهم القرآن: إذ يقول الكاتب إن “فهمنا لكلام الله متطور وغير ثابت، بينما كلام الله ثابت في كينونته باعتباره نصاً إلهياً مقدساً”، واتساقاً مع هذه الفرضية يرى الكاتب أنه “لا فهم للقرآن بنفس طرق فهم الشعر الجاهلي وأدواته بحسب زمن معاصريه”.
3- كينونة التنزيل الحكيم: حيث يرى شحرور أن “التنزيل الحكيم كينونة في حد ذاته، ويظهر هذا في ثبات النص، فلا أحد يملك الإدراك الكلي للنص القرآني حتى لو كان نبياً ورسولاً”.
4- أهمية صدق النبأ القرآني وواقعية التشريع: يفترض “شحرور” أن “جماليات القرآن اللغوية ليست هي التي تجعله صحيحاً صادقاً”، ويعني الكاتب أن صدق النبأ القرآني وواقعية التشريع في آيات الأحكام أهم من جمال التركيب والصياغة اللغوية.
5- الطابع الإنساني للقرآن: استناداً إلى قراءته لنصوص القرآن وفهمه له، يرى “شحرور” أن “التنزيل الحكيم هدى ورحمة للعالمين، لذا فهو لا يحمل طابعاً عروبياً، بل يحمل طابعاً إنسانياً”.
6- الطابع البلاغي للتنزيل الحكيم: يؤكد الكاتب أن القرآن خالٍ من العبث والأخبار غير المهمة والحشو. ويذكر أن التنزيل الحكيم “جاء على أعلى مستوى من البلاغة التي لا يمكن تجاوزها أو الإتيان بمثلها في أداء المعنى وتوصيله إلى السامع، لذا فهو الكتاب الوحيد الذي يمثل في جميع آياته الخيط الفاصل بين الإطالة المملة والإيجاز المُخلّ”، حسب قوله.
مداخل تفسيرية
استناداً إلى رؤيته التطورية للقرآن الكريم، وضرورة أن يكون “التشريع متماشياً مع عملية التطور المعرفي لأي مجتمع”؛ يطرح “شحرور” عدداً من القضايا والمداخل التفسيرية، من وجهة نظره، للقرآن الكريم، وقضية التشريع بشكل عام، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:
1- متطلبات مرحلة ما بعد الرسالات: يقول “شحرور” في مقدمة كتابه، إن “التاريخ الإنساني حسب القرآن ينقسم إلى مرحلتين: الأولى مرحلة الرسالات السماوية التي انتهت برسالة النبي محمد، وهي الرسالة التي نُسخت فيها الرسالات السابقة عليها. والثانية مرحلة ما بعد الرسالات، والتي نعيشها نحن”. ويضيف الكاتب “وقد ختمت الرسالة المحمدية التشريع الإلهي والنسخ الإلهي، وبدأت بالتشريع الإنساني والنسخ الإنساني، علماً بأن النبي مارس الحالتين معاً، فكان عليه البلاغ في الرسالة، وفي الحالة الإنسانية شرّع لمجتمعه في تفصيل المحكم وتنظيم الحلال، فيما لم يشرح النبي محمد أي شيء في رسالته إلا الشعائر، وهذا هو القانون المدني الإنساني القابل للنسخ والتغير باختلاف الزمان والمكان”. وهكذا يعتقد الكاتب أن التشريع يرتبط بتطور المجتمعات واحتياجاته.
وفي هذا السياق، يقول الكاتب إنه وجب أيضاً أن “نقرر نظرياً وعملياً أن الأحكام الدينية تتغير بتغير النظام المعرفي”، معطياً مثالاً لذلك بأنه “لا عجب أبداً إن انتهينا في قراءتنا المعاصرة لآيات الإرث في القرآن في ضوء علم الرياضيات الحديثة إلى نتائج وأحكام مختلفة عن مثيلاتها عند أهل القرن الثامن الميلادي”، فالمسألة عند الكاتب أولاً وأخيراً مسألة إشكاليات نعيشها ونظام معرفي نقف عليه، سمَحا لنا بأن نرى ما لم يستطع أن يراه السابقون، ويجب أن يرى مَن بعدنا بأرضيتهم المعرفية وإشكالياتهم المتطورة عنا.
2- قراءة النص القرآني عملية مستمرة: يؤكد الكاتب في أكثر من موضع أن قراءة النص القرآني عملية مستمرة يجب ألا تتوقف عند زمن معين أو أشخاص بعينهم، وينوه إلى أن قراءته تلك للنص القرآني “ليست الأخيرة، لأنها لو كانت الأخيرة لوقعنا فيما وقع فيه السلف… فمَن يدّعي فهْم كتاب الله ككل من أوله إلى آخره فهماً مطلقاً إنما يدعي شراكة الله في المعرفة، في ضوء قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لستَ مرسلاً، قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومَن عنده علم الكتاب”.
3- ضرورة تفكيك العلاقة بين الإيمان والعلم: فقد أكّد الكاتب أن آيات القرآن “نص إيماني لا عَلاقة لها بأي دليل علمي، بحيث يمكن إقامة الحُجة على المؤمنين بالنص فقط، أما على غيرهم فلا يمكن”، مضيفاً أن مفاتيح فهم النص القرآني “ليست من خارجه، بل من داخله، وما علينا إلا البحث عنها فيه”.
4- تحديد مساحة التحريم في التشريع: يؤكد الكاتب على ضرورة تحديد مساحة التحريم في التشريع الديني، وفي هذا الصدد يقول: “إن أساس حياتنا هو أن كل شيء مباح؛ إذ إن الوحيد صاحب حق التحريم هو الله، ولكنه أيضاً يأمر وينهى، والنبي كان يأمر وينهى، والناس عموماً كانوا وما زالوا يأمرون وينهَون، فيما هناك فرق شاسع بين التحريم والنهي، لافتاً إلى أن المحرمات قد أُغلقت في كتاب الله وحُصرت فيه بـ14 محرّماً لا أكثر ولا أقل، وبالتالي تصبح كل إفتاءات التحريم لا قيمة لها”، حسب قوله.
5- الربط بين القيم الإنسانية والإسلام: يقول “شحرور” إن “الإسلام هو بوابة دخول الدين، وتم تحديد ذلك بالإيمان بالله واليوم الآخر “تسليماً”، فيما السلوك العام للمسلم هو “العمل الصالح”، وبالتالي “فكل مؤمن بالله ويعمل صالحاً فهو مسلم، مهما كانت ملّته الدينية”، بحسب الكاتب الذي يضيف: “وبما أن القيم الإنسانية من العمل الصالح فهي من الإسلام وليست وقفاً على أتباع الرسالة المحمدية”.
6- تقديم رؤية مغايرة لمبدأ الإجماع: يرى “شحرور” أن مبدأ الإجماع هو “إجماع الناس الأحياء على تشريع ما (أمر – نهي – سماح – منع)، ولا علاقة له بالمحرمات الـ14 التي جاءت في التنزيل الحكيم. فالتدخين مثلاً ليس من المحرمات، وبالتالي لا يمكن تحريمه، بل يمكن فقط منعه بعد ثبوت أضراره عن طريق الاستفتاء والمجالس التشريعية”. ويؤكد الكاتب أنه بهذه الرؤية العقلانية للحلال والحرام وحدها يمكننا إخراج الخطاب الإسلامي من حيز المحلية إلى حيز العالمية لبيان مصداقية الرسالة المحمدية بأنها جاءت رحمة للعالمين.
7- إعادة النظر في العلاقة بين القرآن والسنة: يحاول “شحرور” تحديد دور النبي في الرسالة السماوية؛ إذ يقول استناداً إلى الآية الكريمة: “يا أيها الرسول بلّغ ما أُنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته” (المائدة 67)، لافتاً إلى أن البيان الذي جاء في قوله تعالى: “وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليُبين لهم، فيضلُّ الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم” (إبراهيم 4) “ليس المقصود منه التفصيل كما فهمه البعض واسترسل البعض الآخر فيه حتى وصل إلى القول بحاكمية الخبر النبوي على نص التنزيل الحكيم ونسخه له، انتهاءً بأخطر نتيجة قد يصل إليها عقل هؤلاء، تتمثل في أن القرآن أحوج إلى السُّنة من حاجة السُّنة إلى القرآن، سبحانه وتعالى عما يصفون”.
8- طرح تفسيرات مغايرة للمصطلحات المستقرة: يرى الكاتب أن ثمة حاجة لإعادة تفسير بعض المصطلحات المستقرة لدى البعض، ويقدم نماذج على ذلك مثل مصطلح “اللوح المحفوظ”، والذي ورد ذكره في القرآن في آية “بل هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ” (البروج 21 و22)، إذ يقول الكاتب فيه إن هذا اللوح بمثابة برنامج له قوانين صارمة تسيّر الوجود، وهو برنامج ثابت لا يتغير، لا هو ولا قوانينه، وبالتالي لا ينفع فيه الدعاء لأنه لا يتغير من أجل أحد مهما كان.
ومن المصطلحات أيضاً التي يتعرض لها الكاتب “مواقع النجوم”، والتي يقول إنها تعني “الفواصل الموجودة بين آيات القرآن”، وليست مواقع النجوم التي في السماء، بل هي مفاتيح لفهم الكتاب، خصوصاً القرآن في عملية تأويله، فمواقع النجوم في الكتاب تجعل كل آية من آيات الكتاب تحمل فكرة متكاملة: “فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقَسَم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم” (الواقعة 75-77).
كما يعرّف الكاتب الشرك في صورة من صوره بأنه “الإيمان بمبدأ الثبات”، كما أن الشرك بالله “هو أن يجعل الإنسان لله شريكاً في العبادة والدعاء…”، والشرك هو “السكون في الفكر والتوقف عن التطور كما جاء في قوله تعالى على مَن أنكر التغير وآمن بالثبات “ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً”، والثبات على مبدأ الآبائية شرك أيضاً في نظر شحرور، اتكاءً على آية “إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون” (الزخرف 23).
تأويل مغاير
خلاصة القول، يحاول الكاتب اتباع نهج واحد في مساره البحثي عبر هذا الكتاب الموجز، الذي يجمع فيه شتات أفكار مبعثرة في مجموعة من كتبه الصادرة على مدار عشرة أعوام سابقة على هذا الكتاب، وقد اتبع أسلوب عرض يتواءم مع الإيجاز والتكثيف، ملبياً حاجة القارئ في البحث عما وراء النص القرآني من تأويل مغاير ومختلف عن منهج السلف، إذ أكد على أهمية النظام المعرفي في تطور الدين، باعتباره منهج حياة، يؤديه الناس في زمان يخصهم، دون أي مساس بالقواعد الثابتة، أو ما سماه البرنامج الذي حدده الله لتسيير الكون.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.