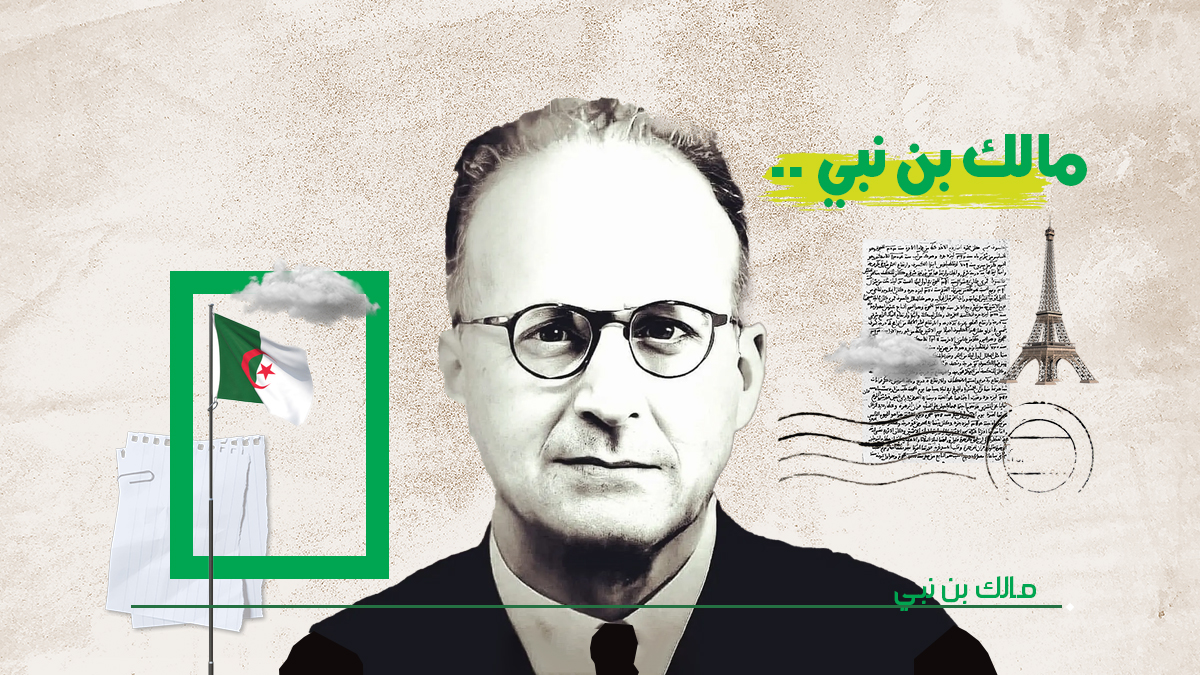
مشكلات الحضارة:
مالك بن نبي وإعادة تجديد الإنسان المُسلم
رغم الانتقادات الحافلة التي وجَّهها المفكر الجزائري مالك بن نبي (1905-1973م)، إلى المجتمع الإسلامي قديماً وحديثاً، عبر كتابه “مشكلات الحضارة.. وجهة العالم الإسلامي“، فإنه يتجاوزها بوضع أفكار وأطروحات منهجية لمعالجة حالة التأخر والآفات المجتمعية، منطلقاً من مزية جوهرية للعالم الإسلامي، وهي حفاظه على “القيمة الأخلاقية”.
دورية الحضارات التاريخية
1- المراحل الثلاث للحضارات: استوحى “مالك بن نبي” حديثه في ما سمَّاه “الظاهرة الدورية للحضارات”، من “ابن خلدون” (1332-1406م)؛ حيث تمر الحضارات بمراحل ثلاث، الفتوة “فتية”، والشباب “أوج قوتها”، والعَجز “تشيب”، وتنتهي، لتنشأ أخرى في بقعة أخرى؛ وكل “دورة حضارية” لها شروط نفسية وزمنية خاصة، ومُركبة من عناصر “الإنسان والتراب والوقت”، حسب قوله.
2- انفصال العقل عن الروح: الحضارة الإسلامية في بدايتها، حسب “بن نبي”، وازنت بين العقل والروح، وهو التوازن الضروري لكل بناء اجتماعي، ولا يمكن لحضارة البقاء دون جانب روحي، لكن بعد معركة صفّين، عام 38 هـ، بين “عليّ” و”معاوية”، انفصل العقل عن الروح في الحضارة الإسلامية، وحلت “الحِمْية الجاهلية” محل “الديمقراطية الخليفية”، حسب قوله.
3- إنسان ما بعد الموحِّدين: يُطلق “بن نبي” مصطلح “إنسان ما بعد الموحِّدين”، على الحالة الإنسانية والاجتماعية التي ظهرت بسقوط دولة الموحِّدين (1121-1269م)؛ إذ حدث تغير للمجتمع بأن صار المسلم سلبياً يؤمن بالخرافات، متواكلاً يتجاهل الأسباب؛ ورغم استمرار الإيمان، فإنه تجرَّد من فاعليته وفقد قوته الاجتماعية وتأثيره الذي ساد المسلمين حتى العصر الحديث، ويقول: “هذا الوجه المتخلّف الكئيب ما زال حياً في جيلنا الحاضر”، وفق تعبيره.
4- العلوم الأخلاقية والحضارة: يرى “بن نبي” ضرورة وجود العلوم الأخلاقية والاجتماعية والنفسية في الحضارة والمجتمعات أكثر من العلوم المادية؛ إذ إن غياب “العلوم الأخلاقية”، حسب قوله، “خطر في مجتمع ما زال الناس يجهلون فيه حقيقة أنفسهم”.
أوروبا والمجتمع الإسلامي
يذهب المؤلف إلى أن الإنسان الأوروبي -رغم سلبياته الاستعمارية– كان قد مارس دوراً نافعاً للعالم الإسلامي، وأنقذه مما سمَّاه “فوضى القوى الخفية التي يغرق فيها كل مجتمع يستبدل الخيال الساذج بالروح”.
أولاً، دور الإنسان الأوروبي: منح “النشاط الأوروبي”، حسب “بن نبي”، إنسان ما بعد الموحِّدين “إلهاماً جديداً لقيمته الاجتماعية، حين نسف وضعه الاجتماعي الذي كان يعيش فيه راضياً، وحين سلبه وسائله التي كان يتبطَّل بها هادئ البال”.
ثانياً، تقديس اللغة العربية: يتعرض الكاتب إلى “تقديس” اللغة العربية، حتى صارت لا تقبل التطور، نتيجة تقديس إنسان ما بعد الموحّدين إياها، حتى ليُعد من الكفر خلق صيغ جديدة بإضافة زوائد مناسبة، رغم أن ذلك ممكن جداً في روح اللغة، حسب قوله؛ فيما يهاجم “بن نبي” التعليم الحُر في العالم الإسلامي، الذي وقف على حاله منذ “القرن المسيحي الوسيط”، فغابت عن الفكر العربي الفاعلية عبر “استبداد الألفاظ والصّيغ به، ما خلق طابعاً سطحياً”.
ثالثاً، أثرية الثقافة العربية: وذلك لأنها اتجهت إلى تقديس الماضي، فانتكس العمل الفكري، مع تعلقُّ “واهم” بـ”الكم” دون النوع، والنزوع إلى الشعر، الذي يعمد إلى الناحية الجمالية والبديع، لـ”يخفي مواضع النقص والاختلال وتستر العجز بستار البلاغة المزعومة”، وهي أمور تقف أمام محاولات الإصلاح، حسب قوله.
رابعاً، أُسس بناء الحضارة: يرى “بن نبي” أن محاولة إعادة بناء الحضارة الإسلامية يجب أن تقوم على أسس، منها: إعادة تجديد التراث الإسلامي، عبر إعادة النظر في تفسير القرآن وتنقية التفاسير، من جهة؛ ومن جهة أُخرى، سيادة الفقه المبني على “الواقع السائد”، لا الفقه التقليدي بجموده وابتعاده عن الواقع.
إشكالية العالم الإسلامي
يقول “بن نبي” في مؤلَّفه، إن العالم الإسلامي الحديث واقع في فوضى لها أسباب داخلية وخارجية، منها:
1- خليط الموروث والوافد: حيث يؤكد الكتاب أن العناصر المستمرة في العالم الإسلامي من عصر ما بعد الموحّدين، تتسم بعدم القدرة على التعامل بوعي وتخطيط مع الثقافة الوافدة، فـ”العالم الإسلامي اليوم خليط من بقايا موروثة من عصر ما بعد الموحدين، وأجلاب ثقافية حديثة جاء بها تيار الإصلاح وتيار الحركة الحديثة، وهو خليط لم يصدر عن توجيه واعٍ أو تخطيط علمي”.
2- القلق من الاقتباس: يرى المؤلف أن الإنسان المسلم يواجه حالة قلق، لعدد من الأسباب، منها: الاقتباس من الحضارة الغربية دون وعي؛ إذ ليس كل ما هو قابل للاقتباس قابلاً للتداول؛ ومنها: العجز عن التفكير والعمل؛ هذا، فضلاً عن انعدام المنطق بين الفكر ونتيجته المادية، فـ”الفكرة والعمل الذي تقتضيه لا يتمثلان كلاً لا يتجزأ”.
3- تقليد أعمى للغرب: يوضح “بن نبي”، في مؤلَّفه، أن التقليد الأعمى للغرب تسبب في تخلي المجتمع الإسلامي عن “الجُهد الفكري”، الذي كان عنصراً رئيسياً في العصور الذهبية للعالم الإسلامي، رافضاً التحجُّج بالفقر والجهل، ولا حتى بالفوضى التي يخلقها الاستعمار، الذي يسحق كل جهد عقلي؛ إذ يُخضِع المستعمِر المستعمَر إلى قانونه أو ما سمّاه “المعامل الاستعماري”.
4- مساوئ العالم الغربي: يرى “بن نبي” أن الحضارة الغربية بها أوجه نقص تتسبب في فوضى يسهل إدراكها، وتأثيرها عالمي، وبسبب “الشعاع العالمي الشامل الذي تتمتع به ثقافة الغرب، صارت مشكلة عالمية يجب تحليلها وفهمها لإدراك نسبية الظواهر الأوروبية، فيسهل على العالم الإسلامي التعرُّف على أوجه النقص وأوجه العظمة بالحضارة الغربية”؛ لافتاً إلى أن العالم الإسلامي لن يجد طريقه إلا بعد اكتشاف “ينابيع إلهامه الخاصة”، فلا يمكن للعالم الإسلامي أن ينأى بنفسه عن الحضارة الغربية، “خصوصاً في عالم يتجه إلى التوحُّد”، حسب رأيه.
“أميبا” المجتمع الإسلامي
يصف “بن نبي” في كتابه المجتمع الإسلامي بـ”الأميبا”؛ بمعنى كائن بدائي أحادي الخلية، “متبطِّل يتسكع حتى إذا رأى فريسة هينة أبرز إليها ما يشبه اليد ليقتنصها”؛ وبالتالي، ينتج عن ذلك التبطُّل جمود فكري وإبداعي؛ إذ نرى أن هذه المجتمعات “لم تخترع حتى يد المكنسة”، حسب قوله؛ فيما يُعظِّم المؤلِّف قيمة العمل التي بَنَت المجتمع الإسلامي الأول، لافتاً إلى أهمية أن تبني هذه القيمة المجتمع الإسلامي الحديث، حيث يتفوق الواجب على الحق، حتى يوجد “فائض قيمة” يكون أداة فاعلة في التجديد والتطور، أما الاعتماد على فكرة الحق دون الواجب فإنها تحول المجتمع إلى كتلة كسل.
من هنا، لا يدعو “بن نبي”، في كتابه، إلى تجديد المجتمع الإسلامي فقط، بل إلى “إعادة تجديد الإنسان المسلم” عبر إحياء “القيمة القرآنية” التي تترك أثراً مباشراً في ضميره، والكف عن المطالبة بالحقوق دون الواجبات؛ كما يرى، أيضاً، أن الحضارة يجب أن تقوم لتُعادل بين المادي والروحي، وبين الكم والكيف، وبين الغاية والسبب، فإذا اختل هذا التعادل كانت “السقطة رهيبة قاصمة”، مستدركاً أن العالم الإسلامي احتفظ بمعنى جوهري هو “معنى القيمة الخلقية”، وهو يخطو في طريقه إلى تجديد نفسه بنفسه، بفضل هذا المعنى الجوهري والقيم الحديثة التي تحصل عليها، وبفضل الامتزاج بين الروح والمادة.
وختاماً، فإن كتاب “مشكلات الحضارة.. وجهة العالم الإسلامي” للمفكر الجزائري “مالك بن نبي”، يُجسِّد الحالة التي يقف فيها العالم الإسلامي في الفوضى التي حدثت بعد دولة الموحدين، وأبعدته عن اللحاق بالحضارة الغربية. ولا يقتصر الكتاب على البحث في التاريخ الإسلامي، بل يتجول بين الماضي والحاضر، ليكشف الأسباب التي أدت إلى التخلف، ومظاهرها الحديثة، مُحاولاً عبر منهج عقلي تحليلي، أن يتلمس طرقاً هامة لإحداث التطور في المجتمع الإسلامي ليجد له مكانة إلى جوار الحضارة الغربية.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.