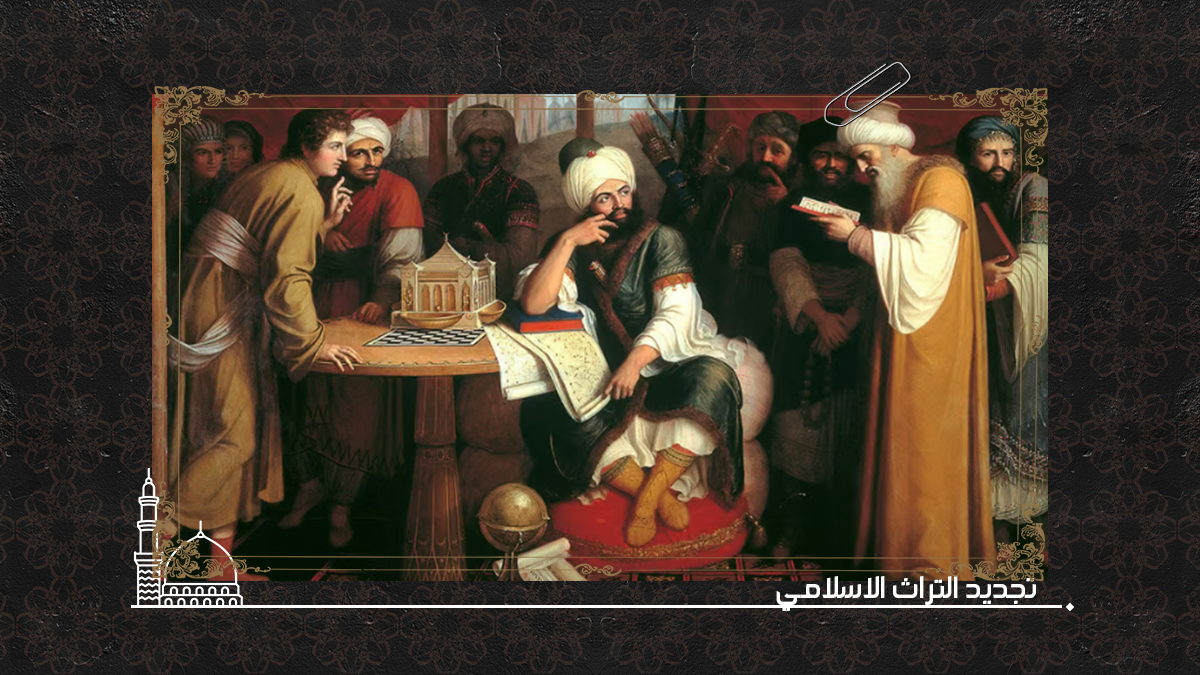
مرجعية جديدة:
إشكاليات وتحديات تجديد التراث الإسلامي
التجديد ضرورة حضارية، ولا تخلو محاولة تجديد للتراث من تحديات، لا سيما مع وجود فجوة كبيرة بين التراث الديني والتقدم الحضاري؛ ورغم المعوقات المتعلقة بالتجديد، فإن التجديد الديني لازم لوجود حاجة إليه ملحة ومستمرة. وعند اللجوء إلى التجديد تظهر الصعاب، لا سيما في العالم الإسلامي، بعضها خاص بالتراث نفسه، وبعضها الآخر رهين بالواقع المعاصر.
المفكر العراقي ماجد الغرباوي، في كتابه “إشكاليات التجديد”، يتجاوز الآليات إلى تناول الصعاب التي حالت دونه قديماً أو تعوق المحاولات الحديثة، داعياً إلى حوار داخلي في المجتمع الإسلامي نفسه، وآخر خارجي مع الحضارة الغربية.
توقف المد الحضاري
يستهل المفكر العراقي ماجد الغرباوي كتابه بطرح تساؤل حول: “لماذا تقدم الغرب وتأخر المسلمون؟ لماذا توقف المد الحضاري بعد أربعة قرون من العطاء؟”؛ عارضاً اتجاهات ثلاثة تختلف في التعاطي مع هذا التساؤل:
أولاً، الانبهار بالغرب وحضارته، ما أدى إلى الشعور بالدونية وكراهية الذات؛ الأمر الذي يجعل أصحاب هذا الاتجاه يقبلون كل ما يرد من الحضارة الغربية دون فحص، مقابل رفض التراث بشكل عام، وهو ما يرفضه الكاتب.
ثانياً، ما وصفه بالانكفاء المروع على الذات، وسط شريحة واسعة عكست صورة لا تفقه من الدين إلا ظاهره، وتتمسك بحرفية النصوص وقدسية التراث؛ وتسبب هذا الاتجاه وفقاً لـ”الغرباوي” إلى التطرف والإرهاب.
ثالثاً، الاتجاه الإصلاحي، الذي عمد إلى دراسة حقبتي الازدهار والانحطاط بحثاً عن الحقيقة؛ وانتهى إلى ضرورة التشبث بالجانب المعنوي حيث الأخلاق وضبط السلوكيات، مع الأخذ بأسباب التطور التكنولوجي العلمي؛ وهو الاتجاه الذي يفضله المؤلف ويدعو إليه.
ملامح الوعي الراهن
يُمكن تناول أهم النقاط في أطروحة ماجد الغرباوي، حول “إشكاليات التجديد”، كما يلي:
1- تحليل الوضع الحالي: يتناول “الغرباوي” في الفصل الأول، الذي حمل عنوان “الوعي الراهن”، تحليلاً كاملاً للوضع الحالي كما هو، داعياً إلى الارتقاء بالوعي الإنساني، ضد ما تعرض له من تزييف وتغييب بعد عهد الخلفاء الراشدين، في “الدول” التي قامت عقب فترتهم؛ ذلك التغييب الذي كان الهدف منه تحقيق أهداف ومصالح خاصة.
ويرى الكاتب أن الوعي لن يعود دون وجود مرجعيات، تجدد تعاملها وفهمها للنص الديني بشكل مستمر من منطلق القرآن والسنة النبوية “الصحيحة”؛ إذ إن الأمة “في حاجة أولاً إلى وعي رسالي، تتجاوز به أزمتها، حتى تستطيع تحدي الممنوع، ولا يتحقق لها ذلك، إلا بإعادة تشكيل وعيها داخل فضاء معرفي، يستظل بمرجعيات تجدد باستمرار فهمها للنص الديني، في ظل المستجدات الحياتية المتأثرة بالظروف الزمانية والمكانية”، داعياً إلى التمييز الواضح بين الإلهي والبشري والمقدس وغير المقدس.
2- المثقفون والارتقاء بالوعي: لا يقتصر الارتقاء بالوعي على المرجعيات الدينية “المجددة لفهمها الديني باستمرار”، بل إلى جوارهم تقع المسؤولية أيضاً على المثقفين والدائرة الثقافية ووسائلها كالإعلام؛ فيرى أن الثقافة هي المعيار المحدد لوعي الأمة، ويشترط للمجدد أن يكون مثقفاً وأن يتملك المعرفة الكاملة للتراث مع القدرة على التفكير والبحث، والوعي الكامل بالواقع بشكل مفصل والتعاطي معه، حتى لا يحدث انفصال عن واقع الأمة، والشجاعة لاتخاذ أفعال قادرة على خلق صحوة الأمة.
3- مسار العقيدة الإسلامية: استعرض الكاتب في أطروحته العقيدة الإسلامية منذ نشأتها، حينما كانت نموذجاً عقائدياً فكرياً فريداً، تمكن من التخلص من الوثنية وانسجم مع الفطرة الإنسانية، حتى صارت الحياة الاجتماعية تفعيلاً لهذا النموذج العقائدي؛ فيقول: “تمتاز العقيدة الإسلامية بقدرتها على تجديد عقل الإنسان وانتزاعه من عالمه الوثني، الطقوسي، القلق، إلى أفق رحب تتفاعل فيه العقيدة مع الحياة، ليُفرز ذلك التفاعل مجتمعاً يتمثل القيم الإسلامية ويعيشها ممارسة يومية”.
وينتقل الكاتب من المرحلة العقائدية السابقة إلى تطور بناء فكري عقائدي أوجد علم الكلام التقليدي، الذي تسبب في “موت الإيمان الحقيقي”؛ إذ رغم إسهامات علم الكلام وأطروحاته الفكرية في الدين والمذهبية، فإنه تسبب في تعطيل المنهج القرآني الواقعي المباشر، الذي يدعو إلى العمل الصالح دون الجدل العقائدي، فأوجد أفكاراً مدمرة كالقدرية والجبرية والإرجاء، وابتعد بالعقيدة عن الفاعلية الحياتية، وكانت سمات هذه الفترة تأصيل المذهبية وانتشار الفرق وتعميق الخلافات وهجر الحوار وإقصاء الآخر.
4- أهمية علم كلام جديد: يذهب الكاتب إلى ضرورة التأصيل لعلم كلام جديد، يتجاوز أخطاء العلم السابق وما نتج عنه؛ وذلك عبر اعتماد المنهج القرآني المتلازم مع العقل والفطرة، وانتهاج منهج حوار عقلاني، وإعادة زرع العقيدة الحية الفاعلة، وإعادة النظر في القضايا المثيرة للجدل التي تتسبب في الإقصاء والنبذ والتكفير.
كما يُطالب بترك “الجمود والاقتصار على فهم السلف”، مع تقديم إجابات للتحديات الجديدة في العصر الحالي، وتشجيع الاجتهاد في المسائل العقائدية والفكرية.
5- أُسس الحوار المطلوب: لم يتخلَّ المسلمون عن الحوار، لا سيما في عهدهم الأول، إلا أن تراجعاً حدث بسبب علم الكلام، الذي تسبب في انغلاق فكري نشر الجدل والتناحر والتكفير، بما يتناقض مع المنهج القرآني الداعي إلى الحوار وبناء الجسور مع الآخر.
ويدعو الكاتب إلى الحوار “الداخلي” بين المسلمين، والحوار “الخارجي” مع الآخر المختلف فكرياً وثقافياً وحضارياً (الغرب)، مع إيجاد آليات للتواصل وفهم منطلقات الحضارة الغربية.
6- تفعيل المجتمع المدني: تفعيل الحوار بين الفئات المختلفة للأمة، يُساهم في تفعيل “المجتمع المدني”، الذي يتميز بإعلائه الشخصية المستقلة، وتنتشر فيه الحرية بأنواعها، وعلى رأسها الحرية العقائدية والفكرية، وتحافظ فيه المؤسسات على حقوق أفرادها.
و”المجتمع المدني” الذي تتسع فيه الحياة للجميع، يتشابه مع المجتمع الذي أسسه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، مع الأخذ في الاعتبار فارق الزمن والتطور الحضاري والتكنولوجي.
7- القرآن والتفسير العقلي: يطرح الكاتب رؤية لتناول القرآن الكريم والتعاطي معه وتفسيره عبر العقل، لفتح حوار متجدد مع القرآن لحمايته من جمود الأفكار بسبب الإبقاء على الفهم السلفي له، لا سيما وأن كتب التفاسير القديمة تحولت إلى مقدسات يُحرم الخروج عنها والإتيان بأي فهم جديد يتناسب مع الواقع الحالي.
8- التعددية الدينية والولاء: يعالج الكاتب مفهومين عصريين، هما “التعددية الدينية” و”الولاء”؛ إذ يرى أن مفهوم “التعددية الدينية”، الذي ظهر تزامناً مع عصر النهضة الثائر على المنظومة الكنسية، أوجد مفهوم الحق للجميع ولكل الأديان، الأمر الذي لا يتناسب مع بنية الإسلام؛ لأن هذه الفكرة تفرغ الدين من محتواه وتختزل الدين في تجربة روحية باطنية بعيدة عن الحياة.
وفي ما يخص مفهوم “الولاء”، يذهب الكاتب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام تمكن من توحيد القبائل المتفرقة تحت لواء واحد، وهو الولاء لله سبحانه وتعالى؛ إلا أنه بعد ذلك اختلف الأمر بشكل مغاير للقرآن، ما أوجد “الولاء المضاد” المبني على التناحر والتباغض واختلاف الولاءات بين المذهبية والقومية والقبلية، مُعالجاً هذه الإشكالية بالعودة إلى الولاء لله.
تأسيس مرجعية جديدة
يبحث الكاتب في مفردات الإحياء على المستوى النظري، ويحدد قدرته في: “بناء منظومة متكاملة من رؤى ومقولات، تتجه في مسارها الإحيائي إلى الإطاحة بتشوهات طرأت على الفكر الإسلامي، وعطلت فاعليته على صعيد الممارسة، وأنهته بوصفه سلوكاً عاماً أو شبكة من القيم لها دورها في صياغة المجتمع وفق أُطر إسلامية…”، ليؤسس مرجعية جديدة للمسلم تساعده في حياته وتمكنه من العودة بأفق جديدة وأطروحات تعكس تفاعل العقيدة مع الواقع.
بينما المستوى التطبيقي للمفهوم هو ترجمته إلى ممارسات ملموسة لها آثارها وتفاعلاتها، داعياً إلى النظر لما سمَّاه بـ”مراجعة البصمات التي تركتها مشاريع إحياء وإصلاح الفكر الديني”.
وختاماً، اتخذ الكتاب منهجاً وسطياً عقلانياً من التراث، وتعامل معه وفق الفترة الزمنية والوضع الاجتماعي له، ليكشف أسباب التراجع قديماً، لا سيما في الفترات التي تلت العهد الإسلامي الأول، وتحدث عن المعوقات والأسباب التي تقف حائلاً دون فكرة التجديد الديني في العصر الحالي.
وقد وسّع الكاتب من نطاقات التجديد الديني، التي كانت حكراً على رجال الدين، ليضم المثقفين ويضع على كاهلهم المسؤولية؛ بل واشترط على رجال الدين أن يكونوا “مثقفين”، وطالب بتفعيل الحوار الداخلي بين فئات الأمة، والحوار الخارجي مع الحضارة الغربية، ووصفه بأنه طريقة فاعلة نحو التقدم.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.