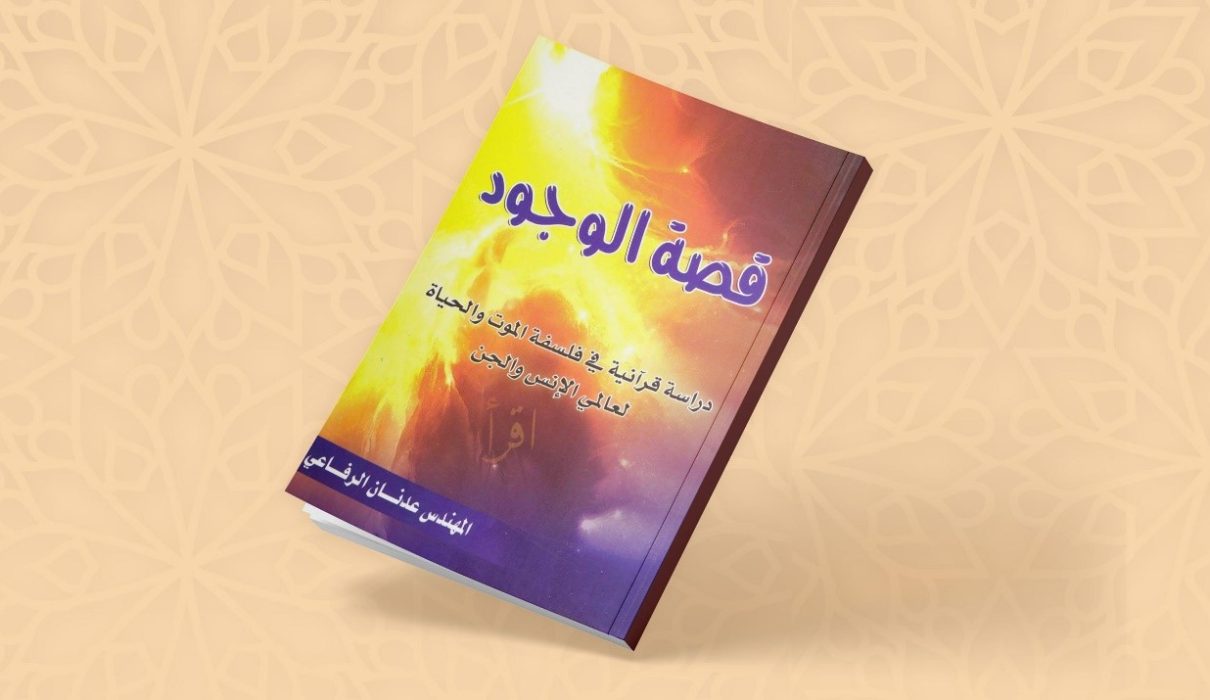
قصة الوجود:
كيف تفاعل الموروث الديني مع القضايا الغيبية؟
لا ندرك حقيقتها ولا نملك يقينها إلا بتدبُّر كتاب الله تعالى المقروء (القرآن الكريم)، وبالبحث في مادة كتابه المنشور (الكون)”.. هكذا وصف الكاتب المهندس عدنان الرفاعي قصة الوجود، في مقدمة كتابه الذي يحمل العنوان ذاته، الصادر عن دار “الخير” للطباعة، مستعرضاً فيه عالمَي الإنس والجن، كما يتطرق إلى حقيقة عالم البرزخ و”استحالة” رؤية الله، وكيف أن الجنة والنار “لم تُخلَقا بعد”، بحسب الكاتب.
ويقول الكاتب إن “تفاسير الموروث الديني تم الجزم فيها من قِبَل كثيرين بأن عذاب القبر جسدي حسي، وبأن المعراج بالجسد، وبأن الشفاعة تُسقِط عقوبة الكبائر، وبأن المسلمين الذين يدخلون النار سيخرجون منها”، لافتاً إلى أنه “سيحاول الغوص في هذه الأمور وغيرها؛ لبيان التناقض الذي صنعه الموروث الديني فيما تسمى السنة مع دلالات القرآن الكريم”.
مراتب الوجود
لقد اختار الكاتب المنهج القرآني لدراسة مسائل بحثية مهمة، واصفاً منهجه القرآني بأنه يملك برهاناً رياضيّاً على صدق نزوله من عند الله خالق الوجود؛ ما يثبت – بحسب قوله – أن القرآن كتاب الله تعالى المُطلَق، الذي يحوي كل أسرار الكون وقوانينه، وكتاب الله تعالى الوحيد الذي لم يُحرَّف فيه حرف واحد.
ويُفرِّق الكاتب بين حالتَي وجود: الحالة الأولى هي عالم الوجود المخلوق المحسوس الذي نستطيع إخضاعه لحواسنا، وهو عالم خاضع للزمان والمكان، وجميع الجزئيات المادية تنتمي إلى هذا العالم. والحالة الثانية هي عالم الوجود المخلوق غير المحسوس، الذي يخضع للزمان والمكان فقط، حينما يؤطَّر بجزئيات المادة في عالم الحس، كأنفسنا التي في أجسادنا مثلاً.
ولما كان عالم الخلق – بحسب الكاتب – هو عالم الأشياء (عالم الجزئيات)، وساحة تفاعل بين الموجودات المحسوسة والجزئيات المادية وقوانين الزمان والمكان، ومؤطراً بإطار المادة والزمان والمكان، فإن موجوداته تُسمَّى باسم الشيء. ولما كان وجود الله فوق وجود الأشياء، فإن الله لا يُسمَّى باسم الشيء؛ إذ الله مُنزَّه عن الشيئية، وعن خواص عالم الأشياء: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [سورة الشورى، الآية 11]، ويقول الكاتب إن كاف التشبيه هنا تَزيد في بيان ابتعاد الذات الإلهية عن الشيئية.
مسائل رئيسية
يطرح الكاتب تفسيراً لعدد من المفاهيم والمسائل الرئيسية في الموروث الديني، وأبرز هذه المسائل يتمثل فيما يلي:
1- مفهوم الشيطان: يقول الكاتب إن مفهوم الشيطان يبرز بين عالمَي الجن والإنس، بصفتهما عالمَين مستقلَّين في الخلق والصفات وطبيعة التكليف؛ فالملائكة باعتبارها كائنات نورانية، لها وجودها وعالمها المستقل، وهي كائنات لا تعصي الله. أما الملائكة من حيث هي صفة تعني الانصياع الكامل لله، وُتقابِلها صفة الشيطان التي تعني التمرُّد على أمر الله تعالى وعصيانه.
وبناءً على الآية الكريم ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [سورة الكهف، الآية 50]، التي تصف سلوك المُسمَّى إبليس. يقول الكاتب إن إبليس قبل هذه المعصية ليس فاسقاً عن أمر ربه، ومن ثم كان منصاعاً لأمر الله وليس متمرداً، ومن ثم أيضاً كان يتصف بصفات الملائكة، وبعد معصيته هذه اتصف بصفات الشيطان التي تناقض صفة الملائكة.
ويُفرِّق الله في تنزيله الحكيم – بحسب الكاتب – بين الملائكة المنصاعة التي بلا إرادة، وبين الشيطان الذي يملك إرادة: ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [سورة النساء، الآية 60]، كما يبين مسألة تمايز الماهية بين عالم الخلق والعوالم الأخرى، حين صوَّر لنا إرسال جبريل عليه السلام (الروح الأمين) إلى السيدة مريم: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [سورة مريم، الآية 17]؛ فالتمثل هنا – بحسب الكاتب – كان بشريّاً تاماً، وليس كتشكُّل الملائكة بالصورة البشرية حين أتت إبراهيم عليه السلام، وأوجس منهم خيفة، فكلمة ﴿فَتَمَثَّلَ﴾ تعني الاقتراب من الصورة البشرية، ولا تعني أبداً التحوُّل إلى الماهية البشرية.
2- قصة المسيح: ينفي الكاتب رواية إلقاء الشبه على أحد غير عيسى ليُقتل ويُصلَب بدلاً منه، وهي الرواية الرائجة باعتباره موروثاً دينيّاً، لكن الكاتب يقول إن دلالات النص القرآني تقول غير ذلك، ويُسمِّي رواية إلقاء شبه عيسى على بديل بالرواية “المُلفَّقة تاريخيّاً لاعتبارات فساد الرواية وتناقضها؛ ما يفتح باب السفسطة، ويعطي حيثيات السفسطة بما يراه الإنسان بعينيه”، على حد وصفه.
ويعود الكاتب إلى شرح آية ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [سورة النساء، الآية 157]، بحسب منهجه القرآني ودلالات النص، بقوله إن الضمير في الفعل المبني للمجهول “شُبِّه” يعود إلى “الصلب والقتل”، وليس إلى عيسى، بمعنى شُبِّه الصلبُ والقتلُ لهم؛ فالعبارة القرآنية يراها الكاتب تنفي الصلب والقتل عن عيسى، وتؤكد تشبيه الصلب والقتل لهم. ولما كان الشبه ليس من فعل بني إسرائيل وهو توهُّم اعتقدوه، جاء الفعل “شُبِّه” بصيغة المبني للمجهول. ويستنتج الكاتب من وراء ذلك أن الإعراض عن الصياغة الحرفية للنص القرآني مع فرض روايات وأقوال السابقين على النص القرآني، لا يزيدنا إلا ابتعاداً عن حقيقة “دلالات” كتاب الله، التي يوليها الكاتب كثيراً من الاهتمام حسب منهجه البحثي.
3- جنة الاختبار: يستنتج الكاتب، عبر منهجيته وتتبع دلالات اللفظ في القرآن، أن الإنسان أُعطي صلاحية التصرُّف بالأسباب والقدرة على دفعها باتجاه مراده، ضمن عطاء خاص يميزه عن غيره من المخلوقات، كالملائكة، وهو عطاء الربوبية، الذي جُعل الإنسان فيه خليفة لله في الأرض، ومن ثم فإن الجنة التي اختُبر فيها آدم عليه السلام وزوجه ليست جنة الثواب التي يدخلها الصالحون في الآخرة.
ويبني “الرفاعي” هذه الفرضية على عدد من العوامل؛ منها أن “آدم” عليه السلام، لَحِقه الغرور في جنة الاختبار بقول إبليس، فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ومن ثم لا خلد في هذه الجنة، بينما يكون ذلك في جنة الآخرة؛ وذلك بحسب الكاتب.
ومن جهة ثانية، فإن جنة الخلد في الآخرة مَن يدخلها لا يخرج منها، كما يؤكد القرآن ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ [سورة الحجر، الآية 48]. ومن جهة ثالثة وأخيرة، فإن جنة الثواب في الآخرة لا تُدخل إلا جزاءَ عمل قام به الداخل إليها بحسب القرآن: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [سورة النحل، الآية 32].
4- الجنة والنار: يقول الكاتب إن الموتة الأولى للنفس والانتقال إلى البرزخ هي المرحلة الأولى من “الآخرة”؛ فالنفس المؤمنة بمجرد مفارقتها الدنيا تدخل مرحلة “عين اليقين” فتعرف مصيرها، وهو الجنة، فيما تعرف النفس الكافرة مصيرها من النار. ويضيف أن أهل الجنة والنار يطَّلعون على الجنة منذ موتتهم الأولى، ومن ثم يدخلونها في الآخرة في مرحلة “حق اليقين”، ومن ثم يكونون على علم بها بحسب القرآن: ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ [سورة محمد، الآية 6]. أما استبشار المؤمنين بالنعيم فهو من قبيل السعادة الروحية. أما الدخول الحسي في الجنة والنار فهو دخول جماعي حسي، ولا يكون إلا بعد النفخة الثانية، وبعد إنشاء الجنة والنار إنشاءً حسيّاً، وبعد أن يقضي الله تعالى بين العباد بالحق.
ويرى الكاتب أن الجنة والنار كوجود حسِّي مادي كامل، ليستا موجودتين أصلاً قبل الانقلاب الكوني الذي تُبدَّلُ فيه الأرض غير الأرض وكذلك السماوات؛ فهذه الأرض – بحسب الكاتب – بعد الانقلاب الكوني (حيث ناموس الآخرة وقوانينها)، بعد ذلك، تُقام الجنة عليها وبعرضها وعرض السماوات.
5- رؤية الله: يرى الكاتب أن رؤية الله مستحيلة إلا من قبيل صفة الربوبية؛ فموسى النبي حين طلب رؤية الله ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ﴾ [سورة الأعراف، الآية 143] جاء التجلي من الله عبر صفة الربوبية ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ [سورة الأعراف، الآية 143]، مؤكداً أن صفة الربوبية، بما تعنيه من قوامة على كل الأسباب والجزئيات في هذا العالم، التي منها الطاقة المودعة في جسم هذا الجبل، حينما تتجلى على كائن حسي كالجبل، لا بد أن يزول من مكانه، علاوةً على أن موسى حين أفاق من الصعقة بعد طلبه رؤية الله، قال: ﴿سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الأعراف، الآية 143]، فطلبُ موسى “يعني خضوع الله لمعايير الزمان والمكان، والله منزه عن ذلك؛ لذا جاءت توبة موسى لازمة؛ لأنه طلب من الله ما لا يجب أن يكون؛ لأنه لو كان لألحق بالله وذاته المنزهة النقائص، والعياذ بالله”، حسب رأي الكاتب.
6- عالم البرزخ: يُعرِّج الكاتب إلى عالم ما بعد الموت، ويحاول الإجابة عن سؤال الفترة الانتقالية التي تحدث للبشري بعد الموت، فيقول إن الموت الأول لا يعني الدخول في العدم، وإنما يعني انتقال النفس المُجرَّدة من عالم المادة والمكان والزمان إلى عالم البرزخ، ويضيف أن عالم البرزخ عالم غير مادي، ومن ثم لا تشعر النفس فيه بالزمان والمكان مثلما يؤكد القرآن: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۞ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۞ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾ [سورة طه، الآيات 102–104].
ويلفت إلى أن “هذا البرزخ الذي يحجز النفس بعد موتها عن عالم الدنيا، هو من مقتضيات انتهاء زمن امتحان هذه النفس في حمل الأمانة”. ويؤكد الكاتب مسألة عدم سماع الموتى أي شيء مما في عالم الدنيا، اعتماداً على أن “النفس في عالم البرزخ تفقد كل آلية جسدية للإحساس؛ لأنها خارج الجسد، وهي (النفس) بحد ذاتها مجردة من المادة والزمان والمكان، كما أن النفس لا تعود إلى جسد في عالم البرزخ؛ فلا حياة في البرزخ أصلاً. ومن ثم ليس هناك آلية مادية لإحساس النفس في القبر، سواء بالعذاب أو اللذة، فلو كان ذلك صحيحاً لصارت هناك ثلاث حيوات، وليس حياتين، بما يناقض صريح القرآن الكريم”، على حد وصف الكاتب.
خلاصة القول أن الكاتب حاول تبني رؤية مغايرة لعدد من القضايا الغيبية الدينية؛ وذلك اعتماداً على قراءة ذاتية للنصوص القرآنية، وإن كان يلاحظ أيضاً أنه حاول تجنُّب استدعاء النصوص الموجودة في السنة النبوية؛ وذلك في إطار ما سمَّاها محاولة تجاوز “التناقض الذي صنعه الموروث الديني فيما يسمى السنة مع دلالات القرآن الكريم”.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.