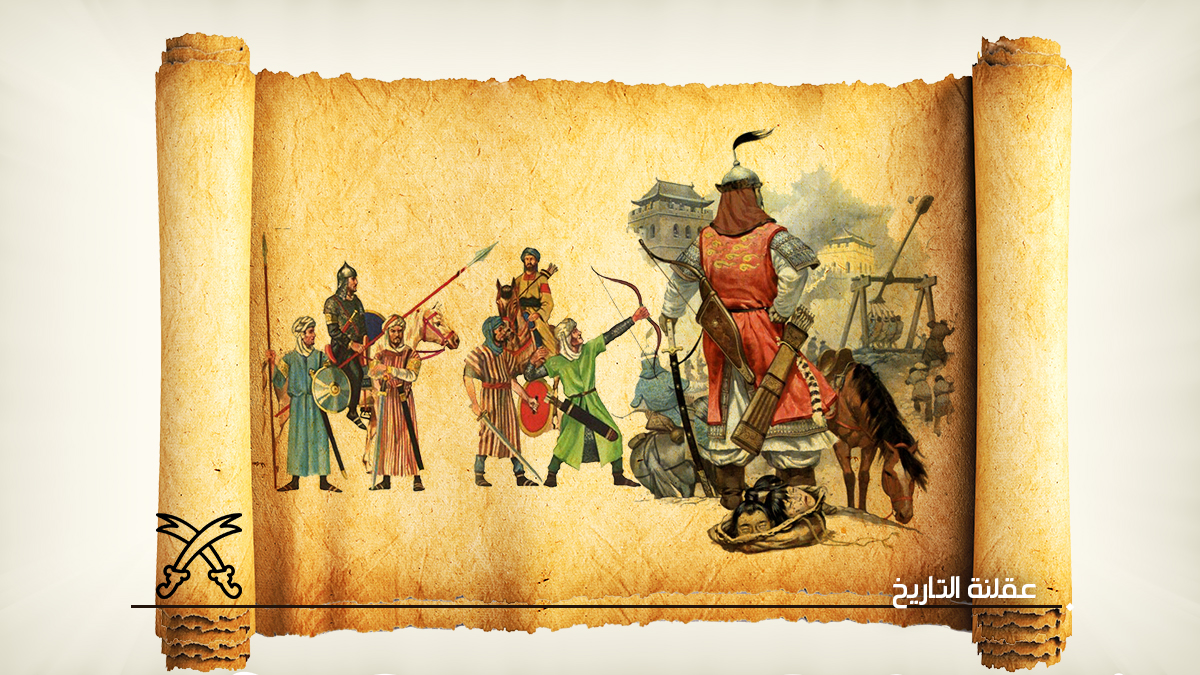
عقلنة التاريخ::
نقد مقولة السيف وتجفيف "منابع العنف" (1)
تظل المساحات الهائلة التي يشغلها التاريخ الإسلامي محل جدل وتساؤلات عديدة، بينما تجعل الباحث يشتبك مع أحداثه المتباينة وميراثه الضخم محاولاً فض النزاعات، ومعرفة الثابت والمتغير، وتحديد ما هو أصيل وما هو مصنوع ومتخيل، أو بالأحرى مسيس. فمن بين تلك الأمور قضية الحروب والغزوات، والتي يتسبب الحديث عنها، بخلاف كتابات السابقين التي شهدت جسارة وانفتاحاً وعدم تخوف من إثارة حساسية الضمير الديني، في مخاوف عديدة وهواجس مريرة.
العقل النقدي
ففي شجاعة قل نظيرها نتيجة الخوف والتربص من العقل النقدي المنفتح القادر على المواجهة، يصف الأديب والمفكر المصري محمد حسين هيكل الإمبراطورية الإسلامية التي تكونت، بأنها “غزوات”؛ من دون خشية الاتهامات التي ستلاحقه بالإساءة إلى الدين الحنيف. لكن الأهم أنه في كتاب بعنوان: “الإمبراطورية الإسلامية والأماكن المقدسة”، يوجز أسباب التدهور في أن “الحرية انقلبت جموداً، الإخاء والمساواة يذبلان أمام سلطان الباطشين من الحكام المستبدين”.
الأزمة أن هناك محاولات محمومة، في ظل تسيد خطابات الأصوليين والسلفيين بالمجال العام، إلى التأكيد على الطابع الحربي للإسلام، ووسم الدين بـ”الجهاد” في إطاره العنيف العسكري، كغرض من أغراض نشر الدعوة.
يقول القسطلاني في “إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري”: إن “الجهاد في الاصطلاح يعني قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله”. ويقول ابن كثير في “البداية والنهاية”: إن “الجهاد فريضة يجب القيام بها، سواء أحصل من الكفار اعتداء أم لم يحصل”. والكلام ذاته للشافعي في كتاب الأم.
لكن المفكر المصري عبد الجواد ياسين، يوضح في كتابه: “الدين والتدين”، أن مسألة الغزوات قد تم التعاطي معها ومع أحكامها الدينية بشكل مُطلق ومُفارق، نظراً لعدم وضعها في سياقها التاريخي، وفصلها عن ملابساتها الزمنية؛ إذ لم تكن تلك الحوادث منفصلة عن الإطار الحاكم لمجرياتها وتفاصيلها. ومن ثم، لا يمكن تعميم الحروب كغرض ديني محض يقفز على معطيات التاريخ وتحولاته، حيث إن النبي عملياً كان يميل إلى السلام وعقد المواثيق؛ كما حدث مع أهل نجران وأهل هجر والبحرين ودومة الجندل. بالتالي، لم تكن سيرة النبي معنية بالحروب كأولوية لنشر الدين والدعوة.
ويردف: “ستصبح آية السيف ﴿فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ﴾ [التوبة: 5]، مركزية في فرض القتال كأمر نهائي على المسلمين ضد أهل الأرض جميعاً. ويرى الفقه أن هذه الآية ناسخة لكل ما يدعو إلى السلام والتسامح من القرآن، مثل ﴿وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]؛ و﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ﴾ [البقرة: 256] و﴿أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ﴾ [يونس: 99]…”.
ومن هنا، ظهرت أحاديث على لسان النبي محمد، منها: “أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم”. هذا الحديث، وغيره، مما ظهر بعد نحو مئة عام من وفاة النبي، لا يمكن إغفال أو إسقاط السياق السياسي والتاريخي الذي ظهرت فيه مثل هذه “الأحاديث”، حيث ذروة حركة التوسع الخارجي؛ الأمر الذي كان يصطدم حتماً بآيات تُقر الحرية ورفض الإكراهات.
الدين والسياسة
لدى المفكر التونسي هشام جعيط، في كتابه “الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر”، رؤية ومقاربة مغايرتين عن السائد، حيث اعتبر “القضية الأولى للفتح العربي هي بالذات وجود آلة حربية أنشأها النبي، ثم طورها أبو بكر وعمر، وكانت ذات اتجاه نحو التوسع اللانهائي؛ وفي المقابل، لم تتمكن هذه الآلة الحربية من أن توجد وأن تمتد، إلا بالاستناد إلى شهية الغنائم لدى دوائر من العرب واسعة أكثر فأكثر، وهذا يعني أن الحوافز الدينية والسياسية والاقتصادية متشابكة تشابكاً قوياً، وأنها تتضافر كلها لإقامة الدولة الإمبراطورية”.
ويقول المفكر السوري محمد شحرور: “الباحث لا يكاد يجد كتاباً في الفقه الإسلامي، منذ نشأته في القرن الثاني الهجري وحتى اليوم، إلا وفيه ذكر للجهاد..”؛ موضحاً أن هناك عملية خلط بين “الجهاد والقتال والقتل والحرب والغزو. مرة بسبب الجهل، ومرات أخرى بسبب التقليد الأعمى، وأحياناً إرضاءً لسلاطين الاستبداد وخدمة للسياسة الإقصائية والتي غدت من سمات الفقه السياسي الإسلامي منذ السقيفة، واستحدثت جملة من علوم فرعية، كالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والقراءات، زعموا أنها أهم من الأبجدية عند قارئ التنزيل الحكيم، وانطلقت من القول بالترادف فوقع أصحابها في التباس كبير ضاع معه الفرق بين الشاهد والشهيد والشاهدين والشهداء، والأب والوالد، والعباد والعبيد، والإسراف والتبذير”.
ويردف: “تم تبني هذا الفهم المغلوط والمشوه للجهاد من قبل جميع التنظيمات والأحزاب الدينية والمجموعات المسلحة، التي تسعى تحت عناوين متعددة وبراقة إلى الاستيلاء على الحكم حصراً، في مختلف الأزمنة والعصور الماضية، بدءاً من أصحاب الفتنة الكبرى التي انتهت باغتيال الخليفة الثالث في القرن الأول الهجري، وانتهاءً بالحركات المسلحة في مصر وإيران وأفغانستان..”. أيضاً: “استغل أصحاب الهجمات الشرسة على الإسلام والمسلمين هذا الفهم المغلوط والمشوه للجهاد والقتال، الذي ساد في كتب الفقه التراثية واستندت إليه جميع عمليات الغزو التوسعية تحت ستار نشر الدعوة، في التشهير بالدين الإسلامي واتهامه بأنه دين السيف والعنف والإرهاب ودين القهر والتسلط والانتقام، وقد ساعدها على هذا الاستغلال طروحات الإسلام السياسي وسلوكيات ما يسمى بالحركات الجهادية، حيث قدموا لها أطروحات العداء على طبق من ذهب”.
وفي كتابه: “تجفيف منابع الإرهاب”، يقول شحرور إن: “الجهاد مصدر الفعل الرباعي (جاهد)، على وزن (فاعَلَ) كالجدال والقتال والخصام. والجهاد فعل إنساني واعٍ لا يقوم إلا بطرفين، ويكون الطرف فيه فرداً أو يكون جماعة، حيث يبذل كل طرف وسعه في مغالبة صاحبه. ولقد وهم بعض أصحاب المعاجم –وتابعهم في ذلك العديد من أنصاف المثقفين– فظنوا أن ألِفَ المشاركة في الجهاد زائدة وأن الأصل في الجهاد ثلاثي هو الجهد، وراحوا في معاجمهم يعرّفون الجهد تحت عنوان الجهاد، وهذا خلط فاحش؛ لأن الألف أصلية في الفعل الرباعي، وإسقاطها يحول الجهاد إلى جهد والجدال إلى جدل والقتال إلى قتل”.
وينقل شحرور هذا الحديث النبوي الذي ورد في كتاب: “كنز العمال” للمتقي الهندي، وجاء فيه قول الرسول لأصحابه: “قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه”. ويوضح شحرور بشأن التحولات المثيرة في معنى الجهاد وحصره في ناحية القتال: “لكن الأعجب من هذا وذاك أن الفقهاء وأصحاب التراث لم يكتفوا بتحويل الجهاد إلى قتال، بل حولوا الجهاد إلى غزو والقتال إلى قتل”.
كما أن الباحث والأكاديمي التونسي المنجي الأسود، يتطرق بعمق إلى آيات السيف من منظور معرفي في دراسة بعنوان: “آية السيف في الإبستيميَّة القرآنيَّة القديمة”، ويرى أن “الذات الإلهية هي التي تحدد وظيفة النبوة في التبليغ والإنذار. بالتالي، إذا كان النبي محمد هو المصطفى من الله ومؤهلاً للامتثال لأوامر الله، فإن المفكر بالسيف قد أبطل تبليغ الرسالة بالتبشير والإنذار، حيث لم يتبقَ لتبليغها إلا بقوة السيف”.
ووفق الأسود، فإن بعض الدارسين لعلوم القرآن اعتبروا القول بالنسخ في هذه الآيات “إساءة أدب على الله”؛ لأن “العمل بالسيف يقطع مع العفو والصبر والتسامح والتبليغ وعدم الدعوة بالإكراه للدين، بل إنه يقطع مع فكرة الحاكمية لله، نتيجة أن السيف بهذا المعنى تحول إلى قوة مطلقة، واتخذ من هذا السيف مفهوم الجهاد الذي تحول لمطية لفرض ثقافة العنف المقدس”. فيما انتهى المنجي الأسود إلى أن “آيات السيف السبعة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز خمسة بالمئة من الآيات الداعية لقيم التسامح والحرية المنسوخة بها نسخاً زائفاً”.
الاستيعاب المُتبادل
ويوضح المؤرخ روبرت جي هويلاند، المختص في تاريخ العصور الوسطى بالشرق الأوسط، أن “الفاتحين العرب اعتمدوا في بناء إمبراطوريتهم وسائل محض سياسية تناسب هذا الطموح التوسعي، والذي يماثل غيره في التاريخ. فالسرعة التي حدث فيها صعود الإمبراطورية لم تكن نتيجة لقيادة العرب لهذه الفتوحات واعتمادهم القوة الذاتية، إنما الاستفادة من الفترة التاريخية والزمن الذي لم يكن إلى جانب الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية”؛ هذا من جانب. ومن جانب آخر استخدام ما وصفه “الاستيعاب المتبادل”، الذي “سمح للعرب والشعوب التي تعرضت للغزو بالعيش معاً، مثلما كانت التجربة البريطانية في الهند، حيث كان 80 بالمئة من الجيش البريطاني من أصول هندية”.
ويقول في كتابه: “في سبيل الله.. الفتوحات العربية وتكوين الإمبراطورية الإسلامية”، إن “العرب كانوا يخدمون في الجيوش البيزنطية والفارسية في فترة ما قبل الإسلام بوقت طويل، وأحرزوا تدريباً قيماً في ما يخص استخدام السلاح والخطط العسكرية. بالتالي، يجب رؤية ذلك بعين الاعتبار، كما يجب رؤية الكثير من تحالف النبي محمد مع القبائل العربية في غرب الجزيرة العربية، البدو منهم والمستقرين، ليس بوصفهم مجرد يبحثون عن الغنائم وسلب الإمبراطوريات ونهبها فقط، إنما عناصر داخلية تبحث عن المشاركة في ثروات أسيادهم الإمبراطوريين. وكما هو الحال عند دخول القبائل الجرمانية إلى الإمبراطورية الرومانية، في القرون الميلادية الأولى. هذه السرعة في تكون الإمبراطورية، الأقرب إلى معجزة على حد تعبير ووصف مؤرخين وفقهاء، يكشف عن محاولات تعظيم الدور المركزي لله والنبي والمسلمين والنصر الإلهي؛ وفي المقابل، تهميش باقي العناصر بما فيها غير العربية والمسلمة”.
وختاماً، إذا وصلنا إلى هذا الفهم العقلاني والعلمي، بصرف النظر عن الانحيازات المسبقة، نكون قد وضعنا لبنة في مسار شاق وممتد نحو مراجعة التراث، من دون السقوط في فخ التمجيد أو التحقير، أو اللجوء الاضطراري إلى فلسفة التوفيق والتلفيق والتبرير ولي عنق الحقيقة، والوقوع في مغالطات ساذجة وغير منطقية، والتحرر من أعباء التاريخ؛ حتى نجد فرصة لتحسين شروط الواقع ومستقبل ليس فيه خوف وقلق.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.