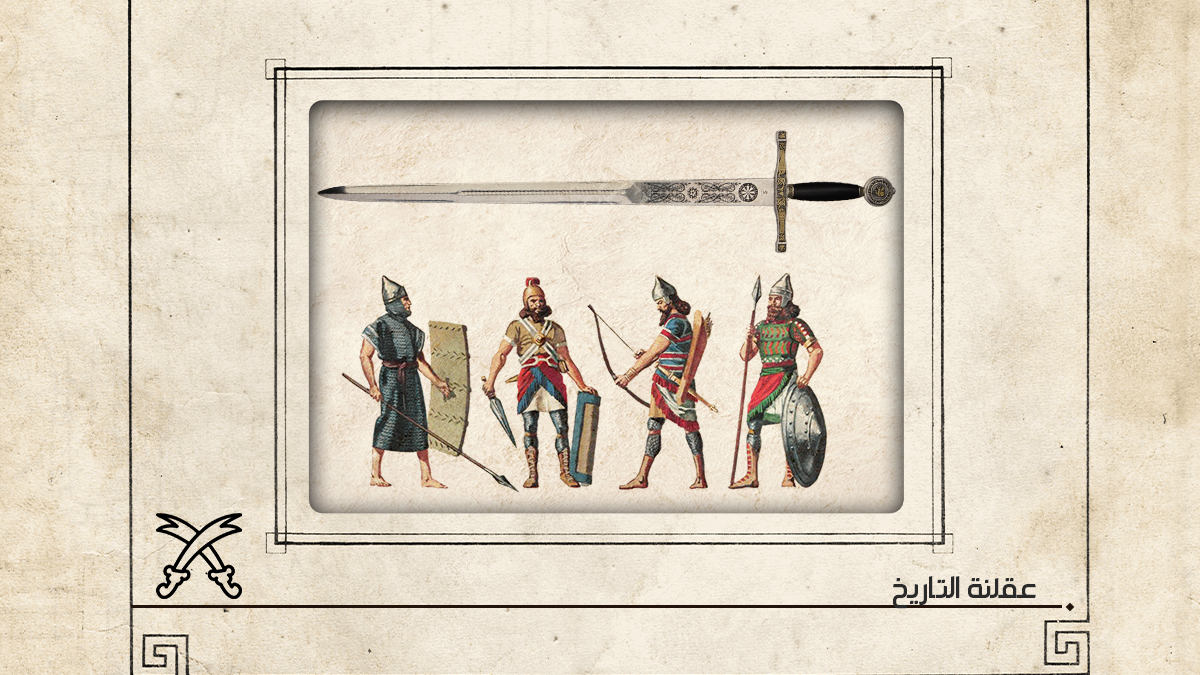
عقلنة التاريخ:
نقد مقولة السيف وتبيان "دوافع الغنائم" (2)
تظلّ قضية الفتوحات الإسلامية، أو الغزوات، مثار اشتباكات عديدة بين الباحثين، بينّما تبدو دائماً نقطة استقطاب عنيفة وخشنة تؤدي إلى نتائج سلبية، من الأطراف كافة المنخرطة في هذا الجدال. تُعزى تلك النتائج الصفرية، أو السلبية، في الاصطفاف الأيديولوجي، أو بالأحرى التمترس في مربعات ضيقة، تجعل رؤية المسألة مبتسرة، وتصل لنتائج متعسفة. وتكون المقولات النهائية من هذا الطرف أو ذاك متخمة بحمولات العنف الرمزي، لغياب المقاربات الإبستمولوجية والحقائق المعرفية؛ وذلك لحساب باراديغمات شمولية تخدم حدوداً ورؤى سياسية، لتأطير جماعات وظيفية (قوى الإسلام السياسي بتنويعاتها، واختلاف مرجعياتها)، في الحكم، راهناً أو مستقبلاً.
الشرط التاريخي
في إطار الاستفادة البراغماتية من التاريخ، من جانب القوى الأصولية والسلفية وجماعات الإسلام السياسي، يتم نفي الشروط التاريخية للحوادث المرتبطة به، وتعميم الجهاز المفاهيمي (الباراديغم)، لهذه الفترة وحيزها الزمني؛ فضلاً عن آثاره الاجتماعية والاقتصادية والقيمية الأخلاقية والسياسية، أو عصرنته.
بعبارة أخرى، تتحول قضية الحروب والغزوات إلى ضرورة دينية مفارقة لتاريخها القديم، بل يمكن القبول بها واستعادة الصراع على أساس “ديني/طائفي”، فيتشظى العالم إلى “دار حرب” و”دار إسلام”. ومن ثم، يتورط الفريق المؤيد لهذه الحروب في قضايا مثل “السبي”، والتي كانت ضمن الأمور المشروعة في الصراعات الحربية التاريخية، لكنّها أمست “جريمة حرب” في الوقت الحالي.
غير أنّ استعادة وفهم “الشرط التاريخي”، يعفي من الحرج وخدش الضمير الديني. فالدعوة المحمدية لم تكن في لحظات ملء التاريخ تحفر سوى مسارات آمنة، يتعايش فيها الأفراد على أساس عقد اجتماعي يقلل من حدة التنابذ، ويمتّن الصلات بصرف النظر عن التباينات الجهوية أو القومية والدينية. إذ إنّ تلك الحروب هي فصل سياسي حربي داخل التاريخ، وليس في صميم الدين كدعوة قائمة على رفض الطاعة القسرية.
الإسلام والحرية
يقول الأديب المصري محمد حسين هيكل في كتابه: “الإمبراطورية الإسلامية والأماكن المقدسة”، إن “الإسلام دين سلام ودعوة للسلام، والقرآن صريح في إنكار حرب الاعتداء صراحته في الدعوة إلى الجهاد لدفع الاعتداء”. موضحاً أن “الإمبراطورية الإسلامية ظلت مستمرة وقائمة لقرون، حيث استمدت شرعيتها من قبول التنوع والاختلاف، والالتزام بجملة من المبادئ الغنية والسامية، المتمثلة في الحرية العقلية”.
ويردف: “لحرية الرأي من القدسية ما يشهد به اجتهاد المشترعين والفقهاء في القرون الأولى، وما يدل عليه ما نقل من كتب الفلسفة اليونانية، وما أخذ به المفكرون والفلاسفة الإسلاميون من مبادئ هذه الفلسفة اليونانية، وما أضافوه إليها من عندهم”.
ثم ما لبث الانحسار وعوامل الإخفاق تتجمع وتتشكل معها “أسباب التدهور”، كما يقول هيكل، حيث “الحرية انقلبت جموداً، وإذا الإخاء والمساواة يذبلان أمام سلطان الباطشين من الحكام المستبدين. وعند ذلك بدأ تدهور الإمبراطورية وانحلالها. ولم يكن ذلك عجباً، والحياة الإنسانية فكرة ورسالة، وليست أداة يوجهها من شاء إلى ما شاء”.
ويؤكد هيكل أن “الحياة الإنسانية القائمة على الفكرة مثمرة دائماً، موجهة أبناءها جميعاً إلى ألوان من النشاط تزيدها قوة، وتدفع إليها كل يوم حيوية جديدة. فإذا انطفأ نور الفكرة لم يبقَ للرسالة وجود، وآن لهذه الحياة الإنسانية أن يتوارى كل ما فيها من ضياء، فلا يبقى منها إلا المظهر المادي، أو المظهر الحيواني للوجود. ولا قيام لإمبراطورية على أساس من المادة، ولا من المظهر الحيواني. ولذلك انحلت الإمبراطورية الإسلامية؛ لأن الرسالة التي آمن بها المسلمون الأولون توارت وراء الحجب”.
السياسي والديني
وبالتالي، فالخلاف والنقاش حول “الحروب/الغزوات”، وغياب الإجماع، إنّما يؤكد واقعيتها السياسية الحربية. وبمراجعة ابن كثير في كتابه: “البداية والنهاية”، أو ألفريد بتلر صاحب كتاب: “فتح العرب لمصر”، وترجمه فريد أبو حديد، فإنّ “الصحابي عمرو بن العاص ألحَّ كثيراً على الخليفة عمر بن الخطاب لغزو مصر. وروى له أنّه زارها قبل اعتناق الإسلام، ووجد فيها من موارد غنية وعمران متطور، ما يجعل الوصول لها ومد النفوذ فيها فرصة للتمكين والقوة. لكنّ الخليفة ظل متردداً ويتخوف من ذلك”.
الملاحظ، أنّ أياً من الصحابيين لم يذكر أحدهما، وفق ما هو مدون في كتب المؤرخين، الأحاديث النبوية المتداولة حول الفتح؛ بل غلب على الحوار بينّهما الواقع، أو بالأحرى الحسابات الواقعية، بما فيها من ربح وخسارة، واحتمالات عديدة لها ارتداداتها الميدانية والسياسية التي تحكم ذهنية رجال الدولة سياسياً وعسكرياً. فكان الخليفة يضع في اعتباره، بشكل عملي، المعاهدة بينه وبين الإمبراطور هرقل الذي هيمن على الإمبراطورية البيزنطية؛ في حين تبدو إغراءات الفتح واضحة ومباشرة، في قول الصحابي ابن العاص وهو يردد: “إنّك إن افتتحتها كانت قوة للمسلمين، وعوناً لهم، وهي أكثر الأرض أموالاً”.
كما أنّ إغراء ومحاولات إقناع عمرو بن العاص نفسه للخليفة، ليس فيها أي إشارة أو تلميح ديني؛ بل إنّ التوسع لأهداف براغماتية تتصل بالقوة الإمبراطورية ويميل لها أي طموح سياسي. فـ”كثرة الأموال” وتنوع الموارد الاقتصادية، حيث كانت مصر مصدر القمح للإمبراطورية الرومانية وبها مخازن الغلال، يجعلها وجهة للتمكين السياسي والنفوذ الخارجي.
بل إنّ عمرو بن العاص، بعدما انطلق جيشه إلى مصر واستجاب له الخليفة عمر بن الخطاب، كان عثمان بن عفان هو الآخر متوجساً وخائفاً من هذه الخطوة. ولم يُخفِ ارتيابه وشكوكه من عواقب الذهاب لغزو مصر؛ فخشى من هلاك المسلمين، كما يقول ابن عبد الحكم، في كتابه “فتوح مصر وأخبارها”. بل كتب الخليفة إلى الصحابي عمرو بن العاص، بأن “يعود أدراجه إن لم يكن قد دخل مصر بعد”.
إذاً، كان الحديث سياسياً واقعياً لم ترد فيه أي إشارات دينية تشي بنبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نسبوا إليه قوله: “إِنَّكُم سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يَسمَّى فِيْهَا القِيْرَاط، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا، فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا؛ فَإِنَّ لَهُم ذِمَّةٌ وَرَحِماً”. كما تتجلى عدة إشارات أخرى، منها ما ورد في عدة مصادر تاريخية، منها ما جاء لدى صاحب كتاب: “فتوح مصر وأخبارها”، حول كيفية إدارة المسلمين للجزية، والتي كانت سبباً في ثورات المصريين المتكررة، وغضبهم وامتعاضهم. كما أثقلت كاهلهم، لدرجة أنّ الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، كتب إلى عامله في مصر حيّان بن شريح، بأن يجعل جزية أموات الأقباط على أحيائهم، كما جاء في كتاب: “أقباط ومسلمون: منذ الفتح العربي إلى عام 1922م”، للمؤرخ جاك تاجر. وفي كتابه: “تاريخ العالم القديم ودخول العرب مصر”، يذكر المؤرخ القبطي يوحنا النيقيوسي: “وكان المسلمون قد امتلكوا مصر من الجنوب إلى الشمال، وضاعفوا الضرائب إلى ثلاثة أمثالها”.
ويقول جرجي زيدان، في كتابه: “تاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلامي إلى الآن مع فذلكة في تاريخ مصر القديم”، بأنّه “أتى عمرو بن العاص وجيشه بلبيس فقاتلوه فيها نحو شهر حتى فتح الله عليه، وكان في بلبيس أرمانوسة بنت المقوقس حاكم مصر من قبل الروم، فأحب عمرو ملاطفة المقوقس استجلاباً لوده فسيَّر إليه ابنته مكرمة في جميع ما لها، فسر أبوها بقدومها كثيراً”.
وتابع زيدان: “لما فتح المسلمون البلاد لم يتولوا حكومتها، بل نزلوا خارجها في معسكراتهم كالمحتلين؛ يستولون على الخراج والجزية، ويراقبون الأحكام. فعمرو بن العاص وجنده لما فتحوا مصر نزلوا في الفسطاط والإسكندرية، وتركوا سائر قرى مصر بأيدي القبط، ولم يكن أحد من المسلمين بالقرى، وإنّما كانت رابطة تخرج إلى الصعيد، حتى إذا جاء أوان الربيع انتشر الأتباع في القرى لرعي الدواب، ومعهم طوائف من السادات”.
نشبت أزمة بين ابن العاص والزبير بن العوام على توزيع الغنائم، وفق المقريزي، في كتابه “المواعظ والاعتبار”، وذلك بسبب رغبة الأخير في توزيع الغنائم فيئاً بحسب آلية النبي محمد في إدارة الأمر، وامتثالاً لما فعله في غزوة خيبر. وهذا يعني أنّ قريش سيضحى نصيبها خمس أراضي مصر وخمس مالها وخمس سباياها. غير أنّ ابن العاص عدل عن ذلك، باعتماد قانون الرومان حتى يتفادى أيّ انقسام وخلاف، وهو القانون الذي يصنف الأرض كلها كوحدة واحدة، ووافق على تلك الحيلة التوفيقية الخليفة عمر بن الخطاب.
دوافع الغنائم
لم تنقطع الثورات والاحتجاجات حتى العصر العباسي، كما يقول ساويرس بن المقفع، في كتابه “تاريخ البطاركة”، ومنها ثورة البشموريين بمصر في أوائل حكم العباسيين. فيقول ابن المقفع: “وكان متولياً الخراج في ذلك الزمان رجلين، أحدهما اسمه أحمد بن الأسبط، والآخر إبراهيم بن تميم، هذان مع ما كانوا الناس عليه من البلايا لا يراعيان طلب الخراج بغير رحمة، وكان الناس في ضيق زايد لا يحصى وأصعب ما عليهم ما يطلبه منهم متولو الخراج، وطلب ما لا يقدرون عليه، وبعد هذا أنزل الله الكريم بأحكامه الحق غلاءً عظيماً على كورة مصر، حتى إن القمح بلغ خمس ويبات بدينار، ومات بالجوع خلق كثير من النساء والأطفال والصبيان والشيوخ والشبان، ومن جميع الناس ما لا يحصى عدده من شدة الجوع…”.
ووفق العديد من المصادر التاريخية الإسلامية، اضطر الخليفة عبد الله المأمون إلى قيادة حملة عسكرية، لضبط الثورة والهبات الشعبية والتي وصفها في رسالة للوالي هناك بـ”الحدث العظيم”. وفي كتابه: “الولاة والقضاة”، يقول الكندي، إنّ المأمون نهر بحدة وغضب شديدين والي مصر. وقال له: “لم يكن هذا الحدث العظيم إلا عن فعلك وفعل عمالك، حملتم الناس ما لا يطيقون، وكتمتموني الخبر حتى تفاقم الأمر واضطرب البلد”.
ولا يختلف ذلك عن ما جرى في بلدان أخرى؛ ففي كتاب “فتوح البلدان”، يقول البلاذري إنّ “الصدام العربي الأمازيغي، عام 643 (22 هـ)، حدث بسبب الحملة التي قادها والي مصر عمرو بن العاص باتجاه برقة (تقع في ليبيا حالياً)، وقد طالب أهلها بجزية سنوية بلغت 13 ألف دينار. لكن بعد مقتل عثمان بن عفان تراجع الاهتمام بنشاط المسلمين في المغرب الغربي، ثم ما لبثت أن عادت بعد وصول معاوية بن أبي سفيان للحكم، الذي بعث حملات عسكرية لأفريقيا”. أما الدكتور حسين مؤنس، في كتابه: “فتح العرب للمغرب”، فيذكر أن “كلاً من القائدين معاوية بن حديج وعبد الملك بن مروان تخاصما حول توزيع غنائم مدينة جلولاء”.
فيما يشير المفكر المغربي، محمد عابد الجابري، في كتابه “العقل السياسي العربي”، إلى العامل المهم والمؤثر للغنائم كأحد دوافع الحرب الرئيسية، خاصة في فترة ما بعد وفاة النبي؛ فيقول: “في حال كانت قلة من المسلمين، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قد ربطوا تحركاتهم لجهة المساهمة في الفتح بالدعوة المحمدية، ونشر رسالتها، فإنّ الغالبية العظمى من جمهور المسلمين، وتتكون أساساً من المسلمين الجدد من قريش والأعراب، علاوة على المنافقين، كانت تتحرك بغرض الغنيمة أساساً، وقد كان هذا أمراً واقعاً وسائداً حتى زمن النبي نفسه”.
وهذا تحديداً ما ينطبق على فتح بلدان عديدة، مثل مصر والمغرب والشام. فقد كانت الغنائم وسيلة إغرائية قصوى تجعل اشتهاء الحرب ضرورة ملحة. ففي كتاب “فتوح البلدان”، يقول البلاذري: “لما فرغ أَبُو بكر من أمر أهل الردّة، رأى توجيه الجيوش إلى الشام، فكتب إلى أهل مكة والطائف واليمن، وجميع العرب بنجد والحجاز، يستنفرهم للجهاد ويرغّبهم فيه وفي غنائم الروم، فسارع الناس اليه من بَيْن محتسب وطامع، وأتوا المدينة من كلّ أوب، فعقد ثلاثة ألوية لثلاثة رجال…”. ويُضيف أن “آلاف المرتدين التحقوا في صفوف الجيوش المسلمة المحاربة بجبهتي الشام والعراق”.
وختاماً، يكفي أن نُشير إلى ما أورده الطبري، في “أخبار فتوح بلاد فارس”، من أن خالد بن الوليد قام خطيباً في جيشه قبل إحدى المعارك فقال مشجعاً لهم على القتال: “لو لم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء إلى الله عز وجل، ولم يكن إلا المعاش، لكان الرأي أن نقارع على هذا الريف، حتى نكون أولى به ونولي الجوع والإقلال مَن تولاه ممن اثاقل عما أنتم عليه…”.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.