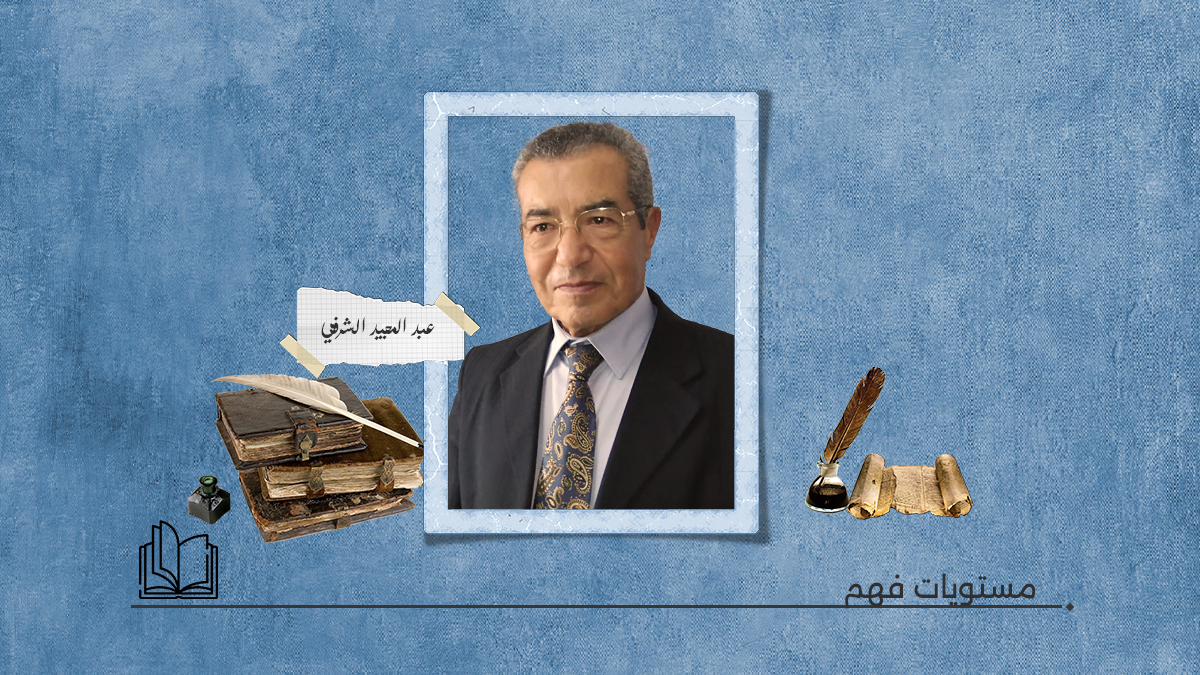
عبد المجيد الشرفي:
مستويات فهم الإسلام وإشكاليات القراءة
إنتاج فكر ديني جديد يعتمد على قراءة حديثة للنصوص الدينية، تلتزم المناهج والعلوم الحديثة، هو من المعالم الرئيسية للمشروع التجديدي للمفكر التونسي عبد المجيد الشرفي، (1942م)، الحاصل على الدكتوراه في الآداب من جامعة تونس، وشغل مناصب أكاديمية جامعية عديدة.
اهتم “الشرفي” بنقد وتحليل التراث الديني بأشكاله المختلفة، والتصورات التي قدمها وما نتج عنها في التاريخ المعاصر؛ ونادى باستخدام المعرفة العلمية الحديثة ومناهجها، لمعالجة ما سمّاه “الانحدار الذي تسبب فيه التراث”، وعبّر عن ذلك في عديد من مؤلفاته، مثل: “لبنات”، و”المسلم في التاريخ”، و”الإسلام والحداثة”، و”الإسلام بين الرسالة والتاريخ”، و”مستقبل الإسلام في الغرب والشرق”، و”الثورة والحداثة في الإسلام”.. وغيرها.
صور الإسلام
يرى “الشرفي” أن للإسلام صوراً مختلفة ومتباينة، الأمر الذي يظهر في سلسلة مؤلفات ودراسات فكرية، شارك فيها وأشرف عليها، حملت عنوان “الإسلام واحد ومتعدد”، تضمنت “15” دراسة عن صور الإسلام المختلفة، مثل: “الإسلام الخارجي وإسلام المتكلمين، والإسلام الشعبي، وإسلام الفلاسفة، وإسلام المجددين”.
ويذهب “الشرفي” إلى وجود ثلاثة مستويات لفهم الإسلام، هي:
1- مستوى القيم القرآنية: وهي قيم ومفاهيم نصَّ عليها القرآن، اشتملت على مبادئ عامة تشترك فيها الأديان السماوية كلها، مثل تحريم القتل وتجريم السرقة والزنا والكذب، وهي قيم دينية لها طابع وجودي يمكن اعتبارها جوهر الإسلام، وتُضفي “معنى على الحياة، وتتجاوز الزمان والمكان”، حسب قوله.
2- مستوى الممارسات التاريخية: محاولات المسلمين المستمرة في تأويل القرآن لتطبيق الدين على الحياة، هي ممارسات بدأت عقب انقطاع الوحي، واستمرت على مدار التاريخ، دون إدراك للتغيرات التاريخية والاجتماعية التي تسببت فيها الفتوحات ودخول غير العرب إلى الإسلام؛ وهذا المستوى من فهم الإسلام يجب أن “يخضع للنقد والمراجعة وفق منهج تاريخي دون تقديس”، حسب قوله.
3- مستوى الإيمان الفردي: وهو المستوى الثالث في محاولة فهم الإسلام، ويتعلق بالإيمان الفردي ومحاولة استبطان القيم والمبادئ الإسلامية عن طريق الفرد، الأمر الذي “يُظهر نماذج مختلفة للإيمان وفقاً للظروف الفردية، فيظهر إيمان العامة وإيمان الفلاسفة، وإيمان الصوفية وإيمان العلماء، وغيرها من النماذج الإيمانية الفردية”، حسب قوله.
الفترة المحمدية وجوهر الرسالة: يرى “الشرفي” أن للإسلام في بدايته، تحديداً في فترة الدعوة المحمدية، صفات مشتركة ثابتة مطلقة تتجاوز الزمان والمكان، ويمكن الاعتبار بها في العصر الحديث؛ لأنها جوهر الرسالة، مثل: التوحيد، ورفض الشرك، وعمومية الرسالة إلى جميع الناس، وقيم الخير والإحسان، ورفض الشر والظلم.
إشكاليات القراءة
أولاً، أيديولوجية التفسيرات الدينية: يذهب “الشرفي” إلى أن القراءات التراثية للنص الديني جاءت عبر مفسرين، استخدموا آراءهم ومواقفهم الطائفية والمذهبية في شروحاتهم للنص الديني وتفسيراتهم له، والتاريخ الإسلامي شهد قراءات أيديولوجية للنص الديني، وهي قراءات وتفسيرات يصفها “الشرفي” بأنها “خاطئة، وتخضع للحالة الاجتماعية والأدوات المعرفية السائدة وقتها، ما يجعلها قراءات غير صالحة للعصر الحديث”، حسب قوله.
ثانياً، الاستعانة بالمناهج العلمية لفهم النص الديني: التفسيرات والقراءات التراثية للنص الديني عجزت عن الجمع بين رسالة الإسلام المطلقة الصالحة لكل زمان ومكان، وبين العصر الحديث ومقتضياته؛ لذا يحاول “الشرفي” إيجاد فهم وقراءة حديثة للنص الديني، “تُناسب العصر الحديث واحتياجاته ومتطلباته الفكرية والاجتماعية والعلمية، الأمر الذي لن يحدث إلا عبر الاستعانة بالمناهج العلمية الحديثة”، حسب قوله.
ثالثاً، إشكالية تدوين الأحاديث النبوية: يرى “الشرفي” وجود أزمة في صحة انتساب الأحاديث النبوية إلى النبي، من أسبابها: “وجود فاصل زمني بين العهد النبوي وبين مرحلة تدوين الحديث، يصل إلى نحو قرن على الأقل، واستناد تدوين الأحاديث إلى ذاكرة أكثر من جيل بسبب الفارق الزمني”، حسب قوله.
إشكالية الأحاديث النبوية لا تزال قائمة ومطروحة عند “الشرفي”، ويجب معالجتها، عبر عرضها على العقل الإسلامي، للنظر فيها عبر المناهج والأدوات العلمية الحديثة، حسب قوله.
مراحل التأسيس
1- تحول الدين إلى مؤسسة: تأسست المؤسسات الدينية في الإسلام، تاريخياً، مع بدء تطبيق الرسالة الإسلامية عملياً على أرض الواقع، الأمر الذي حدث عبر مراحل ثلاث: “تميز المسلمين في عاداتهم ومظاهرهم من غيرهم، والمرحلة الثانية تحويل الشعائر والعبادات إلى طقوس واحدة ثابتة لا اجتهاد فيها، وأخيراً تحوُّل الدين إلى مؤسسة لا يمكن إنكار محتواها العقائدي أو التشريعي”، وفقاً لـ”الشرفي”.
2- ابتعاد المسلم عن نص القرآن: وحسب “الشرفي”، فإن المؤسسة الفقهية تأسست في الإسلام حتى تُخضع المسلم إلى أحكامها التي حددها الفقهاء وأعطوا لها صفات التقديس والتشريع، متعللين بأن هذه الأحكام مستنبَطة من نصوص مقدسة، ما تسبب في ابتعاد الشخصية المسلمة عن التعامل المباشر مع النص القرآني، ليتعامل مع ما تفرضه المؤسسة الفقهية من أحكام.
السلفية المقدسة
1- نزعة تاريخية لتقديس السلف: انتشر الفكر السلفي والسلفية تاريخياً وفي العصر الحديث، وتعامل التراث مع السلفية بنوع من التقديس، سببه ارتباط التراث آنذاك ببُعد اجتماعي وتاريخي سائد وقتها، هو النزعة والميل إلى تقديس السلف “الموعودين بالجنة”، كما أن نزعة التقديس السلفية لا تزال منتشرة في العصر الحديث، وتظهر بوضوح في مقولات تيارات الإسلام السياسي، حسب قوله.
2- موروث تراثي “ثقيل”: تقديس السلف وازدهار السلفية في التاريخ والعصر الحديث، تسبب في انحدار وتراجع وجمود الحضارة الإسلامية، حسب الشرفي، وكان من نتائجها تراجع الاجتهاد الديني، ما وقف حائلاً ضد أي قراءة جديدة للنص الديني.
ازدهار السلفية، عند “الشرفي” موروث تراثي “ثقيل يجب التخلص منه” وفتح باب الاجتهاد، لإيجاد قراءة عصرية للنص الديني تُظهر “حداثية الإسلام”، وفق قوله.
انهيار الحداثة
1- انهيار مشروعات الحداثة: من أسباب انهيار مشروعات الحداثة والنهضة العربية، حسب “الشرفي”، انتشار الخطاب الأصولي في التراث والعصر الحديث، لا سيما مسألة التوحيد بين الدين والدولة ورفض الفصل بينهما، وهو الخطاب الذي يصفه “الشرفي” بـ”المتصلّب”.
ويرى أن هذا الخطاب يتجاوز تبني توحيد الدولة والدين، إلى الهجوم على مبدأ مدنية الدولة و”علمانيتها”، ويصوره على أنه مبدأ “يتناقض مع الإسلام ولا يناسب المجتمع الإسلامي”، على عكس الحقيقة.
2- النضال لفصل الدين عن الدولة: يطالب “الشرفي” بضرورة فصل الدين عن الدولة، لتجنب انهيار مشروعات الحداثة في العالم الإسلامي، ولتأكيده أهمية ذلك المطلب يعرض آراء تنويرية سابقة تتفق مع مطلبه، مثل آراء الإمام محمد عبده، والشيخ علي عبد الرازق، وغيرهما، في فصل الدين عن الدولة، ويدعو “الشرفي” إلى “النضال من أجل تحقيق هذا الهدف”.
الأصولية والمرأة
يرى “الشرفي” أن مكانة المرأة في التراث الإسلامي متدنية، وسبب هذه الدونية “بعض الأحكام الفقهية المنسوبة إلى النص الديني، والتي حالت بين المساواة بين الرجل والمرأة، ومنعت المرأة من الإسهام المجتمعي، وأدت إلى فرض سيطرة الرجل، سواء كان أباً أو زوجاً”.
ويصف هذه الأحكام التي تسببت في تدني وضع المرأة، بأنها “ناتجة عن خطاب أصولي رجعي، ضد المرأة، من سماته النظرة الهرمية للبناء المجتمعي التي تضع الرجل فوق المرأة، والتقليل من حقوق المرأة أمام حقوق الرجل”.
ويدعي الخطاب الأصولي الرجعي، حسب “الشرفي”، عدم وجود ظلم ضد المرأة المسلمة، بل هي تحصل على حقوقها كاملة -دون توضيح حقيقة الغبن الواقع عليها- كما أن محاولات إنصاف المرأة هي دعوات غير طبيعية، تنسف النظام الطبيعي، ومحاولات تجديد الخطاب الديني الخاص بالمرأة مؤامرات تهدف إلى هدم الأسرة وإشاعة التحلل الأخلاقي، حسب قوله.
ويفند “الشرفي” الخطاب الأصولي ضد المرأة وينفيه، ويدعو إلى أهمية وضع قضايا المرأة في صُلب قضية التجديد الديني والحداثة الفكرية، مشدداً على أهمية وجود منظومة عقلية حداثية تواجه الخطاب الأصولي، الذي وصفه بـ”المُعادي للمرأة”، وتضع قضايا المرأة في أطُرها الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حتى يمكن الوصول إلى تجديد ديني حقيقي لوضع المرأة المسلمة.
وختاماً، مَثَّل تعمُّق “الشرفي” في تفسير الصور والأشكال المختلفة للإسلام، التي انتشرت تراثياً وعصرياً، وفهمه التحليلي الدقيق لمستويات فهم الإسلام والنص الديني، وتمكُّنه من تحديد الإشكاليات الخاصة بالتراث، والخطاب الأصولي، الذي ما زال “مزدهراً”، الجانب النظري في المشروع الحداثي له.
وإضافة إلى الجانب النظري من مشروعه، استطاع تقديم جانب عملي واقعي لتحقيق الحداثة والنهضة، ارتكز على الفهم الدقيق للإشكاليات التراثية والمعاصرة، وتمثل في الاستعانة بالعقل والمناهج العلمية، والعلوم الحديثة.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.