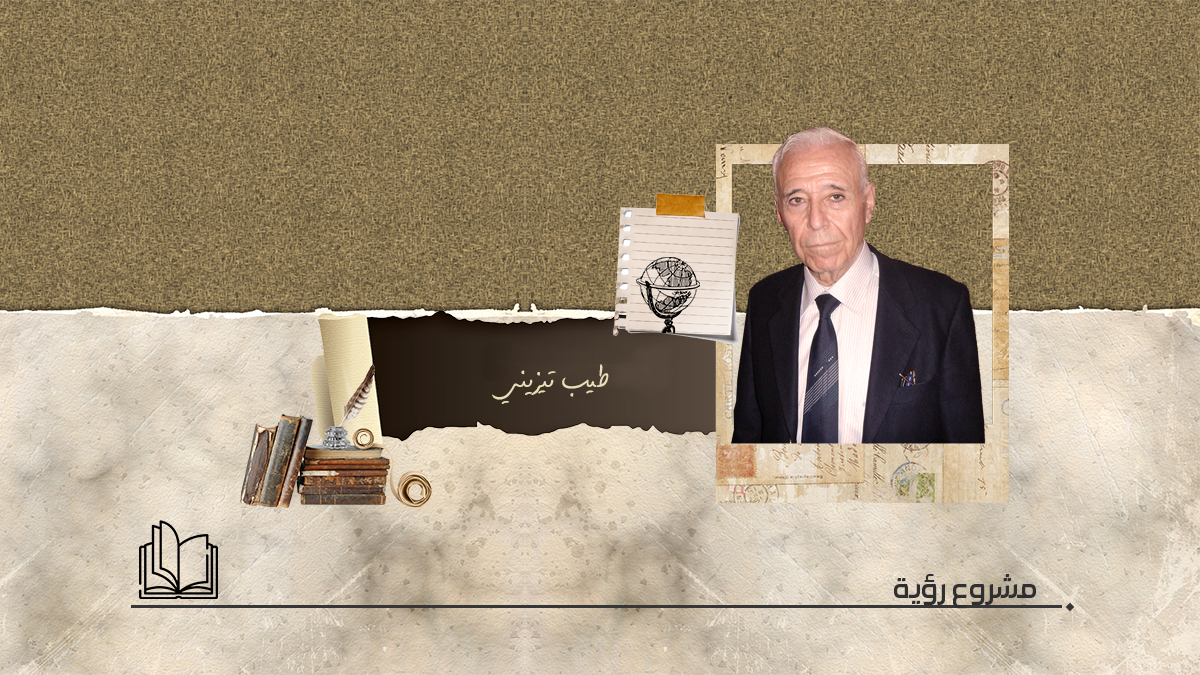
طيب تيزيني:
مشروع رؤية جديدة للتراث العربي
إعادة قراءة التراث العربي قراءة تاريخية علمية، تستند إلى منهج فلسفي في الجدلية المادية، هي محور رئيسي في المشروع الفكري الفلسفي للمفكر السوري طيب تيزيني (1934-2019م)، الذي اعتمد في قراءة التراث العربي على منهج تاريخي اجتماعي، ارتكز فيه على العلوم الإنسانية، واضعاً في اعتباره الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية الراهنة للحدث التراثي.
“تيزيني”، أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق، والحاصل على الدكتوراه من ألمانيا في الفلسفة العربية الوسيطة، ثم الدكتوراه في العلوم الفلسفية، تناول مشروعه الفكري الفلسفي فكرة إحياء النهضة العربية، وشروطها وأركانها، ووضع عبء مشروعه النهضوي على الأمة العربية كلها، وعبَّر عنه في مؤلفات عديدة، منها: “مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط”، و”حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث: الوطن العربي نموذجاً”، و”من التراث إلى الثورة”، و”التفكير الاجتماعي والسياسي”، و”أبحاث في الفكر العربي الحديث والمعاصر”، و”في السجال الفكري الراهن حول بعض قضايا التراث منهجاً وتطبيقاً”، و”من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي”.. وغيرها؛ إضافة إلى عديد من الدراسات والأبحاث العلمية والمقالات.
قراءة التراث
اهتم “تيزيني” بالتراث العربي، وقدم منهجاً يعتمد فيه على الجدلية المادية، وقراءة التاريخ وفق الظروف المعاصرة له عبر استخدام العلوم الإنسانية، ووضع أهم ملامحه قراءته النقدية للتراث العربي في كتابه “من التراث إلى الثورة”.
1- منهجية البحث في التراث العربي: البحث في التراث العربي يجب أن يكون عبر “منهجية تراثية ناجعة علمياً”، وفق “تيزيني”، الذي يرى أن هذه المنهجية لها أبعاد اجتماعية إنسانية، والهدف منها الوصول إلى “الحقيقة التراثية” التي لا تختلف عن “الحقيقة العلمية”، وهذه الحقيقة: “لا تكون حقيقة لأنها مفيدة، بل تكون مفيدة لأنها حقيقة”، وفق قوله.
المعيار الرئيسي في “المنهجية التراثية” لدى “تيزيني” هو الوصول إلى الحقيقة، عبر منهج علمي يتسم بآفاق إنسانية، تضع الحركة الداخلية للتراث في سياقها التراثي الحقيقي، المرتبط بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية آنذاك.
2- إعادة إنتاج التراث وفق العصرنة: يهدف “تيزيني” في قراءته للتراث إلى وضع “نظرية تراثية” تعتمد على إعادة كتابة التاريخ العربي، وتعيد إنتاجه وفقاً لمعطيات عصره وزمنه والبنية الاجتماعية والتاريخية؛ كما أنه يقدم نقداً للتراث نفسه وفق منهجه العلمي.
كما يقدم نقداً لمحاولات إعادة قراءة التراث من الباحثين المهتمين بالفكر العربي؛ فيرى أنهم تجاهلوا المنهج العلمي في بحثهم وكان هدفهم الخاص بالتراث “رغبة في إخضاعه سلباً أو إيجاباً، وعلى نحو مبتذل، لمصالح وحاجات سياسية عملية أو أيديولوجية نظرية أو غير ذلك من هذا القبيل”، حسب قوله.
3- الدور السلبي للنزعة السلفية: النزعة السلفية في التراث وفي عالمنا المعاصر لها دور سلبي، تَمثل في تقديس وتمجيد الماضي، وجعله مرجعاً أساسياً لحل الإشكاليات بنوعيها التراثية والمعاصرة، ونشأت مقابلها نزعة معاصرة مناهضة لها، ترفض الماضي وتتجاوزه لتدعو إلى الجديد.
وهي عنده نزعة تراثية عدمية تمثل رؤية غير متماسكة للتراث والتاريخ؛ وبين النزعتين، السلفية والمعاصرة، نشأت النزعة التلفيقية، التي تحاول الجمع بين النزعتين، ففقدت شخصيتها المتميزة.
4- الفكر العربي قبل الإسلام: اعتبر “تيزيني” أن العصر الجاهلي قبل الإسلام هو رافد للفكر العربي، وأنه مرحلة أساسية في سُلَّم تطور الفكر العالمي، رافضاً اعتباره عصراً جاهلياً ينطلق تناوله من الوجود التابع للإسلام؛ وعلى العكس، يرى “تيزيني” أن هذا العصر كان له وجود مستقل قبل الإسلام، وهو مرحلة فكرية هامة تطوَّرت حتى تصبح ما هي عليه بعد ظهور الإسلام، حسب قوله.
تأويل القرآن
1- تجاهل الإسلامويين لتغيرات التاريخ: القرآن نص مقدس عند “تيزيني”، تجاهلت تفسيرات الإسلامويين له التغيرات التاريخية؛ لذا يدعو “تيزيني” إلى تقديم تفسير تأويلي للقرآن يتجنب ما سمَّاه “أخطاء التفسيرات التراثية السابقة”، على أن يقدم رؤية جديدة عبر الاجتهاد العقلي والعلمي والفلسفي؛ الأمر الذي حرّض عليه القرآن ذاته، حسب قوله، إذ إن وجود “المحكم والمتشابه” في القرآن يفتح باب الاجتهاد في تفسيره اعتماداً على معطيات العصر الحالي، وعبر منهج علمي في التفسير، حسب رأيه.
2- التأويل وتعطيل أحكام القرآن: إعادة تأويل القرآن عند “تيزيني”، وفق المعطيات العصرية، “تتحمل تعطيل بعض أحكامه”؛ فقد عُطِّلت أحكام قرآنية بداية من زمن النبي، اعتماداً على “النسخ” في القرآن، وكذلك مسألة زواج المتعة، ثم “المؤلفة قلوبهم”. وذهب “تيزيني” -بناء على ذلك- إلى إمكانية تعطيل أحكام بعض الآيات، وفقاً لما يفرضه الواقع المعاصر، كما حدث أيام النبي وبدايات عصر الإسلام.
الدين والفلسفة
يتبنَّى “تيزيني” موقفاً توافقياً في توصيف العلاقة بين الدين والفلسفة، ورغم إقراره باختلافهما المعرفي والمنهجي، فإنه يقر بأهمية العلاقة بينهما.
1- الاختلاف النسقي: يؤكد “تيزيني” وجود علاقة مفتوحة بين الدين والفلسفة، رغم وجود اختلاف نسقي معرفي بين الحقلين؛ فهذا الاختلاف النسقي لا يؤدي بالضرورة إلى صراع حتمي، بل يمكن عبره بناء حوار وتفاهم بين أصحاب الفريقين من المتديِّنين والفلاسفة، لا سيما في القضايا الإنسانية المصيرية.
2- الاختلاف المنهجي: لا يقتصر الاختلاف والتمايز بين الدين والفلسفة على النسق المعرفي، عند “تيزيني”، بل يتجاوزه إلى الخلاف المنهجي، الأمر الذي يظهر عند تناول قضايا هامة، مثل الوجود والمعرفة والعقل. وسبب هذا الاختلاف راجع للاعتماد على العقل فقط في المنهج الفلسفي، لكن ذلك الاختلاف لا يجب أن يقف حائلاً في العلاقة بين الدين والفلسفة؛ إذ إن العَلاقة بينهما تتسبب في نتائج إيجابية مثمرة لكل منهما، وفق قوله.
3- الاستبداد الفكري: يرفض “تيزيني” ما سمَّاه “الاستبداد الفكري” الذي جعل الفكرة الإسلامية، وفق قوله، “بنية مغلقة تتأبى على كل تأثر من خارجها”؛ ويذهب إلى أن الاستبداد الفكري الذي حدث في التراث، وامتد إلى العهد الحالي، تسبب في حالة إرهاب مادي، سواء تاريخياً أو في العصر الحالي. ويدعو، في المقابل، إلى إلغاء هذا الاستبداد، لا سيما أنه يصف “الفكرة الإسلامية” بأنها “قادرة على التأثير في الخارج، ويمكن التعاطي والتعامل معها”، وفق قوله.
النهضة العربية
1- إنتاج فلسفي عربي: انطلاقاً من موقف “تيزيني” بشأن العلاقة بين الدين والفلسفة، فإنه يدعو إلى ظهور إنتاج فلسفي عربي يساعد في نهضة المجتمعات العربية لوصولها إلى مرحلة التنوير، ويذهب إلى أن خصائص هذا الإنتاج الفلسفي العربي يجب أن تخضع للعلاقة المحتملة بين الدين والفلسفة، ووفق إطار من العقلية العلمية.
2- المشروع النهضوي: المعني بنهضة الأمة العربية عند “تيزيني” هي الأمة بكاملها، فيدعو الأمة العربية إلى أن تكون حاملة للمشروع النهضوي، الذي يحتاج إلى مساحة من الحرية والديمقراطية واحترام التعددية، ليتحول المشروع النهضوي من مشروع نظري إلى تطبيق عملي على أرض الواقع، حسب قوله.
الإسلام والمرأة
يذهب “تيزيني” إلى أن وضع المرأة في الإسلام بدأ تحديده في بدايات الإسلام عبر علاقة النبي بزوجاته؛ تلك العلاقة التي أرست قواعد دينية جديدة تنظم المعاملة بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي عبر ترسيخ مبدأ ديني مثل “الحلال والحرام”، فيما يرى أن التراث الإسلامي أوجد قطبية دينية بين الرجل والمرأة، كرَّست لدونية المرأة أمام الرجل، ما سمح له بفرض سلطته الذكورية على المرأة، التي أصبحت موضوعاً للسيادة والملكية الخاصة، وفق قوله.
وختاماً، فإن الفيلسوف والمفكر السوري طيب تيزيني، الذي صنفته مؤسسة “كونكورديا” الفلسفية الأوروبية، في عام 1998م، ضمن أهم “مائة” فيلسوف عالمي، وضع نظرية تراثية جديدة ترتكز على فتح باب التجديد أمام كتابة التاريخ العربي، في ضوء عقلي إنساني، يتباعد عن الأيديولوجيات التي وصفها بأنها “تخطئ” في التعامل مع التراث، وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة، التي يبني عليها مشروعه النهضوي للفكر العربي.
إن الاستبداد الفكري في التراث العربي، حسب “تيزيني”، يُلقي بظلاله على الحاضر، ويخلق تدهوراً وينشر حالة من الإرهاب المادي، لذلك دشن مشروعاً توافقياً بين الدين والفلسفة، رغم إقراره باختلاف النسق المعرفي لكل منها، ومغايرة منهج كل منهما للآخر، فيما يرى أن ظهور مشروع عربي فلسفي على علاقة بالدين من شأنه إفادة الدين والفلسفة معاً.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.