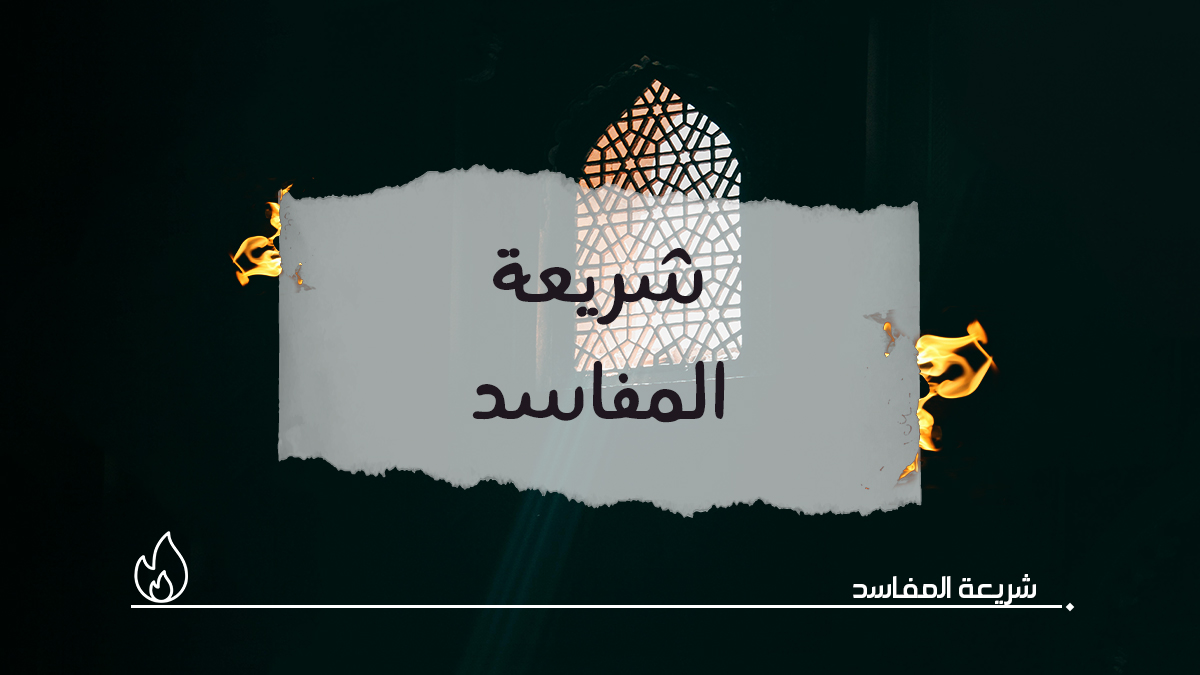
شريعة المفاسد:
معمر عطوي وكيفية تناول النص الديني
في كتابه “شريعة المفاسد.. الاجتهاد الغائب عن فضاء النص الديني”، ينطلق الباحث اللبناني معمر عطوي، في محاولته لإصلاح ما سمَّاه “الخلل” الناتج في الفكر الإسلامي التراثي والمعاصر، من قاعدة “درء المفاسد وجلب المصالح”، ليجعلها منهجاً للولوج إلى “أخطاء” التعامل مع النص الديني.
ويُقسم “عطوي” النص الديني لأقسام ثلاثة: “القرآن الكريم” الذي يجب إعادة تفسيره بما يتوافق مع العصر الحالي، دون الثبات على التفسيرات التقليدية له الممتدة تاريخياً رغم جمودها، و”الحديث النبوي” الذي يرى ضرورة إعادة النظر فيه وفقاً للقرآن والعقل، وأخيراً الفتاوى الفقهية بمراحلها التاريخية الجامدة، لإعادة إنتاج فقه يناسب الإنسان المعاصر، عن إفادة وتوافق مجتمعي.
يحاول “عطوي” الخروج بالدين مما سمّاه “الحصار اللاهوتي الغيبي المفروض عليه”، وذلك عبر إخراج النص الديني “من الجمود والتقليد إلى رحابة العقل وسعة منهجه”، من خلال إعادة التأويل، لا سيما في ما قيل عنه إنه “مقدس” في النصوص الدينية، عبر ذكر أمثلة تاريخية ومعاصرة، متجهاً إلى “تعرية مقولات التيارات الإسلاموية التي تُشرْعِن بها القتل والإرهاب وسفك الدماء”، داعياً إلى “المدنية الكاملة” حتى يتدارك العالم الإسلامي التطور الذي فاته.
أزمة الفكر الديني
1- تخبط الأمة وأزمتها الدينية: يقول “عطوي” إن الأمة الإسلامية تعاني من حالة تخبط، بسبب أزمتها مع الفكر الديني التراثي، فهي “تتخبط في تراثها دون العمل على إنتاجه وفق تطورات العصر بأدوات العقل نفسها”. ويضيف أن الفتاوى الدينية لا تزال “غارقة في تاريخانيتها”، محاولاً إيجاد ما يُطلق عليه “مخرجاً من حالة التخبط التراثي”، لجعل الإسلام عنواناً حضارياً غير محصور في الجانب اللاهوتي، بما يسهم في إخراج المجتمعات “من تخلُّفها وتجمُّدها”، وإن كان الجهل والاستعمار سبَبَيْن من أسباب تراجع أمّتنا، فيُضاف إليهما “انكماش فكري من الداخل واستغلال لهذا الانكماش من الخارج”، حسب قوله.
2- عدم احتكار النص الديني: يرى “عطوي” أن النص الديني “غني بالدلالات والمفردات، وهو بمثابة فضاء لا يجوز احتكاره ولا يمكن حصره في مجموعة من العقائديين الذين جمدوا حركته، وقلصوا دوره عبر فتاواهم العقيمة”.
ودعا إلى ضرورة صنع واقع جديد يستفيد من تعاليم النص الأخلاقية والسلوكية ويجسد منظومته القيمية في المجتمع، وهذا لا يتم الا بعودة الاجتهاد إلى ساحة الإسلام لتطويرها بما يلائم روح العصر، حسب قوله.
3- الاجتهاد الغائب عن الإسلام: يرى “عطوي” أن الاجتهاد في النص أداة هامة للخروج من الأزمة، لا سيما وأن للنص الديني قدرة كبيرة على الإقناع والتأثير في فئات عريضة من المجتمعات الإسلامية، مؤكداً أهمية “الاجتهاد في النص”، الذي يصفه بأنه “فريضة غائبة عن الفضاء الإسلامي”؛ مفسراً براجماتية الاجتهاد في النص التي هي قاعدة دينية وصفها بـ”الأساسية”، وهي “درء المفاسد أولى من جلب المصالح”.
4- الاجتهاد المسكوت عنه: الاجتهاد فريضة غائبة مسكوت عنها مع المسكوت عنه في التراث الديني، والإشكالية الرئيسية في المجتمع الإسلامي هي حالة الاقتناع السائدة بأنه “لا اجتهاد مع نص”، حسب قوله؛ بينما التراث نفسه يحمل ما ينفي ذلك، فعلي بن أبي طالب، أكد أن النص بشقيه القرآني والحديث “حمَّال أوجه”، قابل للتفسيرات المتعددة والمختلفة.
ويستنتج “عطوي” أن التفسير الظاهري للقرآن لا يكفي لجلاء دلالته ومعانيه، والسُّنة، التي تُتَّخذ بوصفها أحد مصادر التشريع، “محل تشكيك بسبب خضوعها لعلوم الجرح والتعديل”، ما جعل بعضها ضعيفاً وبعضها باطلاً أو مدسوساً، الأمر الذي يُصَّعِب إعادة تدوينها، بل إن التشريع نفسه محل خلاف بين المذاهب الإسلامية المختلفة، حسب قوله.
5- الواقع والنص الديني: يدعو “عطوي” إلى إعادة تأويل النص الديني بما يتناسب مع واقع العصر وحاجات الإنسان اليومية والمجتمعية، واضعاً شروطاً للتأويل، وهي: “العقلانية”، و”الابتعاد عن التقليد الأعمى”، و”رفض تقويض الحرية الفكرية”، و”الاجتهاد وفق مصلحة المجتمع الفرد، وعبر المعطيات السابقة”؛ لافتاً إلى أن تجاهل ذلك يؤدي إلى وضع الحالة المدنية تحت السيطرة الدينية، فتتراجع مدنية المجتمع.
6- الحاجة إلى تغيير ديني: حينما يقف الدين حائلاً دون التطور والتجديد، حسب “عطوي”، تكون الحاجة ملحة إلى “تغيير ثوري” يستند إلى الاجتهاد العقلي في تأويل النص الديني؛ إذ إن الدين “يلعب في أحيان كثيرة دور المعوّق للتطوّر والمُسهِم في ترسيخ التخلّف، من خلال بُعده العقائدي الجامد الذي يسيطر على البشر فيجعلهم أسرى للفتوى، حتى لو كانت في غير الصالح العام، أو في غير خدمة القِيَم، أو حتى في غير سبيل تحقيق أحد أبرز مقاصد الشريعة”، حسب قوله.
7- مفهوم الدين الخطر: يشرح “عطوي” مفهوم “الدين الخطر”، الذي يتولد بسبب التحجُّر في التفكير التقليدي والثبات وتغييب العقل، بما يجعل من بعض العادات الاجتماعية الخطرة والمُضرة عقائد ثابتة لا يمكن التشكيك فيها، مثل الثأر والحجاب والقتل، رابطاً بين مفهومه وبين قول كارل ماركس إن “الدين أفيون الشعوب”.
8- المعتزلة والفلسفة اللاهوتية: فرقة المعتزلة مدرسة فكرية دينية ظهرت في صدر الإسلام إثر “الخلافات السياسية في المرحلة التي واكبت نهاية الخلفاء الراشدين”، في ذلك العهد، الذي وصفه “عطوي” بأنه “أكثر المراحل جدلية وأشدها تعقيداً”.
فالمعتزلة بشكل خاص، وعلم الكلام بشكل عام، وجه آخر للفلسفة اللاهوتية، أظهرت اتجاهاً نحو “إعمال العقل في النص، وهي محاولة لفهم العقيدة الإسلامية في ضوء العقل الإنساني، ذلك لأن المعتزلة منطلقون من اعتبارهم أن الأوامر والنواهي التي أصدرها النبي، قابلة من بعده للاجتهاد وإعمال العقل فيها وفقاً للظروف التاريخية، فاستخدموا الفلسفة في فهم العقيدة وإبداء آرائهم”، حسب قوله.
جمود الحركات الإسلاموية
يقول “عطوي” في كتابه إن التعامل مع النص الديني، وتطبيق الشريعة بظاهرها الصريح، دون تأويل، يؤديان إلى انتشار الفكر التكفيري الذي يتسبب بدوره في الفوضى والحقد المجتمعي.
أولاً، علاقة الجمود بالتكفير: يلفت “عطوي” إلى أن ما تفعله الجماعات الإرهابية، من قطع للأيدي والرؤوس، بحجة تطبيق الحدود كالردة والسرقة والرجم، نتاج ذلك الجمود الديني؛ إذ إنهم، حسب قوله، ارتكزوا في أفعالهم إلى نصوص من الموروث الديني التقليدي ونسبوها للمقولات المقدسة، فأنتجوا فتاوى الإرهاب أو فتاوى استغلتها الجماعات الإرهابية في جرائمها.
ثانياً، عقم الحركات الإسلاموية: في كشفه زيغ الحركات الإسلاموية وحقيقتها، والأسس القائمة عليها ومصدرها، ينطلق الكاتب من قاعدته الإسلامية الأساسية التي أقرها “درء المفاسد وجلب المصالح”، فيذهب إلى أن مفاسد الجمود والتقليد وازدواجية المعاير أنتجت تلك الجماعات، التي استغلت ذلك الجمود في تبرير تخبطها، واستخدام الدين لأهداف غير مشروعة، تحوّله إلى أداة للفُرقة بعد أن كان راية تجمع الكل.
ثالثاً، استثمار فكرة الجهاد: لقد استغلت التيارات الإسلاموية فكرة الجهاد، ونزعت عنه سماته العامة وروحانيته، وحوّلته إلى حرب “مقدسة”، حسب “عطوي” في مؤلَّفه، فصارت عدوة لمجتمعاتها ولكل مخالف لها، فاتجهت إلى “الهجرة من المجتمع وتكفيره، واعتماد القتل والإرهاب”، واتهمت المجتمع بـ”الجاهلية”.
رابعاً، في مفهوم التربية العقيمة: يصف “عطوي” التربية الدينية الحالية، المعتمدة على التراث التقليدي المتجمد، الذي يحتاج بشدة إلى إعمال العقل، بأنها “تربية دينية عقيمة”، تؤدي إلى عدم الفهم لصحيح الدين، وإلى إشكاليات تنتقص من مدنية المجتمع؛ وهذه التربية، تؤدي إلى التناقض بين القانون السائد على الجميع وبين التحريم الديني، فقد توجد أمور محرمة دينياً متاحة قانونياً، والعكس، ما يؤدي إلى إشكالية مجتمعية وحياتية تحتاج إلى إعادة نظر عميقة تستند إلى المنهج العلمي والعقلي.
خامساً، مصطلح إنسان القطيع: يستلهم “عطوي” مصطلح “إنسان القطيع” من الفيلسوف الألماني “فريدريك نيتشه”، ليصف به الحالة السائدة للأفراد الذين يتلزمون القيم المجتمعية السائدة والمتوارثة حتى وإن كانت خاطئة، ويصفهم بأنهم أتباع المجتمع والفترة، ويدعو إلى تجاهل ذلك التقليد الأعمى للقيم التراثية السائدة في المجتمع، والتعاطي معها بشكل عقلي لتحديد ما يصلح أو ما لا يصلح، أو ابتداع قيم جديدة تتناسب والعصر الحالي.
ويضع الكاتب “المدنية الكاملة” -غير المنتقصة- شرطاً للتقدم والتطور والتجديد، التي لا يمكن أن توجد إلا بعد “تنحية المقدس”، متسائلاً: “متى يأتي دورنا في تنحية المقدّس؟”، ليعرض إجابة استلهمها من تجربة الاتحاد الأوروبي، حينما حذفت أوروبا كل إشارة إلى الدين من دستورها الجديد، ووضعت مبدأ راسخاً ألا وهو “الاتّحاد ليس نادياً مسيحياً”، حسب قوله.
ومن ثم، فقد طالب بالاقتداء بهذه الخطوة، مع العمل على إصلاح الفكر الديني لإصلاح بعض التناقضات فيه، حسب إشارته.
مخرج إصلاحي
يحاول “عطوي” عبر كتابه “شريعة المفاسد.. الاجتهاد الغائب عن فضاء النص الديني”، إيجاد ما سمّاه “مخرجاً للأزمة الإسلامية الراهنة” حتى يتصالح المجتمع الإسلامي مع الحضارة، عبر العقل كأداة تعالج النص الديني بعيداً عن تفسيراته التقليدية الجامدة، وليجد تفسيرات ودلالات توظف في المصالحة الإسلامية مع الحضارة، وتخدم مصلحة المجتمعات الإسلامية وأفرادها.
وفي سبيل ذلك، انتقد حالة “السكوت العمدي” عن الاجتهاد التي عانى منها التراث الإسلامي عبر تاريخه، مما وقف عقبة كؤود ضد التجديد الديني؛ كما رفض “الجمود العقلي” الذي استخدمته الجماعات الإسلاموية المتطرفة في التأصيل لأفعالها الإرهابية، شارحاً عيوب التربية الدينية المعتمدة على التراث التقليدي.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.