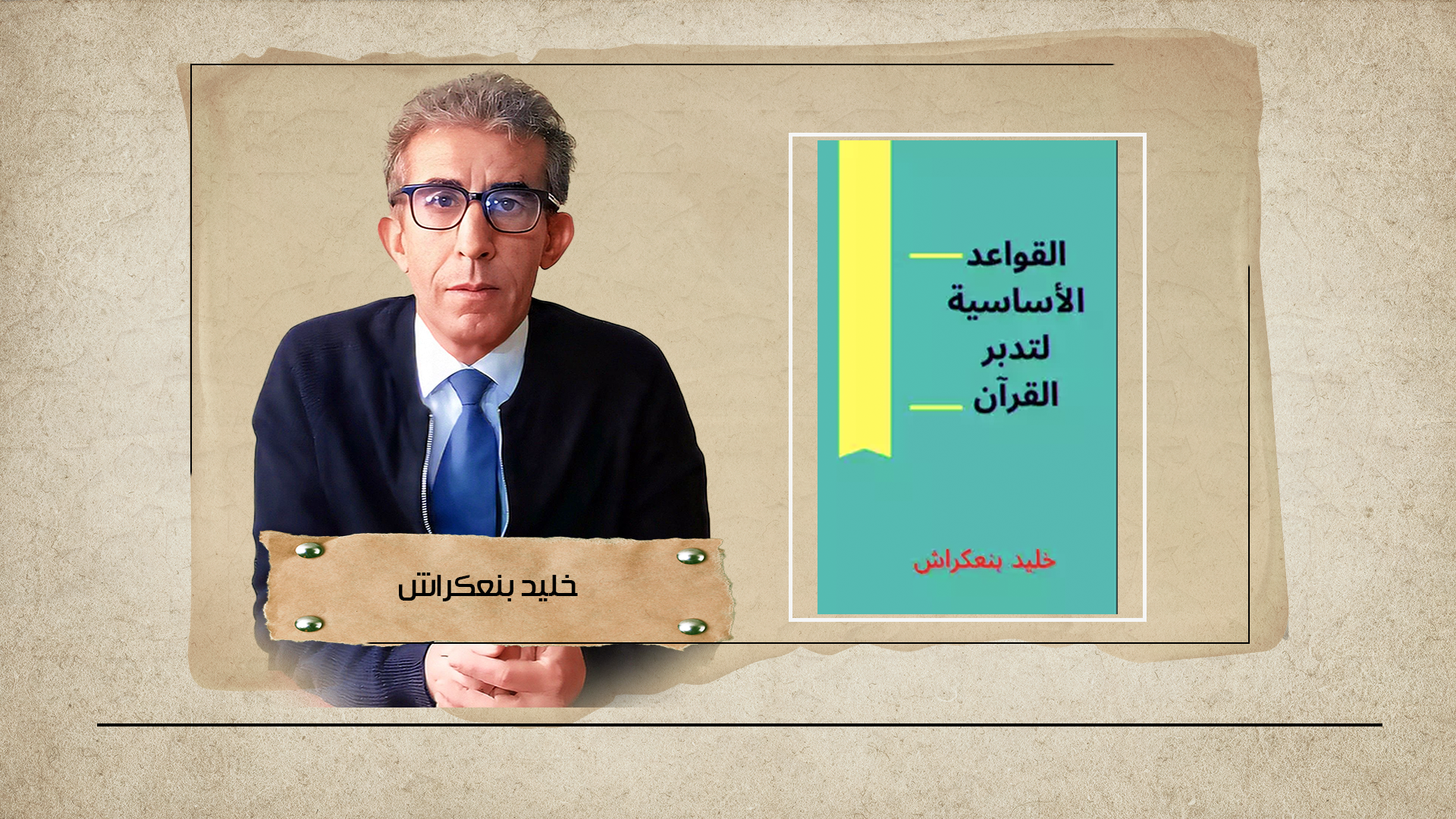
خليد بنعكراش:
القواعد "الست" في فهم وتأويل القرآن
فهم القرآن وتأويله قضية شغلت فكر الباحث المغربي خليد بنعكراش؛ إذ خصص لها كتابه “القواعد الأساسية لتدبُّر القرآن”، الذي شقَّ مساراً لمحاولة فهم القرآن عبر “ست” قواعد رئيسية استقاها من القرآن الكريم، وبنى عليها أساس تأويله.
يحاول “بنعكراش” أن يتجه إلى القرآن لاستنباط جميع الأحكام وتحديد الحلال والحرام؛ إذ يرى أن القرآن تعرض لفهم خاطئ، حسب قوله، تتابع حتى الوقت الحالي، وتسبب فيه عدم فهم القرآن فهماً صحيحاً وفقاً للغة العربية، الصافية الخالية من أي لفظ غير عربي، ما وصفه بـ”اللسان العربي”، ولعدم تفسير القرآن وفهمه بالقرآن نفسه، فوضع القواعد الأساسية لتدبر القرآن منهجاً ينطلق منه، فتجلى في جميع مؤلفاته ومنها: “القواعد الأساسية لتدبر القرآن”، و”الأخطاء الفقهية في الإرث والوصية”، و”الربا الحلال بالدليل من القرآن والسُّنة”، و”المحكمات والمتشابهات بين القرآن والفقه”.. وغيرها.
تدبر القرآن
في كتابه “القواعد الأساسية لتدبر القرآن”، وضع “بنعكراش” ست قواعد لفهم القرآن وتدبره، استخلصها من القرآن، معللاً إياها بما أورده في مقدمة الكتاب: “تعيد تدبر القرآن طبقاً للقواعد التي بداخله، ونعترف بأن آباءنا تدبروه حسب ما كان لديهم آنذاك من معرفة وآليات تناسب الحقبة التي كانوا يعيشون فيها”، حسب قوله.
1- القرآن عربي لا إعجام فيه: انطلق “بنعكراش” في قاعدته الأولى لتدبر القرآن من الآية: ﴿إِنَّا جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰناً عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ [الزخرف: 3]، فيرى أنه لا يمكن أن يعقل ما بداخل القرآن إلا إذا جرى تدبره باللغة العربية، والقرآن عربي بحروف عربية، والكلمات التي كُتبت بها هذه الحروف هي كلمات عربية؛ ووفقاً لهذه القاعدة، عند “بنعكراش”، فلا يمكن أن يتضمن القرآن “كلمات أعجمية كالسريانية أو الحبشية”، حسب قوله.
وأي قول إن بعض آيات القرآن أو بعض الكلمات أو حتى بعض الحروف التي وردت به مفردة هي غير عربية، فإنه يناقض قول الله: ﴿كِتَٰبٞ فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥ قُرۡءَاناً عَرَبِيّٗا لِّقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾ [فصلت: 3]، حسب قوله.
2- القرآن نزل بلسان عربي: جعل “بنعكراش”، الآيات في قوله سبحانه: ﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٭ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ ٭ عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ ٭ بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ﴾ [الشعراء: 192-195]، أساس القاعدة الثانية لتدبر القرآن؛ ويذهب فيها إلى أن “القرآن اعتمد على اللسان العربي، وليس على لسان العرب”، لأن لسان العرب يخضع لتغيرات جغرافية وزمانية وقد يتضمن كلمات دخيلة على اللغة العربية، بينما اللسان العربي يتقيد باللغة العربية الصافية دون أي تدخل خارجي بها.
وعند “بنعكراش” فإن المزج الخاطئ بين اللسان العربي ولسان العرب أدى إلى ما سماه “أخطاء” في تفسيرات القرآن، حسب قوله.
3- البعد عن الأهواء: استخدم “بنعكراش”، الآية في قوله تعالى: ﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾ [ص: 29]، ليوضح بها أهمية أن نبحث في معاني القرآن حتى نفهم آياته، بعيداً عن الأهواء والميول النفسية، شارحاً أن أولى الناس بفهم القرآن هم من وصفتهم الآية الكريمة، “أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ”، أي الذين يستخدمون عقولهم في الفهم، حسب قوله.
4- قرآن غير ذي عوج: يشرح “بنعكراش” القاعدة الرابعة لفهم وتدبر القرآن، منطلقاً من الآيتين: ﴿وَلَقَدۡ ضَرَبۡنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٖ لَّعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٭ قُرۡءَاناً عَرَبِياً غَيۡرَ ذِي عِوَجٖ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ﴾ [الزمر: 27-28]، بأن الله استعمل الكلمة الواحدة في عدة آيات لكي “نتعرف على دلالاتها التي تصاحبها في كل تلك الآيات ولا يمكن تغييرها”، فيقول نصاً: “يجب عندما نتدبر القرآن أن نبحث عن المعنى العميق للكلمة، أي دلالاتها التي لا تتغير حسب تغير الآيات، لكي يكون كتاب الله تعالى قرآناً (قراءة) غير ذي عوج”، وفقاً لقوله.
5- تفصيل القرآن وضرب الأمثال: لتأسيس القاعدة الخامسة، يستعين “بنعكراش” بقوله عزَّ وجل: ﴿وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَا فِي هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٖۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ أَكۡثَرَ شَيۡءٖ جَدَلٗا﴾ [الكهف: 54]، التي يذهب فيها إلى أن الله صرف القرآن، أي فصّله عبر آيات وصرفها لنا كأمثلة لسببين هما:
– “ليبيّن ويحدد كل شيء، لكي لا يضطر المسلمون إلى استفتاء بعضهم بعضاً، فيحرّموا عليهم ما لم يحرمه تعالى”.
– “ليفصل كل الأنباء والقصص التي جاء بها القرآن، لكي يأخذ الناس منها العِبَر وليؤمنوا بأن القرآن من عند الله”، حسب قوله.
6- القرآن محفوظ حتى قيام الساعة: القاعدة الأخيرة استمدها “بنعكراش” من قوله عزَّ من قائل: ﴿الٓرۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1]، ويذهب فيها إلى أن هذه القاعدة أهم القواعد جميعاً؛ لأنها أساس كل القواعد الأخرى، لأنها: “حفظ بها تعالى كتابه”، وحفظه “من كل تحريف من البشر وإلى قيام الساعة”، مستشهداً بآية ﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ [الحجر: 9].
الربا الحلال
يرى “بنعكراش” أن الله بيَّن في كتابه كل ما حرمه وفصله تفصيلاً، لذا يتساءل: “أين بيَّن الله وفصّل تحريم القرض بفائدة”، موضحاً وجود ما سماه “ربا حلال” ذكره في القرآن: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [آل عمران: 130]؛ إذ الآية تمنع المغالاة في أكل الربا أضعافاً مضاعفة.
أولاً، بين الربا والتجارة: يفرق “بنعكراش” بين لفظ البيع الذي ارتبط بالربا في القرآن: ﴿… ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ…﴾ [البقرة: 275]، وبين لفظ التجارة في القرآن وفقاً لقوله: “كل تعامل بين الناس ينتج عنه كسب أو ربح”، وتأتي بمعنيين: الأول القيام بعمل مقابل أجر؛ والثاني عبر الشراء والبيع.
ثانياً، تجارة حاضرة وغير حاضرة: يذهب “بنعكراش” إلى أن التجارة نفسها بها نوعان:
– النوع الأول: تجارة غير حاضرة اشترط فيها الله المُكاتبة والشهود؛ حتى لا يظلم طرفٌ طرفاً، وفقاً لـ”بنعكراش” الذي استشهد بآية: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ﴾ [النساء: 29].
والنوع الثاني: تجارة حاضرة كشراء سلعة ولا يشترط فيها المكاتبة والشهود، حسب قوله.
ثالثاً، ربا البيع وربا التجارة: وفقاً للتقسيم السابق، يرى “بنعكراش” أن الله حرَّم ربا البيع، لكنه لم يحرّم ربا التجارة أو ربا القرض، ويذهب إلى أن الله ﴿يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ﴾ [البقرة: 276]؛ ويقول: لم يقل القرآن إن الله يحرّم الربا، لأنه هو بنفسه يُربي ويضاعف لكل من أقرضه مالاً كما جاء في سورة البقرة: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضاً حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗۚ﴾ [البقرة: 245]، ويتساءل: “كيف يمكن أن يحرم على عباده ما أحلّه لنفسه؟”.
ويختتم “بنعكراش”، كتابه “الربا الحلال بالدليل من القرآن”، بفائدة يلخصها في قوله: “الربا الحلال هو كل كسب أو ربح ينتج عن معاملة تجارية تتم عن تراضٍ ولو كان قرضاً بفائدة”، وينتقل منها إلى أن المعاملات البنكية والقروض “لا حرمة فيها”، حسب قوله.
وختاماً، لا يُنكر “بنعكراش” السُّنَّة، بل يأخذ على القائمين عليها أنهم لم يهتموا بها، بل اهتموا بالرواة دون أي اهتمام بما جرت روايته، ويذهب إلى أن ما يسمى “علم الحديث، ليس بعلم الحديث”، بل هو “علم الرجال، وعلم الجرح والتعديل، وهو ينظر في أحوال الرجال دون النظر إلى السُّنَّة والأحاديث نفسها”، حسب قوله؛ وإزاء هذا يقول “لا بد من التحقُّق باعتبار أن المنقول عن الرسول نبأ يستحق منا أن نتثبّت منه خشية أن نصيب معرفة بجهالة”، حسب قوله.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.