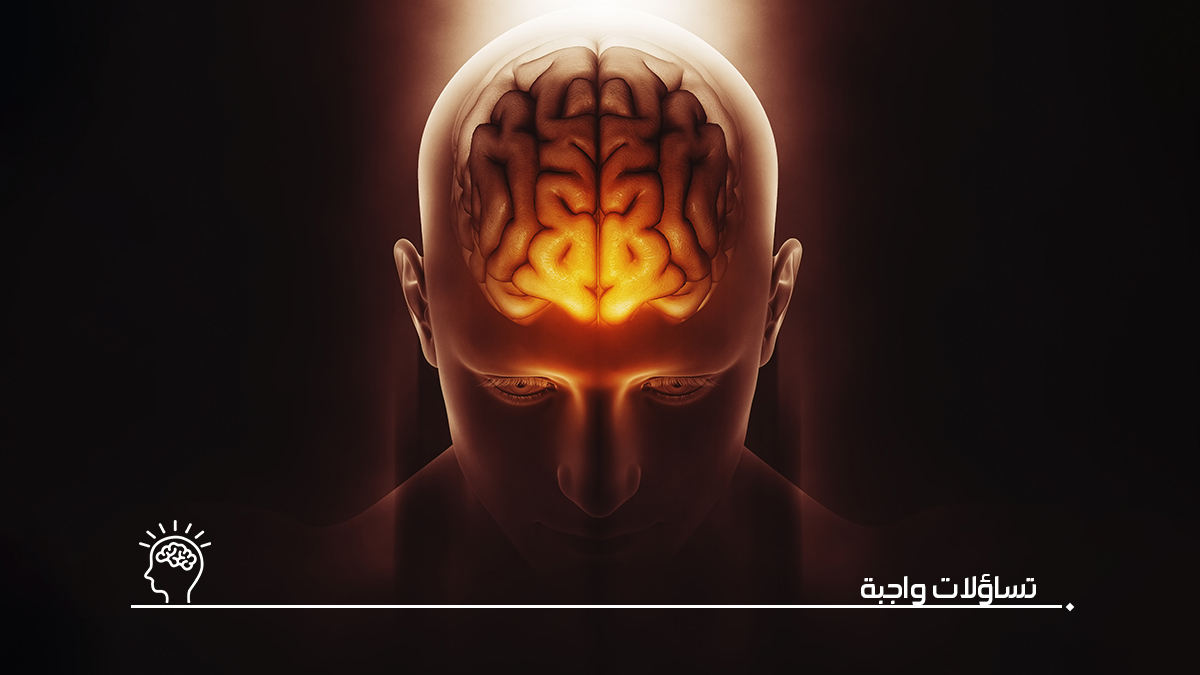
تساؤلات واجبة:
دوافع التضخيم في قدرات "ذاكرة العرب"
توجد حالة من التوافق حول التميز المذهل للعرب قديماً بذاكرة فولاذية تمكنهم من حفظ الشِّعر والسِّيَر والأنساب، وأن منهم كثيرين يمتازون بقدرة خرافية على الاستذكار وسرد الأحوال.. روايات كثيرة رسخت فكرة تفرد “ذاكرة العربي”، ما يعني أنها تخصهم وحدهم دون باقي شعوب الأرض، أو محاولة الإيحاء بتفردهم ذاك حتى لو لم يكن يدعم ذلك استنتاج علمي.
ودون أسباب واضحة، سُمِح لهذه الظاهرة أن تشمل غير العرب ممن دخلوا الإسلام، وفعلياً عاشت النخبة المسلمة حالة من المناطحة بين التدوين والشفاهية، تجلَّت هذه الحالة في ما يعرف بكتب “الأمالي”.
فهل كان رواج هذه الفكرة -الحفظ عن ظهر قلب لدى العربي- سبباً من أسباب دعم مصداقية المنسوب من أحاديث إلى رسول الله، استناداً إلى قدرة الحفظ عند العرب؟
ذاكرة تصويرية
تعدَّدت الروايات التي تسجل مواقف وأحداثاً تُظهر الذاكرة الخارقة لعديد من الشخصيات في تاريخ الإسلام، عرب وغير عرب، لكن يجتمعون في كونهم فقهاء أو كُتَّاب سِيَر أو مُحدثين.
أولاً، الحافظ.. لقب أو رتبة: في أرشيف “ملتقى أهل الحديث”، المتوفر بموقع “المكتبة الشاملة”، يورد تصنيفاً لدرجات المحدثين نقله المناوي، في “أوائل شرح الشمائل”، عن المطرزي: “لأهل الحديث مراتب: أولها: الطالب، وهو المبتدي. ثم المحدث، وهو من تحمل روايته واعتنى بدرايته. ثم الحافظ، وهو من حفظ مائة ألف حديث متناً وإسناداً. ثم الحُجَّة، وهو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث. ثم الحاكم، وهو مَن أحاط بجميع الأحاديث المروية”.
يشير هذا التصنيف التراتُبي إلى أهمية مهارة الحفظ، ليس فقط لوجود درجة أو رتبة يقال عنها “الحافظ”، وإنما لأن التنقل بين الرُّتَب قائم على كفاءة الحفظ.
ثانياً، الشافعي وموطأ مالك: يذكر الكاتب محمد حسان، في كتابه “سلسلة مصابيح الهدى”، أخبار رحلة الإمام الشافعي إلى المدينة ولقائه الإمام مالك، على لسان الشافعي: “ذهبت إلى رجل من أهل مكة علمت أنه يحوي عنده موطأ الإمام مالك، يقول: فذهبت إليه واستعرت منه الموطأ وعكفت عليه، فحفظت الموطأ عن ظهر قلب في تسع ليالٍ”.
وكتاب الموطَّأ يضم نحو ألفَي حديث في أقل قراءاته، وللموطأ عدة قراءات حسب تدوين تلاميذ الإمام مالك عنه، وهو يدقق وينقح في كتابه على مدار أربعين سنة.
يُكمل الشافعي: “فلما كان الغد أخذت الموطأ في يدي وجلست بين يدي شيخي مالك، وأخذت أقرأ عليه الموطأ من حفظي، وكلما نظرت إلى مالك وتهيبت مالكاً -وكان مالك قد أعجب ببلاغتي وقراءتي وحسن إعرابي- فكلما أردت أن أنهي القراءة في الموطأ نظر إليَّ مالك وقال: زِدْ يا فتى زد يا فتى زد يا فتى، حتى أنهيت الموطأ كله في أيامٍ يسيرة”.
تحوي الرواية اعتداداً لا ريب فيه بالذاكرة القوية، من استعراض القدرة الرهيبة على سرعة الحفظ وسعة الذاكرة.
ثالثاً، البخاري في بغداد: يُعد البخاري عُمدة المحدثين بلا منازع، وبالتالي كثُرت الروايات حول سعة ذاكرته؛ ففي كتاب “سير أعلام النبلاء”، يروي الإمام الذهبي، على لسان أبي أحمد عبد الله بن عدي الحافظ: “سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى مئة حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد هذا، وإسناد هذا المتن هذا، ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس، فاجتمع الناس، وانتدب أحدهم، فسأل البخاري عن حديث من عشرته، فقال: لا أعرفه. وسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه. وكذلك حتى فرغ من عشرته. فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض، ويقولون: الرجل فهم. ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعجز، ثم انتدب آخر، ففعل كما فعل الأول. والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم الثالث وإلى تمام العشرة أنفس، وهو لا يزيدهم على: لا أعرفه. فلما علم أنهم قد فرغوا، التفت إلى الأول منهم، فقال: أما حديثك الأول فكذا، والثاني كذا، والثالث كذا إلى العشرة، فرد كل متن إلى إسناده. وفعل بالآخرين مثل ذلك. فأقرّ له الناس بالحفظ. فكان ابن صاعد إذا ذكره يقول: الكبش النطاح”.
من هذا السياق، بخلاف التحدي الرهيب وقدرات البخاري الفائقة، يُفهم أن الحفظ كان أحد أهم مقاييس الكفاءة العلمية في ذلك العصر، سواء كانت الرواية دقيقة أو غير دقيقة، فهذا لا يغير من أهمية الحفظ وقتها(!).
تساؤلات واجبة
تتعدد التساؤلات بخصوص مسألة “القدرة على الحفظ”، وأهميتها في نقل المرويات، من أحداث وأحاديث:
ـ هل هذه القدرات الذهنية المتعلقة بالذاكرة، حقيقية تماماً أم تعرضت لشيء من التضخيم والتهويل؟
ـ هل هذه السُّمعة أو الصورة المتخيَّلة عن ذاكرة كل ما هو عربي مسلم، كانت المدخل لاعتماد الأحاديث المنسوبة للنبي باعتبارها أحد مصادر التشريع؟ رغم أن العمل على جمعها بشكل رسمي كان بأمر من الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (681-720م)، أي بعد وفاة النبي بأكثر من ثمانين عاماً. هذا، فضلاً عن أن أول كتاب وضِع فيها هو “الموطأ” للإمام مالك (711-795م)، الذي وضعه بناءً عن طلب من ثاني خلفاء بني العباس، أبي جعفر المنصور، الذي تولى السلطة عام 754م، أي بعد وفاة النبي بأكثر من قرن.
ـ هل فعلاً الرجوع إلى كتب السِّيَر وروايات معاصري الأحداث التاريخية البارزة عند العرب، يضمن الوصول إلى رواية واحدة متماسكة، بوصفها نتيجة متوقعة لهذه الذاكرة الخارقة، التي احتفظت بأحاديث عادية -لا نَظْم فيها ولا قافية- وتوارثتها أجيال، حتى جاء البخاري (810-870م)، بعد قرنين من وفاة النبي ليجدها محفورة في الذاكرة العربية الفريدة ليجمعها؟
اختلاف الروايات
بالرجوع إلى كتب السِّيَر، التي وضعها المؤرخون المسلمون بعد انتشار الإسلام، نجدها تعتمد على روايات تناقلت شفاهياً عبر أجيال إلى أن جرى تدوينها، وقد عمد كَتَبة السِّيَر إلى ذكر مصدر كل رواية ومصادر كل مصدر بالترتيب، فيما يُعرف بالعَنْعَنة، الأمر الذي مكَّن المُحدثين والمُدققين من تضعيف روايات والاطمئنان لأخرى، بناءً على تتبع خط الرواية وتناقُله بين الرواة، والبحث في مدى علاقة هؤلاء الرواة ببعضهم، وهل هم أشخاص ثقات أم لا، في ما يُعرف بـ”السند”.
وهذا يعني أن الروايات المجموعة غير موحَّدة، كما يمكن أن يُتَصوَّر عن “فوتوغرافية” ذاكرة العرب، ما يعني بدوره أن هذه الذاكرة الفريدة ليست مُعمَّمة في كل العرب، لكن إلى أي مدى يمكن أن يصل الاختلاف بين الروايات؟
أولاً، مولد النبي: في القرن السادس عشر، وضع المؤرخ الصالحي الشامي، في الجزء الأول من كتابه “سُبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد”، فصلاً بعنوان “في وفاة عبد الله بن عبد المطلب”، رصد فيه عدة روايات عن وقت وفاة عبد الله بن عبد المطلب، والد النبي، بالنسبة لعُمر النبي وقت الوفاة.
فقال إن ابن إسحاق والواقدي والبلاذري وابن قيم الجوزية والذهبي وغيرهم اتفقوا على أنه مات خلال فترة الحَمل، لكنه قدم آراء أخرى تقول إن النبي “كان في المَهد حين تُوفى أبوه”؛ وتفاوتت تلك الآراء “فقيل ولَهُ شهران. وقيل ثمانية وعشرون شهراً. وقيل تسعة أشهر، ونقل السهيلي عن الدولابي أنه قول الأكثرين، قلت والحق أنه رأي كثيرين لا أكثرين”.
وهنا، لا تسعفنا الذاكرة العربية في تحديد زمني “دقيق” لواقعة وفاة والد أهم شخصية في التاريخ الإسلامي قاطبة، إنما يمكن من رصد مختلف الروايات الوصول إلى فترة تقديرية، قدرُها نحو ثلاثة أعوام، وهو تراوح مقبول في ظل الاعتماد على الذاكرة بلا تدوين.
ثانياً، عُمر حمزة: في المجلد الأول من “الطبقات الكُبرى”، نجد قصة زواج والدَي النبي، عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب: “كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب في حجر عمّها وُهيب بن عبد منَاف بن زهرة، فمشى إليه عبد المطّلب بن هاشم بن عبد منَاف بن قُصيّ بابنه عبد اللَّه بن عبد الطلب أبي رسول اللَّه، فخطب عليه آمنة بنت وهب فزوّجها عبد اللَّه بن عبد المطّلب، وخطب إليه عبد المطّلب بن هاشم في مجلسه ذلك ابنته هالة بنت وُهيب على نفسه فزوّجه إيّاها، فكان تَزَوّجُ عبد المطّلب بن هاشم وتزوّج عبد اللَّه بن عبد المطّلب في مجلس واحد، فولدت هالة بنت وهيب لعبد المطّلب حمزة بن عبد المطلّب، فكان حمزة عمّ رسول اللَّه في النّسب وأخاه من الرّضاعة”.
وهكذا نعرف كيف تزوّج والدي النبي، وكذلك نعرف عن ميلاد حمزة بن عبد المطلب. ثم في موقع آخر بنفس المصدر، نعرف عن واقعة استشهاد حمزة يوم أُحُد، فيقول المصدر: “قُتِلَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، يَوْمَ أُحُدٍ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْنِ وَثَلاثِينَ شَهْراً مِنَ الْهِجْرَةِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً، كَانَ أَسَنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ”.
يظهر، هنا، تضارب واضح بين الروايات، فمن المستحيل أن تصح رواية زواج الأب والابن في نفس اليوم، ورواية وفاة عبد الله بعد الزواج بقليل، مع تقدير عُمر حمزة؛ وبالتالي، لا بد أن إحدى هذه الروايات خاطئة، لكن حجم الخطأ، وبداهته، يدعو للتساؤل حول مدى دقة عملية الجمع وعنايتها بالتفاصيل.
ثالثاً، زواج النبي من خديجة: حدث آخر شديد الأهمية في تاريخ الإسلام، وهو زواج النبي من السيدة خديجة بنت خويلد، وبالبحث عنه في كتاب “محمد” للكاتب محمد رضا، نجده ضمن روايات مختلفة للواقعة.
الرواية الأولى، تقول: إن عمَّها عمرو بن أسد هو من زوَّجها؛ لأن أباها مات قبل ذلك بنحو عشر سنين، “من حديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ومن حديث ابن أبي حبيبة عن داوود عن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: أن عمها بن أسد زوَّجها رسول الله وأن أباها (خويلد بن أسد) مات قبل الفجار”.
والرواية الثانية، تقول: “ويقولون أيضاً إن خديجة أرسلت إلى النبي تدعوه إلى نفسها، تعني التزويج، وكانت امرأة ذات شرف، وكان كل قريش حريصاً على نكاحها، وقد بذلوا الأموال لو طمعوا بذلك، فدعت أباها فسقته خمراً حتى ثمل ونحرت بقرة وخلقته بخلوق وألبسته حلة حبرة، ثم أرسلت إلى رسول الله في عمومته فدخلوا عليه فزوّجه. فلما صحا قال: ما هذا العقير وما هذا العبير وما هذا أكابر قريش فلم أفعل”.
اللافت هنا في هذا التضارب الكبير بين الروايتين أن مرجعهما هو الواقدي، ما يعني أن كُتَّاب السِّير -ولو لمرحلة- اعتمدوا منهج تسجيل كل ما يسمعونه، بصرف النظر عن مدى دقته أو تضاربه مع غيره من روايات.
وختاماً، بتأمل الصورة الكاملة، وما جاء في كُتُب السِّيَر من تفاوت كبير بين الروايات لنفس الحدث، تصبح مصداقية تفرُّد الذاكرة العربية محلَّ شك، خصوصاً أنها في أعلى تجلياتها كانت خارج العرب، البخاري من مدينة بخارى بإقليم أوزبكستان حالياً.
في ضوء هذا التفاوت الكبير في الروايات ومدى تضاربها معاً، هل نلقي التراث العربي برمته ولا نلتفت إليه؟ الإجابة بالطبع لا. لكن السؤال الذي يحتاج إلى توقف ومحاولة الرد عليه بشكل موضوعي: هل يمكن الاعتماد على هذا التراث في استنباط أحكام شرعية تسيّر أمور المسلمين على مر الزمان؟ وهل يمكن اعتماد هذه الروايات بوصفها مادة “مُكمِّلة” لدين الله وتمثل ثلاثة أرباعه عند بعض كبار رجال الدين، حتى وإن كان هذا بمساعدة التدقيق في سِير الرواة أنفسهم “التي جُمعت بدورها اعتماداً على نفس الذاكرة”؟
أظن أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.