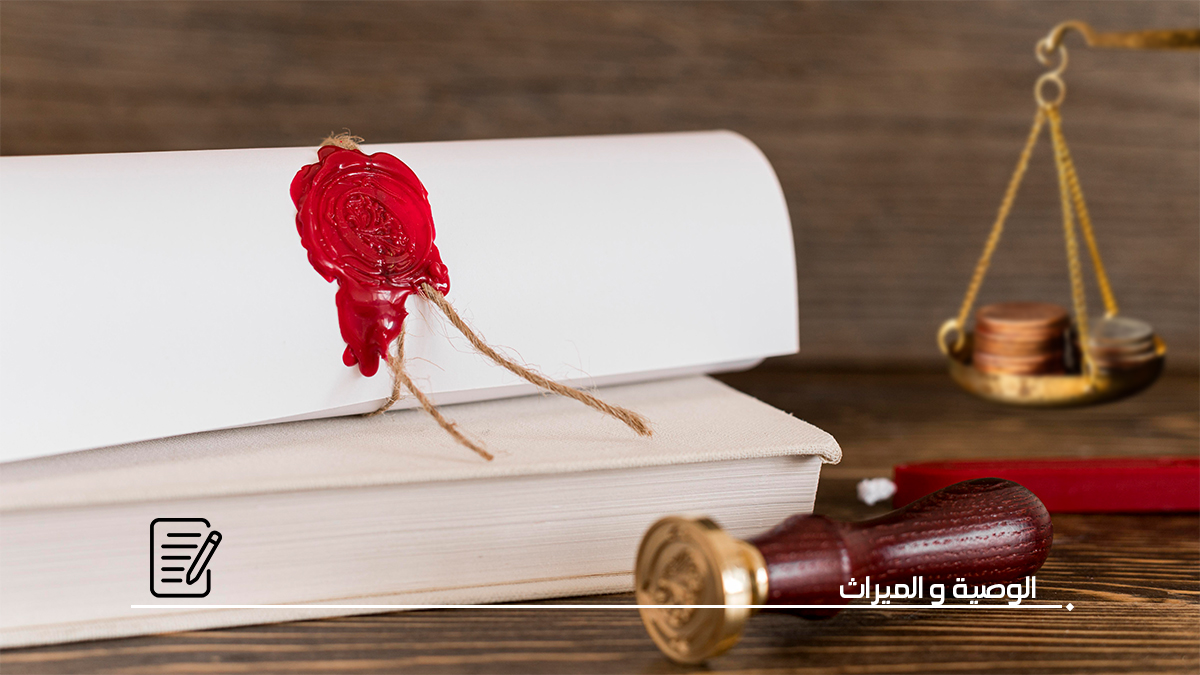
الوصية والميراث:
إشكالية الروايات في تحجيم "حكم الوصية"
تُعرف أحكام المواريث في الإسلام من خلال مجموعة من الآيات نزلت متفرقة بين أكثر من سورة، منها: البقرة، الأنفال، الأحزاب، النساء.
آيات متعددة فصّلت الأمر من عدة جوانب، وفيها استدراك لما لم يسبق ذكره، مثل حالة “تركة الكلالة” في سورة النساء (الآية: 176).. رغم ذلك، لا يخلو الأمر من تخبُّط وارتباك في بعض حالات الميراث، إحدى هذه الحالات أن يوصي صاحب التركة بشيء من تركته قبل الوفاة.
فما موقف الشرع من الوصية؟ وأين تكمن الأزمة؟
مفهوم الوصية
ذُكرت الوصية الخاصة بالترِكات “سبع” مرات على مدار خمس آيات موزعة على ثلاث سور؛ البقرة (180 و240)، النساء (11 و12)، المائدة (106)، ما بين تأكيد أهمية الوصية وتوضيح شروطها، وبين وضع قواعد تقسيم التركة، بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية، إنْ وجِدا.
أولاً، الأمر بالوصية: في سورة البقرة، يقول سبحانه وتعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡراً ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقاً عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]. وتلاحظ صيغة الأمر المُشددة والمُستخدمة في ما يخص أوامر الله للمسلمين، كما في قوله “كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ”، وهي تماماً مثل قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾.
وفي نفس السورة، البقرة، يقول سبحانه: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجَاً وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعاً إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾ [البقرة: 240]. في هذه الآية يدعو الله الأزواج أن يوصوا لزوجاتهم بالحق في البقاء بمنزل الزوجية لمدة عام كامل، قبل أن يتحول إلى جزء من التركة قابلٍ للتقسيم؛ وبالتالي احتمال إجبار الزوجة على أن تخرج منه. ويظهر من الصيغة أن هذا الأمر غير مُلزِم كسابقه.
ثانياً، تقعيد الوصية: في سورة المائدة، يقول عزَّ من قائل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ﴾ [المائدة: 106].
وهنا، يضع الشارِع للمؤمنين قواعد كتابة الوصية، فيحدد أن يشهد عليها شاهدان “منكم/مسلمان.. ذوا عدل”، وإن لم يتوافر، لأسباب منها السفر مثلاً شهود “منكم/مسلمون” يمكن الاستعانة بشاهدَيْن من غير المسلمين، “غيركم”؛ واختتم الآية بتأكيد أهمية الشهادة وضرورة إتيانها، ومَن يفعل غير ذلك فهو آثم.
ثالثاً، دور الوصية: في سورة النساء، يقول عزَّ وجل: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾ [النساء: 11].
وبالتالي، يضع الشارِع قواعد تقسيم الترِكة بين المُستحقين في عِدة حالات؛ فيوضح نصيب أبناء المتوفَّى ووالديه وإخوته؛ لكنه في نهاية التشريع يوضح أن يجري تفعيل هذه القواعد بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية، حال وجودهما.
وفي نفس السورة، النساء، يقول تبارك وتعالى: ﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ﴾ [النساء: 12].
وعبر هذه الآية الكريمة، يوضح الشارِع عدة حالات أخرى في تقسيم التركة، عن نصيب الأزواج في مختلف الحالات؛ لكنه أيضاً يؤكد أهمية أن يحدث هذا في ما تبقى من التركة بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية، ويختم النص بتوضيح أن ذلك “وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ” لعباده.
تحجيم الوصية
ورد في السُّنة النبوية حديث منسوب للنبي بروايتين مختلفتين، أحدهما برواية أبي أمامة الباهلي والمحدث أبي داوود، والثاني برواية عمرو بن خارجة والمحدث ابن حجر العسقلاني، ويتفق النصان على جملة: “إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ”.
وبسبب هذا النص اختلف الفقهاء بين جواز التوصية لمُستحق الميراث، وبين رفض ذلك.
أولاً، نص الحديثين: من حيث النص الأول للحديث، فهو: “سَمِعتُ رسولَ اللهِ يقولُ في خُطبتِه عامَ حجَّةِ الوَداع: إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وصيَّةَ لوارثٍ” (الراوي: أبو أمامة الباهلي، المصدر: سُنن أبي داوود، حُكم المُحدث: سَكَت عنه “وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح”).
ومن اللافت، هنا، أن الراوي يقول إنه سمعه من النبي خلال خطبته في حجة الوداع، وبالتالي من المفترض أنه سمعه مئات من الصحابة، على أقل تقدير.
أما عن النص الآخر للحديث، فهو: “عن عمرو بن خارجة: كنتُ آخذاً بزمامِ ناقةِ رسولِ اللَّهِ عليهِ الصلَّاة والسلَّامَ، ولعابُها يسيلُ على كتفيَّ، فقالَ: ألا إنَّ اللَّهَ قد أعطى لكلِّ ذي حقٍّ حقَّهُ، ألا إنَّهُ لا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ، والولدُ للفراشِ، وللعاهرِ الحجَرُ ومن ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو انتَمى إلى غيرِ مواليهِ، فعليهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكَةِ والنَّاسِ أجمعينَ، لا يقبلُ اللَّهُ منهُ صرفاً ولا عَدلاً” (الراوي: عمرو بن خارجة، المُحدث: ابن حجر العسقلاني، خلاصة حُكم المحدث: حسن).
ويبدو الأمر أشبه بتداخُل حديثين معاً، أو جزء من إعادة النبي ذكر عدد من الأحكام دفعة واحدة، فقوله: “الولد للفراش وللعاهر الحجر” يعود إلى واقعة تحكيمه بين سعد بن أبي وقاص وبين عَبْد بن زَمْعَةَ، وهي تخص خلافهما حول نسب غلام، ولا عَلاقة لها بتقسيم تركة.
ثانياً، عمق الإشكالية: يقول الإمامُ مالك وابنُ رُشد وابنُ تَيميَّة بعدم شرعية الوصية لوارث، بينما يقول أتباع المذهب الحنفي والمذهب الظاهري بإمكانية التوصية لوارث. لكن بشكل عام، فإن الانقسام حول شرعية الوصية لوارث من عدمه، يذهب إلى أبعد من حق الإنسان في تقسيم تركته وحق الورثة في ما يتركه ذووهم، فهو يمتد ليمس منطقة شديدة الحساسية في الفقه الإسلامي، وهي قضية النَّسخ في القرآن.
فالنص القرآني [البقرة: 180]، يحمل أمراً مباشراً، “كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ”، من الخالق لعباده بالوصية للوالدين والأقربين، بينما النهي عن التوصية للوارث جاء عبر حديث منسوب للنبي؛ وبالتالي، فالأزمة منبعها هو الاتفاق والاختلاف حول إجابة سؤالين:
- هل يوجد نسخ في القرآن؟.. وهو سؤال انقسم حوله جمهور الفقهاء، فإذا نظرنا للقائلين بالنسخ سنجدهم منقسمين حول عدم شرعية الوصية لوارث؛ لأنهم بالأساس مختلفون حول إجابة السؤال الثاني.
- هل السُّنَّة تنسخ القرآن؟.. وهو سؤال الإجابة عنه بالإيجاب تفتح الباب على مصراعيه لإعادة تشكيل الإسلام بالكامل على يد المحدِّثين.
وختاماً، بعيداً عن اتفاق الفقهاء أو اختلافهم حول حق الوارث في الوصية، نجد أن الجميع متفقون على حق الإنسان العاقل الراشد في التصرف في أمواله كيفما شاء؛ ومن ثم، وبحسب قواعد العصر الحالي، يستطيع صاحب المال تخصيص ما يريد من ماله إلى من يريد من ذويه.
فحتى في حال عدم أحقية الوارث في الوصية، يستطيع صاحب المال أن ينقل ملكية ما يريد تخصيصه إلى الوارث بصيغ قانونية أخرى، الهِبة أو التنازل أو البيع.. إلخ. وعليه، فإن الأزمة الحقيقية في الأمر هي الاتفاق والاختلاف حول المُنطلَقات، وهي في هذه الحالة سؤال واضح لا لبس فيه: هل ظنِّي الثبوت (السُّنة) “ينسخ/يلغي” قطعي الثبوت (القرآن)؟
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.