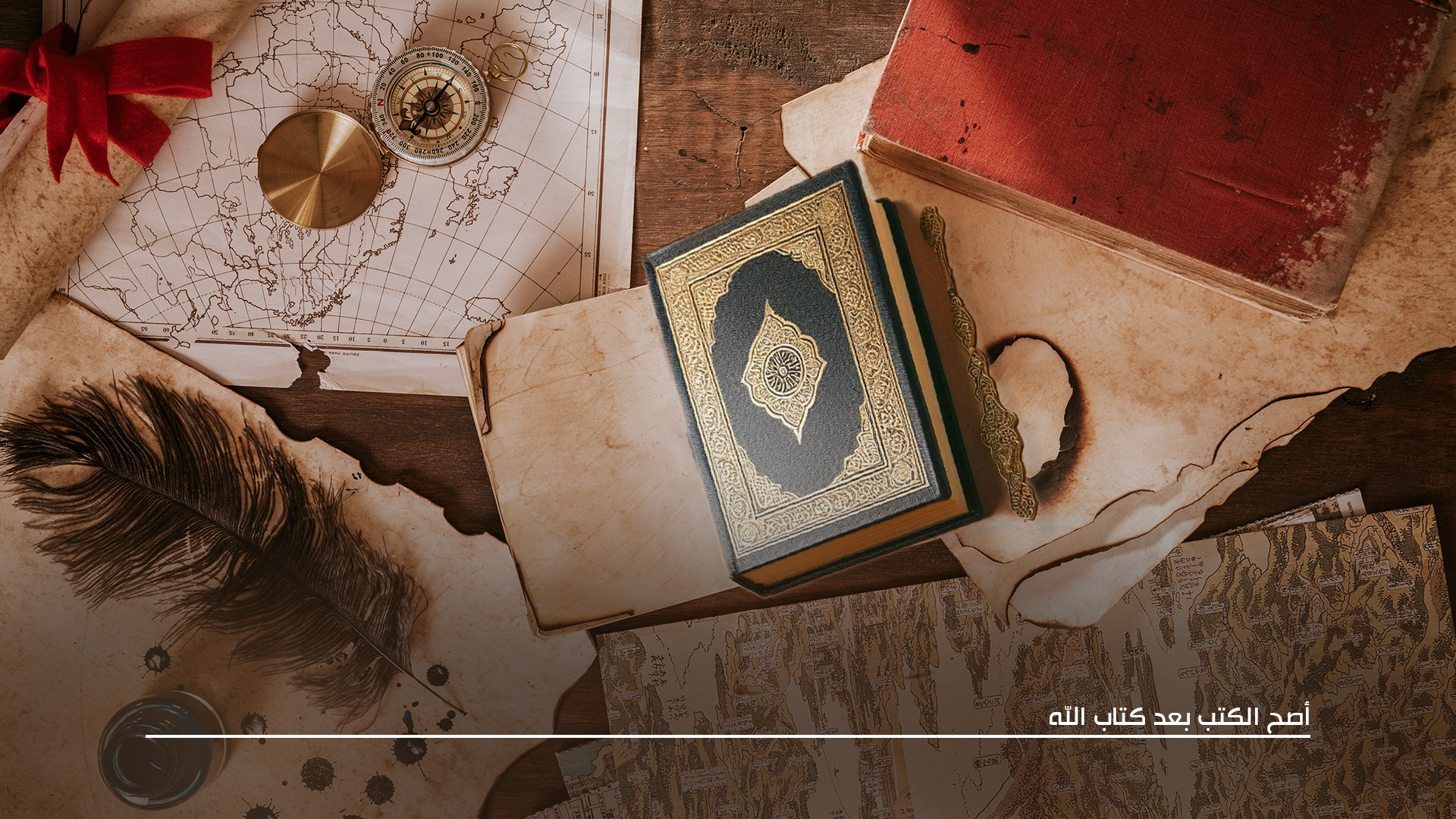
"الكتاب الصحيح":
هل أُغلق باب الاجتهاد بعد البخاري؟
كَثُرت مقولات بعض علماء المسلمين وتواتَرَت عن كتاب “صحيح البخاري”، أحد الكتب التي جمعت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بأنه “أصح كتاب بعد القرآن الكريم”، ورفع بعضهم درجة “صحيح البخاري”، والبخاري، إلى مرتبة مقدسة يصح معها -وهي مغالاة نادرة- القَسَم باسمه. فما آراء العلماء القائلين بذلك؟ وما الآراء المغايرة؟ وهل يُغلق رفع مرتبة “الصحيح” إلى درجة المقدس بابَ الاجتهاد على إطلاقه؟ وهل يجوز أن يوجد ما يقال عنه “أصح كتاب”؟
مدخل تاريخي
بدأت عملية جمع الحديث وترتيبه وتصنيفه في منتصف القرن الثاني الهجري تقريباً، وانتشرت حركة تدوين الحديث في عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد؛ إذ ظهرت كتب السُّنن والمسانيد والجوامع والمُوَطَّآت، حتى القرن الثالث الهجري، حين ظهرت كُتب “الصِّحاح”، كالبخاري، ومسلم، وابن حنبل، وأبي حاتم الرازي، وابن المديني، ويحيى بن معين.. وغيرهم؛ فقد بدأت مرحلة التصنيف والترتيب حسب المواضيع الفقهية أو حسب الراوي.
واستمرت عملية جمع وتدوين الحديث، وتصنيفه وترتيبه، حتى نهاية القرن الخامس الهجري، ثم انتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة «نقد الحديث» تصحيحاً وتضعيفاً، ونقد رجاله تجريحاً وتعديلاً، وتناول المتن شرحاً وانتخاباً، لما جمعه الأولون من مؤلفات في القرون الخمسة الأولى؛ فجمعوا شتات الأقوال النقدية حول الحديث المروي عند الأولين، من تعليل للمتن، وتجريح وتعديل للرواة، ووصل وإرسال وانقطاع للسند. فنتج عن ذلك أن أكثروا من كتب مصطلح الحديث، التي رتّبوا فيها الحديث وهذّبوه وتناولوه بالشروحات.
آراء العلماء
ظهر العديد من الآراء التي تؤكد مقولة “أصح كتاب”:
1- رأي الإسفراييني: يقول الفقيه الشافعي أبو إسحق الإسفراييني، إن “أهل الصنعة مُجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونِها، ولا يحصل الخلاف فيها بِحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتِها”؛ ثم أضاف قائلاً: “فمن خالف حُكمُه خبراً منها، وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه؛ لأنَّ هذه الأخبار تلقَّتها الأمة بالقبول”.
ولا يُعلم على وجه الدقة أي أمة يقصد أبو إسحق، وأي زمن لأي أمة؛ فما كان مقبولاً قبل عشرة قرون، هل من المضمون القطع بأن يظل مقبولاً زماناً ومكاناً بعدها؟ ثم إن لغة “القطع” و”الإجماع” هذه تتناقض بالتأكيد، وتقطع الطريق، أمام أي اجتهاد جديد في طريق المسلمين، إذا ما اتفقنا على أن الاجتهاد بابه مفتوح.
2- رأي الإمام النووي: يقول الإمام النووي إن العلماء قد اتفقوا على أنَّ “أصحَّ الكُتب بعد القرآن الكريم هما الصحيحان، صحيح البُخاري، وصحيح مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحُّهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة”.
ويبدو أن أحكام الصحة المطلقة في التوصيفات المستخدمة، تصب في الإطار المقدس ذاته، وتدعو من جانب إلى غلق باب الاجتهاد؛ فماذا سيكون أمام أي مجتهد ليضيفه أمام توصيف “أصح كتاب” بعد كتاب الخالق الأعظم (؟!).
3- رأي ابن تيمية: يذهب ابن تيمية إلى عدم وجود كتاب تحت أديم السماء، حسب قوله، “أصح من كتابَي البخاري ومسلم بعد القرآن”.
4- رأي الحافظ ابن كثير: يقول الحافظ ابن كثير إن “كتاب البُخاريِّ الصَّحيح أجمعَ على قَبُولِه وصِحَّةِ ما فيه أهلُ الإسلام”.
5- رأي الإمام الذهبي: يذهب الإمام الذهبي إلى أن جامع البُخاريِّ الصَّحيح هو “أجَل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى”.
استنتاجات منطقية
أولاً، هل يجوز أصلاً أن يوجد ما يقال عنه “أصح كتاب”؟ وما معيار الصحة المطلقة هذه؟ فكل مسلم يعلم أن الكتاب المقدس المجمَع عليه هو القرآن الكريم، كلام الله، وما عداه فهو نتاج بشري لا يرقى إلى مصاف كلام الله في كتابه العزيز، وأن مصدر التشريع الأول في الأحكام والأوامر والنواهي والإرشادات الروحية والخُلُقية هو القرآن الكريم.
ثانياً، أليس رفع مرتبة غير المقدس إلى درجة المقدس، درجة من درجات الشرك عند جمهور العلماء من المسلمين؟ فتعامل المسلمين مع كتب المسانيد والصحاح من منظور تلك القداسة، يجعلهم ينظرون إلى تلك الأقوال والمرويّات على أنها حكم شرعي قاطع من الله، بجعلها في مصاف الوحي القرآني.
ثالثاً، بدأ جمع الأحاديث ثم تصنيفها وتبويبها، بعد انقضاء مئة عام وأكثر على وفاة النبي؛ فما هي درجة الدقة والإحكام في تتبع الروايات المتواترة شفاهة بعد مئة عام، في زمن لم تكن فيه أدوات التوثيق على ما هي عليه في عصرنا؛ وحتى في عصرنا، هل نملك توثيقاً محكماً لحدث ما مر عليه مئة عام قبل الآن؟
رابعاً، يذهب الدكتور محمد شحرور إلى أن قول بعضهم بأن ما كان يقوم به النبي هو وحي كله، استناداً إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٭ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3-4]، لا مسوغ له البتة هنا؛ فالضمير “هو” لا يعود إلى النبي، وإنما يعود بوضوح وحصراً إلى الكتاب المنزل ولا علاقة للضمير هنا بالضمير قبله المستتر في الفعل “ينطق” العائد على النبي، الذي كان من صفاته أنه لم يكن ليتحكم فيه وفي أقواله وفي أفعاله الهوى وتقلبات النفس؛ الأمر الذي يجعله في مرتبة رفيعة حقاً، وهي مرتبة النبوة، لكن دون أن يجعل ذلك أقوال وأفعال النبي كلها من صنف الوحي على كل حال.. فما بال القائلين بأن “صحيح البخاري”، هو “أصح كتاب بعد كتاب الله” (؟!).
خامساً، إن النبي والصحابة لم يعتبروا في وقت من الأوقات أن الأحاديث النبوية وحياً، فالنبي من جهته لم يأمر بجمعها كما فعل مع الوحي “الكتاب”؛ وكذلك الأمر مع الخلفاء الراشدين، فهم قد فهموا أنها كانت نتيجة تعامل مع واقع معين في ظروف معينة عاشها النبي.
سادساً، تذهب فئة من العلماء إلى أن النبي لم يأمر بجمع كلامه وتدوينه، لتجنب الاختلاط بين الوحي والحديث، وهذه حجة واهية.. فالنبي أول من يعلم بقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ [الحجر: 9]؛ ثم، إن ذلك كان سيُستبعد بخطوة إجرائية بسيطة، وهي تخصيص بعض الكَتَبة للوحي وبعضهم الآخر للحديث.
سابعاً، لماذا لم يجمع الصحابة الحديث كما جمعوا القرآن، علماً بأن الأحاديث النبوية حول الحدود والعبادات والأخلاق قد انتقلت إلينا بالتواتر.
فإذا كان النبي لم يفعل ذلك بنفسه، ولم يفعله الصحابة من بعده، فذلك لسبب واحد، وهو علمهم بأن جمعه “ليس ضرورياً، وأن الحديث مرحلة تاريخية”، حسبما يرى الدكتور شحرور، وأن “السُّنة ليست عين كلام النبي، وإلا فما معنى آية ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾ [المائدة: 3]؟ وكيف أكمل الدين والحديث لم يُدوَّن؟”.
ويضيف شحرور أن عدم أمر النبي بجمع كلامه وتدوينه، وأمره بكتابة الوحي وحرصه المطلق على ذلك، هو والصحابة، يقود إلى فهم عميق لفرق أساسي بين النبوة وتصرفات النبي وكلامه، فكلامه وتصرفاته هما نتاج تاريخي يحمل طابع المرحلية؛ وبالتالي، فإن الواقع سيتجاوزه مع تطور الحياة في سياق الزمن.
ختاماً، فإن مثل مقولات “أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري”، أو أي كتاب آخر، يغلق باب الاجتهاد في وجه علماء المسلمين وعامّتهم، اعتماداً على مرويات بدأ جمعها بعد مئة عام أو يزيد من وفاة النبي، وانتهت في القرن الخامس الهجري؛ والرفع إلى درجة القداسة لا يحِق إلا لكتاب الله “القرآن الكريم”، الذي هو تبيانٌ لكل شيء، ولا يحتاج إلى نص مكمّل حتى يُتِم للمسلمين دينهم.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.