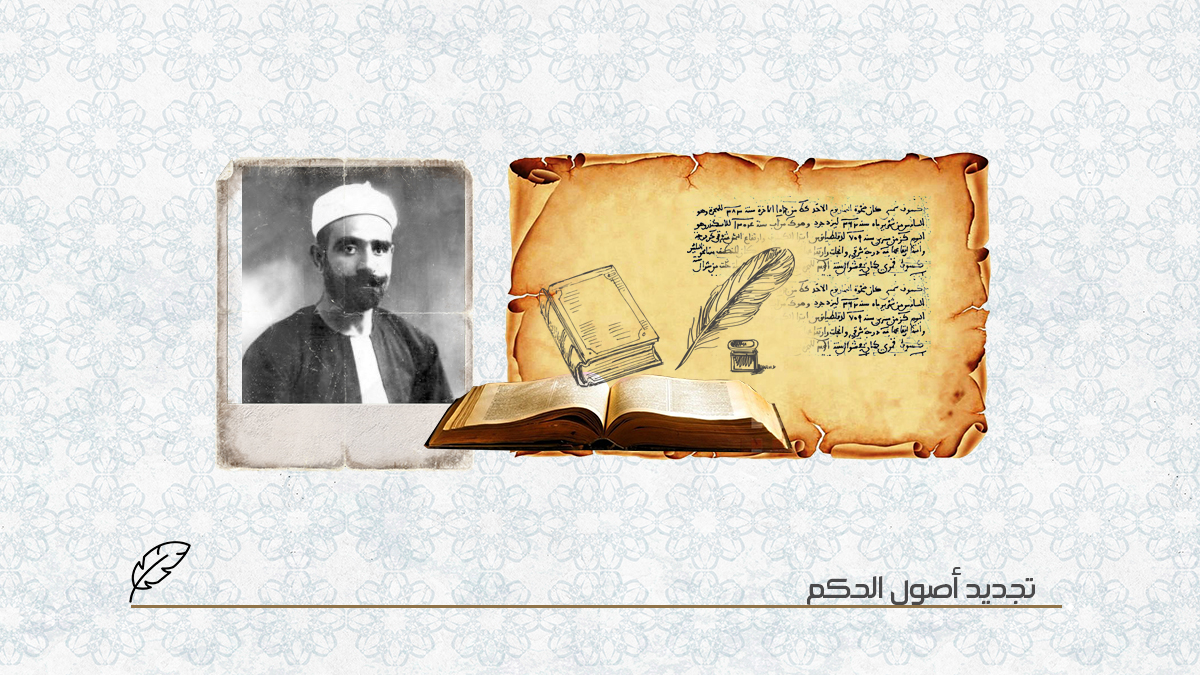
الخلافة الإسلامية:
علي عبد الرازق وتجديد أصول الحكم
الخلافة الإسلامية مصطلح حظي بقدسية منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان السبب فيها فهم بعض النصوص الدينية بطريقة مُعينة، وتوظيف السلطة السياسية التاريخية لهذا الفهم؛ وهو الأمر الذي تناوله الشيخ الأزهري علي عبد الرازق، في كتابه “الإسلام وأصول الحكم.. بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام”، الذي أثار ضجة بتناوله المُغاير لكل ما نُشر في التراث الإسلامي عن الخلافة ووجوبها وشروطها.
وصدر الكتاب، في عام 1925م، بعد أقل من عام على قرار إلغاء الخلافة العثمانية، ليُصبح العالم الإسلام دون مسمى خليفة منذ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؛ متزامناً مع محاولات لإعادة تسمية الخلافة في مصر، التي تزعمها عدد من شيوخ الأزهر وقتها، وبمباركة فؤاد الأول سلطان مصر آنذاك.. فجاء كتاب “الإسلام وأصول الحكم”، الذي نادى بمدنية الدولة، وذهب إلى أن منصب الخليفة منصب سياسي لا علاقة له بالدين، ما أثار معارك وقتها وتسبب في محاكمة المؤلف وفصله من زمرة علماء الأزهر، وإبعاده عن منصبه كقاضٍ شرعي.
مفهوم الخلافة
1- الخلافة لغة واصطلاحاً: يُعرِّف الكتاب مصطلح الخلافة، من الناحية اللغوية، بأنها: “مصدر تخلّف فلانٌ فلاناً إذا تأخّر عنه، وإذا جاء خلف آخر، وإذا قام مقامه. ويُقال خلف فلانٌ فلاناً إذا قام بالأمر عنه، إمّا معه وإمّا بعده”. وهو التعريف الذي اجتمع عليه اللغويون وتوافقت عليه معاجم اللغة العربية؛ ويُرْجِع اصطلاح الخلافة إلى أكثر التعريفات اتفاقاً بين المسلمين، متقدمهم ومتأخرهم، فهي: “رياسة عامّة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم”، وهو ما درج عليه المعرفون دون تدقيق في صحته اصطلاحاً.
2- التسمية الصحيحة للخليفة: يتعرض الكاتب لمسألة خلافية في تسمية الخليفة، هل هو الخليفة مطلقاً دون إسناد إليه، أو خليفة رسول الله، أو خليفة الله: “وأمّا تسميته خليفة، فلكونه يخلف النبيّ في أمّته فيقال خليفة بإطلاق، وخليفة رسول الله، واختُلف في تسميته خليفة الله، فأجازه بعضهم ومنع الجمهور منه، وقد نهى أبو بكرٍ عن ذلك لمّا دُعي به”؛ لافتاً إلى إجماع الجمهور على أن “محل الخليفة بين المسلمين كمحلّ رسول الله، له الولاية الخاصّة والعامّة، وتجب طاعته ظاهراً وباطناً”.
3- مصدر سلطة الخليفة: أوضح “عبد الرازق” أن مصدر سلطة الخليفة، لدى المسلمين، التنوع بين مذهبين: الأول، شائع منتشر بينهم؛ وهو “يستمد الخليفة سلطانه من الله”؛ والثاني، نزع إليه ثلة قليلة من بعض العلماء، لا سيما العلماء الذين لديهم نزوع نحو الاتجاه العقلاني؛ ويرى أن “الأمة مصدر سلطان الخليفة وهي التي تختاره”.
حكم الخلافة
يذهب المؤلف إلى أن فقهاء الإسلام تناولوا مسألة الخلافة بشكل نهائي، دون استعراض الأدلة والأسباب، ودون بحث أو إجابة على أسئلة بديهية.
1- مصدر قوة الخليفة: ينتقد الكتاب ما اتفق عليه المسلمون سابقاً من وجوب الخلافة، سواء كان وجوباً شرعياً أو عقلياً، حتى اُعتُبر من خالف الوجوب قد شذ عن الإجماع، عارضاً لأدلة العلماء على هذا الإجماع؛ ومنها: إجماع الصحابة على اختيار الخليفة عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومبادرتهم لبيعة أبي بكر، ثم تأكيدهم على وجود الإمام كأمر يتوقف عليه “إظهار الشعائر الدينية وصلاح الرعية”.
وينتقد الشيخ الأدلة السابقة؛ فوجوب الخلافة أمر لم يرد في القرآن الكريم، وإنهم عندما حاولوا إيجاد دليل من القرآن على وجوب ما سبق، فـ”أعجزهم أن يجدوا في كتاب الله تعالى حجة لرأيهم، فانصرفوا عنه إلى ما رأيت من دعوى الإجماع تارة، ومن الالتجاء إلى أقيسة المنطق وأحكام العقل تارة أخرى”.
2- إهمال السُّنَّة للخلافة: أشار الكتاب إلى إهمال القرآن الكريم لمسألة الخلافة، وكذلك السُّنَّة تركت الخلافة ولم تتعرض لها؛ فـ”العلماء لم يستطيعوا أن يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث، ولو وجدوا لهم في الحديث دليلاً لقدموه على الإجماع”، مؤكداً بأن: “الكتاب الكريم تنزه عن ذكر الخلافة والإشارة إليها، وكذلك السنة النبوية قد أهملتها، والإجماع لم ينعقد عليها”.
3- الخلافة والشعائر الدينية: ينفي المؤلف أهمية الخلافة لإقامة الشعائر الدينية، لافتاً إلى أن العلماء خلطوا بين مصطلح الحكومة التي تدير شؤون الناس أياً كان نوعها، وبين الخلافة المحددة في الإسلام؛ فالحكومة بأي شكل ومن أي نوع، تتيح تدبير شؤون الرعية وعبادتهم، مستشهداً بأدلة تاريخية نقلها ابن خلدون في مقدمته: “ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم وتلاشي أحوالهم، وبقي الأمر ملكاً بحتاً ليس للخليفة منه شيء”.
حقيقة الخلافة
1- الخلافة ليست من الإسلام: يشدد “عبد الرازق” على أن الخلافة ليست من الإسلام في شيء، فلا القرآن ولا السنة بها ما يؤكد ضرورة وجوب الخلافة، ذاكراً: “كل ما جرى من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر الإمامة والخلافة والبيعة.. إلخ، لا يدلّ على شيء أكثر ممّا دلّ عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعيّة عن حكومة قيصر”.
والأحاديث التي ذُكرت في طاعة الإمام لا تعني الخلافة، “وإذا كان صحيحاً أنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام قد أمرنا أنّ نطيع إماماً بايعناه، فقد أمرنا الله تعالى كذلك أنّ نفي بعهدنا لمشرك عاهدناه، وأن نستقيم له ما استقام لنا، فما كان ذلك دليلاً على أنّ الله تعالى رضي الشرك، ولا كان أمره تعالى بالوفاء للمشركين مستلزماً لإقرارهم على شركهم”.
2- الخلافة ومشكلة الغلبة: يستدل المؤلف من أحداث التاريخ المتعاقبة على شأن الخلافة؛ التي جرت فيها الدماء أنهاراً، ودائماً كانت تؤخذ بالقوة والغلبة، ويذكر: “لا نشكّ مطلقاً في أنّ الغلبة كانت دائماً عماد الخلافة، ولا يذكر التاريخ لنا خليفةً إلا اقترن في أذهاننا بتلك الرهبة المسلّحة التي تحوطه، والقوّة القاهرة التي تظلّه، والسيوف المصلتة التي تذود عنه”.
3- لا صلة للخلافة بالدين: يؤكد “عبد الرازق” أن الخلافة لا علاقة لها بحفظ الدين وإقامته؛ فقد “ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب” كما ذكر ابن خلدون وبقي الأمر ملكاً بحتاً، ولم يُضيع ذلك ركناً من أركان الدين، ولم يُضيع مصالح المسلمين ولا شأنهم. ويضرب أمثالاً بأزمنة وبلدان لم تكن تخضع للخلافة فعلياً، ورغم ذلك لم يتأثر الدين ولا إقامة شعائره ولا حفظ أغراضه مطلقاً.
4- مقام الرسالة والحكم: يفصل “عبد الرازق” بين الرسالة السماوية وحكم الدولة أو الملك؛ فالرسالة غير الملك، وليس بينهما شيء من التلازم، واعتمد على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجتمع له الرسالة والملك، موضحاً: “لا نعرف لأحد من العلماء رأياً صريحاً في ذلك البحث، ولا نجد من تعرض للكلام فيه”؛ وما يظهر من أعمال الملك في عهد النبي، فليس مملكة نبوية وليس عملاً منفصلاً عن الدعوة، إنما كانت أفعالاً جمعت بين الدعوة وتنفيذها بالفعل، وزعامة النبي “زعامة رسالة وليست زعامة ملك.. والقرآن الكريم يؤيد القول بأن النبي لم يكن له شأن في الملك السياسي”.
5- العرب في زمن النبي: لم يكن الإسلام خاصاً للعرب، ورغم تعاليم الإسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام، والإسلام، لم يتعرضا لأنظمة الحكم المتباينة لدى العرب أو غيرهم؛ ورغم الاختلاف في مناهج الحكم وأساليب الإدارة والآداب والعامة وفي كثير من مرافق الحياة العامة، فإن العرب اجتمعوا في زمن النبي حول دعوة الإسلام، ولم تكن وحدة سياسة، بل كانت وحدة دينية خالصة من شوائب السياسة.
6- زعامة مدنية لا سياسية: الزعامة التي تلت النبي عليه الصلاة والسلام ليست زعامة دينية وفقاً لـ”عبد الرازق”، وليست متصلة بالرسالة ولا قائمة على الدين، بل: “هي ليست شيئاً أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية وزعامة الحكومة والسلطان، لا زعامة الدين”.
7- شرعية رفض الخلافة: يرى المؤلف أن رفض الخلافة وعدم الانصياع إليها ليس إثماً شرعياً، فقد رفض بعض الصحابة بيعة أبي بكر، كعلي بن أبي طالب، وسعد بن عبادة، ولم يعاملوا معاملة المرتدين ولا قيل ذلك عنهم.
براءة الإسلام
ينتهي “عبد الرازق” إلى أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارف عليها المسلمون، والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، ولا وظائف الحكم ومراكز الدولة؛ بل كلها خطط سياسة لا علاقة للدين بها، وتدبير الجيوش وعمارة المدن والثغور ونظام الدواوين أمور لا شأن للدين بها، ومرجعها قواعد الحروب والعقل والتجريب وهندسة المباني وآراء العارفين، بل تجاوز ذلك إلى ضرورة هدم نظام الخلافة العتيق، داعياً المسلمين إلى بناء قواعد الملك ونظام الحكومة على أحدث ما أنتجته العقول البشرية.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.