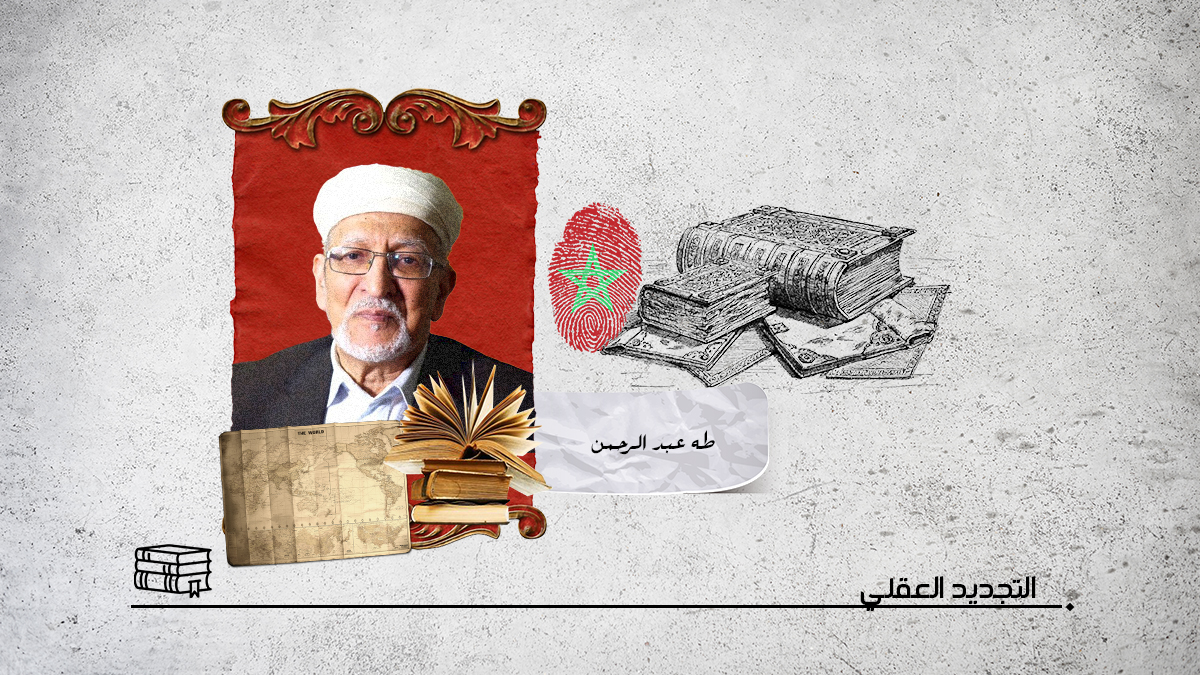
التجديد العقلي:
محاولة ربط العقل بالتجربة الإيمانية
في كتابه "العمل الديني والتجديد العقلي"، يهدف الفيسلوف والمفكر المغربي طه عبد الرحمن (1944م)، إلى دراسة العقلية الدينية المؤثرة في التراث من جهة، وفي الثقافة الإسلامية والعربية تاريخياً وفي العصر الحالي من جهة أخرى؛ باعتبار الدين محركاً أساسياً في التراث، وفاعلاً مؤثراً في المحيط الثقافي، معولاً على العقل في قدرته على رصد آفاته التراثية والمعاصرة، واعتباره محركاً رئيسياً في محاولة أي نهضة للوصول إلى الحداثة الحضارية.
ولتحقيق إمكانية النهضة الحداثية للحضارة العربية، يُحلل "عبد الرحمن" العقل الإسلامي، فيرصد عبر هذا التحليل آفات العقل ومعوقاته، ليصل إلى نتيجة مفادها أن التجديد الديني يجب أن يحدث وفق ممارسة تعتمد على العقلانية المرتبطة بالعلوم الحديثة، وممتزجة بالتجربة الإيمانية الحيَّة، وفق قوله.
أقسام العقل
يبني "عبد الرحمن" كتابه على أمرين هامّين؛ الأول العقل بأقسامه، إذ قسمه إلى: العقل المجرد وحدوده، والثاني العقل المسدد وآفاته، والثالث العقل المؤيد وكمالاته.
والأمر الثاني، الذي ذهب إليه هو التجربة الإيمانية الحية، التي يرى أنها من أبلغ درجات العقل، حسب قوله.
ويُعرِّف المؤلف العقل تعريفاً ثلاثياً:
1- العقل المجرد: هو الفعل الذي يطلع به صاحبه على وجه من وجوه شيء ما، معتقداً في صدق الفعل ومستنداً في هذا التصديق إلى دليل معين.
2- العقل المسدد: هو الفعل الذي يبتغي به صاحبه جلب منفعة أو دفع مضرة، متوسلاً إقامة الأعمال التي فرضها الشرع.
3- العقل المؤيد: هو الفعل الذي يطلب به صاحبه معرفة أعيان الأشياء، بطريق النزول في مراتب الاشتغال الشرعي، مؤدياً النوافل زيادة على إقامة الفرائض على أكمل وجه.
الثقافة والعقل
يوضح "عبد الرحمن" أن علماء المسلمين مالوا إلى اعتبار العقل "ملكة أو قوة أكثر من اعتباره ذاتاً أو جوهراً"؛ فنفَوا جوهرية العقل، لكنهم عند الممارسات الفعلية اعتبروه جوهراً وذاتاً، ما يمثل ازدواجاً وتضارباً منهم، حسب قوله.
ويرى الكاتب أن العقل باعتباره ذاتاً وفقاً لممارسات علماء مسلمين، فإنه يحسُن ويقبُح كما تحسُن الأفعال والصفات وتقبُح؛ فيحسُن العقل حينما: "يسلك بصاحبه مسالك المعرفة الحقيقية"، ويقبُح إذا "انحرف عن المسالك المعرفية المستقيمة، وأوقع في الشبهات والظن"، وفق قوله.
نظرية المعرفة
بَحْث الكاتب في "الإلهيات" هو نظر في الأدلة والبراهين دون الموضوع، وهو يؤكد يقينية موضوع الإلهيات، ويستخدم النقد العقلي للمنهج المستخدم فيها وأدلته وبراهينه.
ويذهب إلى أن مبحث الإلهيات المنتشر في التراث هو بشكل عام أمر نظري، يختص بمحاولة التوسل بالعقل المجرد للفهم والتحصيل، وهو أكثر العلوم المتوسلة بالعقل المجرد خصوصاً في نظرية المعرفة الإسلامية العربية، على عكس علوم أخرى مشتركة بين المسلمين وغير المسلمين، حسب قوله.
وللعقل المجرد حدود في "الإلهيات"، وفقاً للنظرية الإسلامية العربية، هذه الحدود سببها النسق المعرفي الإسلامي العربي، ولا تتعلق بالنسق المعرفي النظري عموماً، وفي المقابل فإنها لا تُشكل موانع أو قيوداً في النُّسُق المعرفية الأخرى غير الإسلامية وغير العربية، لتفعيلها النسق العام لنظرية المعرفة، حسب "عبد الرحمن".
يقول الكاتب إن من إشكاليات "الإلهيات" في نسق المعرفة الإسلامية العربية هي اللغة، التي يرى أنها وعاء يتضمن مجال الإلهيات والنظر فيها، واللغة حسب قوله: "نسق مركب من وحدات متمايزة في ما بينها، وهي مجرد علامات صوتية لها وظائف رمزية، لا يمكن أن تنقل إلينا الأشياء بمعالمها الوجودية وسماتها الخارجية".
مجال الإلهيات
ويرى أن مجال الإلهيات في الثقافة الإسلامية العربية ليس علماً، بل هو "مقال نظري"، مستمد من الخطاب الذي يتداوله عامة الناس، من سماته أنه يحاول الاستدلال على الصفة بشكل يُوصف باليقينية، ولكن بعد النظر في تلك المحاولات الاستدلالية التي تتصف باليقين يتضح أنها ظنية، والأدلة المستخدمة لا تفيد اليقين، عكس ما يدَّعي أصحاب علم الإلهيات، حسب قوله.
ويستدل "عبد الرحمن" على ظنية الأدلة والبراهين في "الإلهيات"، بأن الثقافة الإسلامية والعربية بها اختلافات متباينة، بعض هذه الأدلة يأخذ به علماء، ولا يأخُذ به آخرون، فوجود معارضة على أي دليل يثبت أنه ليس دليلاً، حسب قوله.
ويؤكد ظنية أدلة "الإلهيات"، حسب الكاتب، أنها ليست "صوراً استدلالية مجردة"؛ بل هي صور تشخيصية بها مضامين كلما "اتصلت بالمعتقدات والمقاصد ولصقت بها، كان تأثيرها أوضح وأعمق وأفيد"، والمؤلف بهذا يشير إلى مغايرة موضوع الإلهيات لكل ما سواه، مستنداً إلى الآية: ﴿... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ...﴾ [الشورى: 11].
حدود العقل
ويقسم "عبد الرحمن" حدود العقل العامة إلى ثلاثة أقسام:
1-الحدود المنطقية: وهي حدود صورية مرتبطة بصور الموضوعات، قد لا تقدر على السيطرة على الواقع والتعامل معه، رغم محاولة إضفاء صبغة عقلية عليه، ليؤكد بذلك أهمية التجربة.
2- الحدود الواقعية: وهي حدود مرتبطة بثلاث جهات: "النسبية والاسترقاقية والفوضوية".. أولاً، النسبية: ويرى أنه لا توجد قوانين مشتركة وكلية وواحدة عند الجميع، ويبرهن على ذلك بتعدد دور المنطق في التاريخ.
ثانياً، الاسترقاقية: ويفسرها بأن اختراع الإنسان العلوم والمناهج والتقنيات محاولاً الفهم والسيطرة، تجعله يقع تحت سلطتها.
ثالثاً، الفوضوية: نشأت نتيجة عدم تكامل النظرية ونمو العلم بشكل مطرد، فأصبح تطورها تطوراً تراكمياً تكاملياً، والعلاقات بينها متباينة يخالف بعضها بعضاً.
3- الحدود الفلسفية: وهي الحدود العقلية المرتبطة بمادية الأشياء وبمحسوسيتها، وليس كما يُظن أنها تجريد عقلي خالص.
بهذا التقسيم والحديث عن حدود العقل العامة يوضح "عبد الرحمن" أهمية التجربة الإيمانية العقلية في التجربة الدينية، سواء في العمل الديني أو التجديد العقلي.
وسائل عقلية
يوضح الكاتب أنه يمكن للعقل الوصول إلى وظيفته، في إدراك الحقائق واستخلاص الأدلة، عبر ثلاث عمليات أو وسائل، يضيف إليها الصبغة التجربية المادية للمدركات، وهي:
1- التظهير: إمكانية العقل في التعامل مع موضوع ما حتى يجعله ضمن الظواهر القابلة للتجريب والتحليل.
2-التحييز: وتعني تحييز موضوع في المكان والزمان، ما يجعله قابلاً للتقسيم والتقدير والتركيب، فيجعل ما هو غير قابل للمقدار قابلاً له.
3- التوسيط: وتهدف إلى توسيط الموضوع، فيقول: "كلما كان الشيء دقيقاً ولطيفاً تعقدت وتعددت الوسائط إليه.. وكلما كان كثيفاً مجسماً قلَّت الوسائط إليه".
إلا أن العقل المجرد، وفق "عبد الرحمن"، تتخلله عمليات وممارسات غير عقلانية، مثل تجاوز النظريات العلمية بعضها بعضاً؛ فبعض هذه النظريات يكون في زمن ما مثالاً على العقلانية، ويُكتشف في زمن تالٍ ما فيها من لا عقلانية؛ رغم ذلك، توجد سيطرة ذهنية بأن العقل المجرد يُسبب عقلانية مجردة، وهو بذلك ينافي الشواهد العلمية التي يمكن استخلاصها من الطبيعة أو من الممارسة اليومية، وفق قوله.
وختاماً، تبدو أزمة التراث بالنسبة لـ"عبد الرحمن"، في كتابه "العمل الديني والتجديد العقلي"، وسبب الجمود والتخلف الذي حاق به، وأعجزه عن اللحاق بالحضارة، هي الاعتماد على العقل المجرد، دينياً أو عملياً، وتجاهل باقي أقسام العقل الأخرى، التي أوسطها العقل المسدد، وأعلاها العقل المؤيد الذي يضم قسمي العقل السابقين عليه، وربطه الكاتب بالمصلحة والعمل أو "التجربة الإيمانية الحية".
وإنهاء هذه الأزمة يكون عبر تجاوز النظر العقلي دون العمل الفعلي؛ الأمر الذي جعله يجتهد في ربط العقل بالتجربة الإيمانية، عبر تحويل المعقولات إلى ساحة يمكن التجريب فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى ربط عملية التجريب بالإيمان الروحي الممتزج بالعقلانية.
الأكثر قراءة
اقرأ أيضاً
© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.